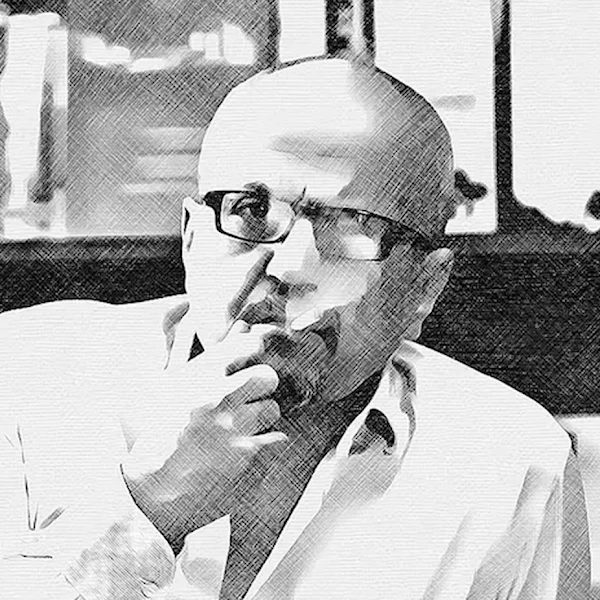الإسلام والغرب
صدام حضارات أم رسالات؟
أ.د. محمد مراد
باحث وأستاذ جامعي
هي موجة جديدة من الاسلاموفوبيا تجتاح مرة أخرى السويد والدنمارك وفرنسا وغير دولة في الغرب الأوروبي والأميركي، هذه الاسلاموفوبيا كانت ترجماتها وتعبيراتها متعددة الآليات والوسائل، لكنها في كل حركتها كانت تنم عن أزمات مخزونة في الذاكرة الثقافية الغربية تجاه الشرق الاسلامي، وبصورة خاصة تجاه الرموز التاريخية البارزة في الوطن العربي بوصف هذا الأخير يبقى الشاهد الدائم على احتضان حركة الاسلام دعوة وجغرافية رسالة. فالرسول الأكرم محمد بن عبد الله (ص) هو عربي الانتماء واللسان والهوى والبيئة الحاضنة للرسالة السماوية التي بشر بها ، والتي لم تكن ليكتب لها النجاح والانتشار لولا لم تتحول الى خصوصية عربية في الأساس ، حيث حملها العرب في وجدانهم الفكري والثقافي وارتقوا بها حركة عربية – انسانية هي بمثابة رسالة حياة الى غير أمة أو جماعة في العالم .
أما وقع الرسالة العربية – الإسلامية على الغرب بدائرتيه الأوروبية والأميركية فكان اقرب الى الصدمة منه الى التفاعل الايجابي معها، فقد ظل ينظر اليها من زاوية الاختلاف الحضاري المحكوم بنزعات التغلب والسيطرة والاحتلال والاستعمار من قبل الغرب من أجل تسيده على حكم العالم وقمره واستغلاله.
تسعى هذه الدراسة إلى تناول العلاقات التاريخية المأزومة بين عالمي الغرب والشرق. محاولة استقراء العوامل الحاملة أو الدافعة لتلك الأزمة المتجددة وهي أزمة لم تعرف بعد، منذ ما قبل لهور المسيحية والإسلام بقرون عديدة وحتى اليوم. الانفراج وسيادة السلام في علاقات العالمين المذكورين ذلك أن فترات الانفراج التي كانت تظهر على السطح بينهما بين الحين والآخر، إنما هي فترات كانت محكومة إلى الظرفية الأقرب إلى الهدنة منها إلى الديمومة التفاعلية في حركتها الخطية الدائمة.
كثيرة هي المقولات الثقافية الغربية التي ظهرت في غير مرحلة من مراحل التاريخ المختلفة، كانت أسيرة دائماً لعملية اسقاط ايديولوجي ديني ثقافي عرقي وحضاري، مدفوعة غالباً بمنهجية تبريرية تعطي الغلبة والتفوق لعالم الغرب مانحة إياه “حق” السيطرة والتدخل في شؤون الشرق وتبرير الذرائع لترويضه ثقافياً وحضارياً وضبط سلوكه «المنحرف» بفعل استبداد عوامل التخلف به والتي باتت حسب مزاعم المؤدلجين الغربيين، سبباً من أسباب اندفاع الشرقيين بعامة، والشرقيين المسلمين بخاصة، نحو “الإرهاب” وتدمير الحضارة وممانعة التقدم.
تحاول هذه الورقة أن ترصد القانون التاريخي أو مجموعة القوانين التاريخية التي حكمت مسار العلاقة بين الغرب المسيحي – الرأسمالي – الاستعماري – الامبراطوري من جهة، والشرق الإسلامي والعربي خصوصاً المتميز بأهمية استثنائية على مستويات ثلاثة: جيواستراتيجي، جيو إسلامي وجيو بترولي من جهة أخرى. أما منهجية هذا البحث فتقوم على ثنائية تجمع بين منظورين إثنين: الأول، توصيف تاريخي لعدائية مستمرة في علاقات الغرب بالشرق الإسلامي عموماً والعربي منه خصوصاً. تكمن مقاربة هذه العدائية في الولوج إلى المخزون التاريخي لثقافة الغرب تجاه العالم الإسلامي، ذلك أن مثل هذا الولوج هو بمثابة مفتاح المعرفة العميقة لفهم خلفية العداء المتراكم في الثقافة الغربية تجاه المسلمين، وبيان الشواهد الداحضة لأسبابها. ونفي المقولات عن «إرهابية الإسلام»، والتي تغالي في وصفه بالرجعية ومعاكسة التقدم. أما المنظور المنهجي الثاني فيقوم على تلمس الخطوط الكبرى لمشروع نهضوي إسلامي يمكنه أن يؤسس لحالة إسلامية قادرة ليس فقط على ممانعة الاختراقات الغربية ومقاومتهاـ وإنما أيضاً على جعل الإسلام القيمي الرسالي الإنساني مرجعية مركزية على مستوى العالم بأسره يؤسس لعلاقات تكامل وتكافؤ في إطار العالمية الإنسانية وليس في إطار العولمة القائمة على الغلبة والإلغاء والهيمنة.
إنَّ رصداً موضوعياً لمسار العلاقات التاريخية بين الغرب والإسلام يظهر بسهولة أنها كانت تسير في اتجاهين متعاكسين تماماً: اتجاه إسلامي مبكر وهو اتجاه قيمي تسامحي سعى إلى تعميم رسالة العدل الاجتماعي والتسامح والقيم الإنسانية والحضارية إلى الغرب وسائر العالم. واتجاه آخر غربي اختراقي الغائي سعى دائماً إلى طمس الهوية الحضارية للعالم الإسلامي وإلى إخضاعه الدائم لسيطرة الغرب ومصالحه.
من الإنصاف التاريخي القول أن عدائية الغرب تجاه الشرق كانت سابقة على ظهور الإسلام، فهناك الاجتياحات الغربية اليونانية والرومانية التي سبقت ظهور المسيحية نفسها بقرون عديدة، والتي جعلت من البلدان الشرقية جزءاً من امبراطورياتها القديمة. غير أنَّ ظهور الإسلام مع مطالع القرن السابع للميلاد كان بمثابة القوة الحضارية الدافعة للشعوب التي اعتنقته وراحت توسع من دائرة انتشاره شرقاً وغرباً. فقد بدأت، مع ظهور الإسلام، تتعزز لدى الغرب فكرة “الاسلاموفوبيا” التي راحت توصّف الإسلام بالدين غير المسالم والمخزون بالعداء للمصالح الغربية ومن ثم لرسالة الرجل الأبيض التي طبعت الحركة الاستعمارية الأوروبية التي تكثّفت خلال القرن التاسع عشر والتي اتخذها الغرب يافطة لنشر الحضارة الأوروبية والغربية عموماً، ولكنها في الواقع تخفي مطامع استعمارية قائمة على الإخضاع الدائم للشرق الإسلامي وإبقائه ملحقاً طرفياً على هامش الغرب المتقدم والمتطور.
ثمة تهمة تاريخية يلصقها الغرب دائماً بالمسلمين عموماً وبالعرب منهم خصوصاً، وهي تهمة التخلف والإرهاب والعداوة الدائمة للحضارة، على قاعدة هذه النظرة الاتهامية كانت التعبئة الغربية لهجمات مستمرة على بلاد المسلمين بهدف اختراقها أو السيطرة عليها. فالحروب الصليبية مثلت أحد أهم الاختراقات من براثن الجهل والتخلف. فالهدف الأول لتلك الحروب كان في أحد دوافعه الأساسية محاولات الغرب للتصدي للثقافة العربية – الإسلامية ومحاصرتها وتفريغها من مضامينها القيمية والحضارية الإنسانية التي اكتسبتها من الإسلام نفسه.
إنَّ بحثاً عميقاً في دوافع الاستعداد الغربي الدائم لاختراق الديار الإسلامية يُظهر أن المحرك الأبرز لذلك الاستعداد يكمن أولاً وأخيراً في أزمة الغرب الدائمة في التاريخ. فقد عرف الغرب، منذ الألف الأول للميلاد، على الأقل، أزمة الكنيسة التي اندفعت وراء سلطتها الاستبدادية على مؤمني أوروبا إلى نقل أزمتها إلى الشرق بهدف إبعاد القوى الاجتماعية والسياسية المعارضة لها في الداخل الأوروبي. من هنا كانت الحروب الصليبية كوسيلة ناجعة من وسائل تصدير الأزمة إلى خارج أوروبا. ومع تنامي الرأسمالية الغربية في أعقاب الثورة الصناعية وجدت هذه الرأسمالية في اللجوء إلى الحروب على أنها أفضل السبل للخروج من الأزمات المتلاحقة. فالرأسمالية الغربية الأوروبية والأميركية كانت تبحث دائماً عن منافس تحت ضغط أزماتها المستمرة، فالحروب الأوروبية بعد الثورة الفرنسية وصولاً إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية، كلها حروب كانت من تدبير الرأسمالية على الرأسمالية دفعت البلاد الإسلامية والعربية تحديداً الثمن الباهظ لنتائجها.
مع نهاية الحرب الباردة في أعقاب السقوط السوفياتي في تسعينيات القرن الماضي (القرن العشرين)، ومع دخول رأسمالية المركز الأميركي عصر العولمة – عصر الأحادية القطبية – راحت تبرز ثقافة القوة المؤدلجة في علاقات الغرب بالشرق الإسلامي. ارتكزت القوة الأميركية المؤدلجة إلى عناصر ثلاثة: المعرفة التكنولوجية، الاقتصاد الرأسمالي والصناعات الحربية. شكلت هذه العناصر المرتكزات الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأميركية في نظرتها للعلاقات الدولية، وبالأخص في نظرتها إلى عالمنا العربي الإسلامي الذي قُصد ابتزازه ليكون أكثر تجاوباً مع ما تفرضه ثقافة القرارات الدولية، وهو ما جعله مرغماً على تبرير وتخفيف لهجة مواجهاته، بعد أن غدا متهماً زوراً “باغتصاب أمن العالم”.
يقدِّم هنري كيسنجر – المهندس الاستراتيجي للسياسة الخارجية الأميركية – نموذجاً تحريضياً صارخاً لتحشيد الاستعداء الغربي على الإسلام. ففي خطاب له أمام المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الدولية عام 1990، قال: “إنَّ الجبهة الجديدة التي يتحتم على الغرب مواجهتها هي العالم العربي الإسلامي، باعتبار هذا العالم هو العدو الجديد للغرب. أما أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) “ولي كلايس” فقد قدَّم صورة أكثر عدائية تجاه الإسلام قائلاً: “لقد حان الوقت الذي يجب علينا فيه أن نتخلى عن خلافاتنا وخصوماتنا السابقة وأن نواجه العدو الحقيقي لنا جميعاً وهو الإسلام، وأنّ الأصولية الإسلامية هي، على الأقل، في مستوى خطورة الشيوعية”.
في عصر العولمة الراهن باتت تشهد الولايات المتحدة تحولات كمية ونوعية تتمثل بانتقالها من دولة الامبريالية التي برزت في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى امبراطورية الامبريالية في ظل الشركات القطبية المتعددة الجنسية المسيطرة على العالم اليوم. مع امبراطورية الامبريالية باتت الشركة أو مجموعة الشركات العملاقة تتحكم في السياسة والاقتصاد والمجتمع. ومع هذه الشركات تحولت الدولة إلى مجرد وسيلة في خدمة المراكمة الرأسمالية القائمة على نهب ثروات العالم ومصادرة إرادة الشعوب. فالإمبراطورية الأميركية في عصر العولمة لا تختلف عن سمات الامبراطوريات المتسلطة السابقة في التاريخ إلا من حيث التسميات والتصورات، وهذا ما عكسه “توني بلير” – رئيس الوزراء البريطاني – بقوله: “فلنعد ترتيب العالم من حولنا” ليعقبه الرئيس الأميركي “جورج بوش الابن” بالقول “إننا نركز على أفغانستان، ولكن المعركة أوسع”. وهنا يكمن التركيز الغربي لا سيما الثنائي الانكلوسكسوني على منطقة الشرق الأوسط ذات الحضور الإسلامي الغالب، وذلك لجهة اعتبارها المدخل إلى الامساك بالعالم كل العالم.
باتت السياسة الأميركية بقيادة المحافظين الجدد بمثابة رأس الحربة في عدائها للعالم الإسلامي عموماً والعربي منه خصوصاً. وقد ارتكز هؤلاء المحافظون إلى خلفية ايديولوجية ذات أبعاد ثقافية وفكرية مغلفة بنزعة إيمانية مسيحية تنشد المغالاة والتطرف في معتقداتها بهدف خلق الذرائع والمبررات لأدائها السياسي، في ضوء هذه الخلفية الاعتقادية للإدارة البوشية راح جورج بوش الابن يقدم تبريره للحرب التدميرية على أفغانستان والعراق معلناً بأن ذلك ينسجم مع “العناية الالهية” التي كلَّفت الأميركيين بتطويع العالم وضبطه بما في ذلك اللجوء إلى الحرب “الاستباقية” التي احتلت الأولوية بين وسائل الإخضاع الأخرى لاحتلال أفغانستان عام 2001 والعراق 2003. فقد قال بوش في احدى خطبه: “لقد دعا التاريخ أميركا وحلفاءها للعمل. فأصبح من مسؤوليتنا ومن حقنا خوض حرب الحرية”.
إنَّ البروتستانتية المتطرق التي تحكم سلوك المحافظين الجدد في إدارة البيت الأبيض اليوم ليست سوى الوجه الآخر لنزعة التفوق في التوراة اليهودية، والتي تزعم بأن اليهود هم شعب الله المختار، وهم المكلفون إلهياً بحكم العالم وقيادته. تقاطعت البروتستانتية المتطرفة مع التوراتية اليهودية وتحولت معها الإيديولوجية الأميركية الجديدة إلى عصبية دينية كانت وراء التوجهات السياسية لإدارة جورج بوش الابن في مشروعه الشرق أوسطي الجديد الذي يهدف من بين ما يهدف إلى إلغاء الهوية الإسلامية كهوية تاريخية للمنطقة والترويج لهوية بديلة شرق أوسطية تستطيع معها الهوية الصهيونية أن تفوز بالتفوق والغلبة.
يخطئ من يعتقد أنَّ التوترات الحاصلة في علاقات الغرب المسيحي بالشرق الإسلامي هي توترات ناجمة عن صراعات – خفية مسيحية – إسلامية. إنَّ مثل هذا الاعتقاد منافٍ للحقيقة. فالمسيحية والإسلام كلاهما نبت في التربة المشرقية والعربية تحديداً، وتفاعلا مع بيئتها تأثيراً وتأثراً، وكانت المسيحية العربية أكثر حماساً في استقبالها للإسلام حين ظهوره بعدها بأكثر من ستة قرون، وقد شكلت معه النواة الأولية للجماعة العربية التي ما برحت تتعاظم حجماً وقوة باتت معهما قادرة على التبشير برسالة حضارية إنسانية، فكانت معها الفتوحات العربية – الإسلامية لا لتنحصر في دائرة محدودة جغرافياً، وإنما اتسعت لتصل إلى غير مدينة أوروبية، إلى نور في فرنسا، والبندقية ونابولي وجنوى في إيطاليا، وفيينا عاصمة النمسا، والأندلس في إسبانيا. أما الدليل الثابت على أنسنة هذه الرسالة فهو ما تركته من آثار ما زالت ماثلة في الزخارف، والنقوش، وفنّ العمارة، وقيم الأسرة، والقول بالمعروف والنهي عن المنكر، بل أكثر من ذلك، أن التاريخ الأوروبي لم ينعت أبداً الوجود العربي – الإسلامي في أوروبا بالاستعمار أو الاحتلال، عكس ما فعله الأوروبيون ومن ثم الأمريكيون مع الشرق العربي – الإسلامي حيث أمعنوا فيه تجزئة وتفتيتاً واحتلالات لم تتوقف، وهم الذين هيأوا الظروف ودمروا المعطيات لزرع الكيان الصهيوني الاستيطاني في فلسطين وشردوا أهلها في الشتات وما زالوا حتى اليوم الظهير الداعم لإسرائيل على حساب الحق العربي – الإسلامي في فلسطين والمنطقة العربية عموماً. ثمة دليل على مدى الانحياز الأميركي لإسرائيل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً، يكمن في موقف الولايات المتحدة الرافض بقوة لمعظم القرارات الدولية المؤيدة للفلسطينيين. ففي الفترة بين 1983-2001 هناك 18 قراراً دولياً أصدرها مجلس الأمن الدولي تدين إسرائيل وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وكذلك تعديها على الحقوق العربية، قامت أمريكا باستخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيل كل هذه القرارات. هذا، بالإضافة إلى 10 قرارات أخرى امتنع فيها الممثل الأميركي عن التصويت.
إنَّ السياسات القهرية والنهبية التي انتهجتها غير دولة غربية مع المنطقة العربية – الإسلامية، تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عن السلوك السياسي المقرون، أحياناً كثيرة، بردات فعل عنيفة من قبل الحركات العربية – الإسلامية التي ارحت تواجه الغرب وتقاوم سياساته العدائية بحثاً عن الاستقلال والحرية.
إنَّ المقولة الغربية الزاعمة بأن الصراع بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي هو صراع حضاري لا تلامس الموضوعية ولا تجانب الحقيقة، وما يؤكد عليه “هانتغتون” في كتابه “صراع الحضارات” هو في حقيقته فعل ممارسة لقوى الغرب على الشرق وإخضاعه لمزيد من السيطرة وفرض وجهات نظره عليه. إنَّ ما نشهده اليوم ليس صراع حضارات، بل هو فرض حضارة على أخرى، وما ينجم عن ذلك من مقاومة. إنَّ ما تشهده علاقات الغرب بالشرق اليوم يندرج ضمن حركة العداء التاريخي ونزعة الغلبة والسيطرة التي تميز بها سلوك الغرب الدائم تجاه الشرق. إن حركة العلاقات المشار إليها تخضع لقانون تاريخي يتمثل بصدام الرسالات وليس صدام الحضارات.
ثمة مجموعة من الحقائق تُوصِّف واقع العلاقة الراهنة بين الغرب والشرق العربي – الإسلامي وهو واقع يتسم بالعجز العربي الإسلامي مقابل احتفاظ الغرب بمقومات التفوق والغلبة. أبرز هذه الحقائق:
الحقيقة الأولى: الخلل في التزام المسلمين بالمنهج الإسلامي، فالإسلام إما معطّل أو مشوّه ومخترق. فهناك إسلام في النصوص، ولكن لا يوجد مسلمون يلتزمون التطبيق.
الحقيقة الثانية: سيادة أنماط الرأسمالية الغربية من أجل الاستهلاك المحلي في غير دولة عربية أو إسلامية، الأمر الذي يشيع ظاهرة التواكلية في الاعتماد على الغرب ويفسح له المجال في الاختراق والتدخل.
الحقيقة الثالثة: تطور ثقافة اللاإنتماء إلى أمة واحدة. فهناك المذهب والفئة والعرق في مواجهة الأمة.
الحقيقة الرابعة: النخب الحاكمة هي نخب مقلِّدة للنماذج الغربية، وتابعة سياسياً واقتصادياً وثقافياً للغرب وأفكاره.
الحقيقة الخامسة: سياسة التراخي المعتمدة من قبل أنظمة الحكم العربية والإسلامية القائمة تجاه التعامل مع سياسات الاختراق الغربي للمجال العربي – الإسلامي في كل شؤونه الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية والأمنية.
ليس هنالك من إمكانية عند العرب المسلمين من تجاوز حالة العجز المشار إليها إلا من خلال التمسك بثوابت الإسلام الحقيقية والصحيحة لبناء عالم خالٍ من العدوانية، يكون العدل فيه المرجعية المعوَّل عليها لترشيد وضبط سلوك الدول والأفراد في مواجهة دعوات الانحياز والتمايز والفوقية، تلك المنتشية في مناخ غطرسة القوة.
إنَّ واقع المسلمين اليوم، وفي ظل العجز الذي يحكم تفاعلهم مع باقي العالم سواء على مستوى المواجهة مع قوى الغطرسة المادية المتمثلة برأسماليات المركز الأميركي – الأوروبي أم على مستوى الفعل الثقافي الحضاري مع سائر بلدان وشعوب العالم الأخرى. هذا الواقع الراهن للمسلمين عموماً والعرب خصوصاً يضعهم على مفترق طرق حاسم: فإما الخروج من التاريخ، وإما الاستجابة في ردهم على التحديات التي تهدد مصيرهم. ان شروط الاستجابة العربية – الإسلامية فإنما تكون باستلهام المضامين الجوهرية للرسالة الخالدة في تأكيد مساهمتها الفعّالة في بناء حضارة إنسانية تُراعى فيها خصائص الشعوب والأمم، مع تبيان أنَّ ذلك لا يتم عبر تأجيج الصراعات أو اعتماد أساليب وافدة من أرحام إمبراطوريات مُهرت بالتسلط وبنهب ثروات الشعوب وتدمير مقومات مستقبلها.
إنَّ تجديد الإسلام القيمي الرسالي بات أكثر من ضرورة وحاجة ملحّة ليس فقط إلى العرب والمسلمين وحسب، وإنما أيضاً إلى سائر شعوب العالم عموماً والشعوب الغربية خصوصاً من أجل أنسنة العلاقات العالمية وفقاً لنظرة معيارية قوامها التكافؤ والعدالة والقيم الإنسانية الثابتة.
المنبر الثقافي العربي والدولي