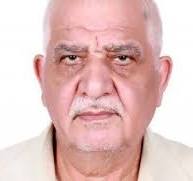مآل الخمينيّة ولغز السيّد حسن

مآل الخمينيّة ولغز السيّد حسن
وسام سعادة
يكثّف اسم السيد حسن نصر الله في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر عدداً من المفارقات.
أبرزها أنه شكّل في الآن نفسه الاسم الذي استطاع تجاوز الانقسام السني الشيعي أكثر من سواه في تاريخ الإسلام السياسيّ.. والحربيّ، كما الاسم الذي دفع هذا الانقسام في محطات غير عابرة أبداً أيضاً إلى حدوده القصوى، بل المطلقة.
بعضهم يكابر على البعد الآخر، والبعض الآخر على البعد الثاني. لكن المدهش ليس هنا. المدهش أكثر هو أن الاسم نفسه جسّد في مرحلة حرب 2006 مثلا لحظة تجاوز واسعة للحاجز المذهبي على صعيد الوعي الشعبي العربي [وقبل ذلك انزعجت التيارات الشيعية العراقية من مبادرته في اتجاه صدام حسين لمساعدته على استباق الغزو الأمريكي بمشروع مصالحة في الداخل]، في مقابل التصادم المتزايد بين «حزب الله» بقيادة نصر الله وبين التيار الأكثري بين سنة لبنان، منذ «انقسام الساحتين» في بيروت على خلفية اغتيال رفيق الحريري، والانقسام بعدها حول المحكمة الدولية الخاصة بكشف من دبّر ونفّذ هذا الاغتيال، وسواه من سبحة الاغتيالات، ومن بعدها توجيه سلاح الحزب الى الداخل في مايو 2008. كل هذا قبل أن ندخل في عقد كامل من الاصطدام العسكري بين «حزب الله» وبين الفصائل الإسلامية المسلحة بسوريا، في حين أن مقاتلي حماس بسوريا خاضوا معركة ضد النظام السوري في دائرة العاصمة نفسها. العجيب أن كل هذا لم يمنع بعد سنوات قليلة بالفعل على تراجع الحرب السورية، بأن ينخرط «حزب الله» في حرب إسناد في مقابل الحرب الإبادية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، وأن يواظب الحزب على هذه الحرب «إلى جانب» الإسلاميين السنة في فلسطين، حتى من بعد تحولها إلى حرب تطهير إثني ضد شيعة لبنان أيضاً، يهجر فيها أكثر الشيعة من مناطقهم، وتقصف منازلهم في ليالي الرعب المتواصلة، وتواصل فيه إسرائيل التنكيل بقادة الحزب، بل وبنصر الله نفسه.
ليست سهلة، ولا بديهية، ويصعب أن تتكرر، هذه المهارة الاستثنائية، في تجسيد الانقسام المذهبي والتحرر منه، بالتزامن حيناً وبالتعاقب حيناً آخر. يأتي ذلك كنموذج يرث ويتجاوز مشكلة حاصرت الخمينية بعد انتصارها في إيران، حين أرادت لنفسها أن تكون فاتحة تثوير لمسلمي الشرق الأوسط ككل.
لا تزال كلمات الشاعر العامي اليساريّ المصريّ أحمد فؤاد نجم، بصوت الشيخ إمام عيسى، تؤرّخ لوقع الثورة الإيرانية لعام 1979 في النفوس، وردّة فعل المتحمّسين لما عُرف «بخط الإمام الخميني» في اليسارين المصريّ والعربيّ، بإزاء ما راح يركّز عليه نظام أنور السادات آنذاك من حصر الثورة الإيرانيّة في الخانة المذهبية الشيعية، ووصم المرحّبين بها بأنهم يعملون على نشر التشيّع، وتعمّد التخليط بين العقائد الشيعيّة وتلك الماركسية.
سواء في اليسار العربي، أو في أغلب الحركة الإسلامية «السنية» استُقبلت ثورة إيران الشعبية على نظام الشاه محمد رضا بهلوي وعودة الإمام الخميني من منفاه الفرنسي مظفراً بما كان يوحي بتجاوز الفاصل المذهبي – النفسيّ بين السنّة والشيعة، والعرب والعجم.
بدت روحية جمال الدين الأفغاني، مُطلق النزعة الأممية الإسلامية في القرن التاسع عشر، من باب تجاوز الشقاق المذهبي السني الشيعي، وإعطاء الأولوية لمواجهة التمدّد الاستعماري، تُبعث من جديد. لكن الأمر لم يطل كثيراً.
لا الصراع مع إسرائيل ينجح في طمس الشقاق المذهبي، ولا الشقاق المذهبي يستقر على نمط واحد، بل أنه لم يزل بين مدّ وجزر
فبعد عام ونصف على عودة الإمام الخميني إلى طهران مطلع شهر فبراير 1979، نشبت الحرب العراقية الإيرانية في 22 سبتمبر 1980، واستعاد النظام «البعثي» العفلقي السردية «نصف القومية نصف المذهبية» للتاريخ الإسلامي على أنه تاريخ الصراع المستدام بين الإسلام العربي وبين الشعوبية الدائمة التي تطلّ كل مرة بوجه، وفي مواجهة الشعاراتية الخمينية «كل يوم عاشوراء، كل أرض كربلاء» استجمعت القومية العربية الآفلة آخر نفس لها في القرن الماضي تحت غنائية من قبيل أن وقعة ذي قار (الحادثة قبل الإسلام) ومعركة القادسية (مطلع الفتوحات) حاضرة في كل يوم، وفي كل أرض، وأن حماية الخاصرة الشرقية للأمة العربية لا تقلّ محوريّة ومصيريّة عن التصدّي للصهيونية.
وقفت الأنظمة الملكية مع العراق الجمهوري البعثي. نجحت عملية تطويق المدّ الثوري الذي حرّرته الثورة الجماهيرية التي تغلّب فيها وعليها وبها الإسلاميّون في إيران.
قسم غير قليل من اليسار العربي تأثّر بصدّام حسين وشعاراته في مواجهة الخميني. قسم آخر تأثر بنكبة شيوعيي العراق، حلفاء صدّام في الجبهة لسنوات، على يد الأخير. هذا قبل أن ينقضّ الخمينيّون في إيران على فصائل اليسار فيها، واحداً بعد آخر، وحتى الإجهاز على حزب «توده» أبرز الأحزاب الشيوعية الجماهيرية في تاريخ الشرق الأوسط، والذي ظلّ يبرّر «خط الإمام» في مواجهة التشكيلات الأخرى من اليسار، إلى أن وصل الدور له بأعمال التنكيل والسجن والمهانة. وفي الموازاة كانت التصفيات ضد مثقفي الحزب الشيوعي في لبنان، وفي مقدمتهم حسين مروة، «الماركسيّ ـ النجفيّ».
بخلاف توقعات ازدهرت في حينه، تمكّن النظام العراقي من الحفاظ على مشهدية الصراع مع الجمهورية الإسلامية على أنه صراع بين قوميتين بالدرجة الأولى. بدلاً من أن ينفجر الشقاق بشكل واسع وغير مسيطر عليه بين السنة والشيعة في العراق نفسه، على ما تسرّعت له بعض التحليلات. لم يمنع هذا صدّام من مواجهة التيارات الإسلامية الشيعية في الجنوب بشكل دموي، لكنه ظلّ قادراً على مواصلة الحرب مع إيران بجيش متشكل من السنة والشيعة معاً. لم يكن الشعور القومي العربي قد فتر بعد في أرض السواد قياساً على التصلّب الإثني للشعور المذهبي بعد ذلك بسنوات قليلة، وبشكل متصاعد وحادّ.
في مقابل النجاح الإيراني في تصدير النهج الخمينوي ونظرية ولاية الفقيه إلى لبنان مع نموذج «حزب الله» لم يكن من السهل تأطير حزب الدعوة الإسلامي الشيعي في العراق ضمن هذا الخط، ولا تجاوز ثنائية آل الصدر وآل الحكيم. لم يعرف منطق تصدير الثورة الخمينية خارج إيران من نجاح سريع له يقارن بنموذج «حزب الله» وقد ارتبط ذلك بشكل أساسي بمآل المسألة الشيعية – الجنوبية في لبنان بعد اجتياح صيف 1982 وخروج منظمة التحرير منه. أما بالنسبة إلى المناخات السنية فقد ظهر أن تجاوز الحاجز المذهبي مع الشيعة، ومع شيعة إيران تحديداً، لم يطل عهده كثيراً. وبخاصة مع إيثار الخميني في فبراير 1982 تفضيل النظام البعثي، العلماني، في سوريا، على تمرد الإسلاميين فيها. خيار الخميني الوقوف إلى جانب حافظ الأسد، شريكه الموضوع في المواجهة مع صدام، كان صادماً وقتها، بالنسبة إلى ثورة إسلامية كانت لا تزال في صباها. وبخاصة أنه لم يكن قد مضى سوى بضعة أشهر فقط على اغتيال خالد الإسلامبولي للرئيس السادات في حادثة المنصة يوم 6 أكتوبر 1981. أطلق اسم الإسلامبولي على أحد شوارع طهران، في ترميز للقاء بين الجماعة المنتسبة الى فكر سيد قطب في مصر وبين الخمينية. لكن ما انطبق على مصر، انطبق سواه على سوريا. وما اعتمد من تواطؤ مع الأسد في مواجهة سكان حماة، أعتمد في المقابل خلافه في طرابلس الشام، حين كان الموقف الخميني أقرب إلى حركة التوحيد إبان المعركة بينها وبين النظام السوري. بالمجمل، لا الخمينية استطاعت تجاوز دائرتها الشيعية لتطرح نفسها كحالة أممية إسلامية ترانس-مذهبية، ولا الحواجز الإثنية والمذهبية لدى العرب كانت بالمساعدة، في ظل وقوف كل من حركة القومية العربية في طبعتها الأخيرة (صدام حسين) والخط الملكي العربي المحافظ في مواجهتها. الاختراق حصل لاحقاً في حالة حماس، وبشكل أكثر وضوحاً في حال حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. إنما، في حالة حماس، لم يتجاوز التلاقي مع إيران الخمينية من باب الدعم العسكري والخبراتي مع تلاق أيديولوجي أكثر عمقاً، وهو ما كان له الأثر لاحقاً في تباين الموقف عند نشوب الثورة ثم اشتعال الحرب في سوريا. الحمولة الثورية للخمينية على الصعيد الإقليمي لم تستطع بالمحصلة تجاوز الانقسام المذهبي السني الشيعي، الذي أعيد إنتاجه بشكل أكثر توتراً وانفجاراً من ذي قبل. في حين أن ظاهرة حسن نصر الله ترمز إلى حركة صعود فجائي ثم هبوط حاد ثم صعود في آليات التلاقي والتباعد بين السنة والشيعة، داخل «الإسلام الحركي» نفسه، وخارجه. وبالمحصلة لا الصراع مع إسرائيل ينجح في طمس الشقاق المذهبي، ولا الشقاق المذهبي يستقر على نمط واحد، بل أنه لم يزل بين مدّ وجزر.
كاتب وصحافي لبناني