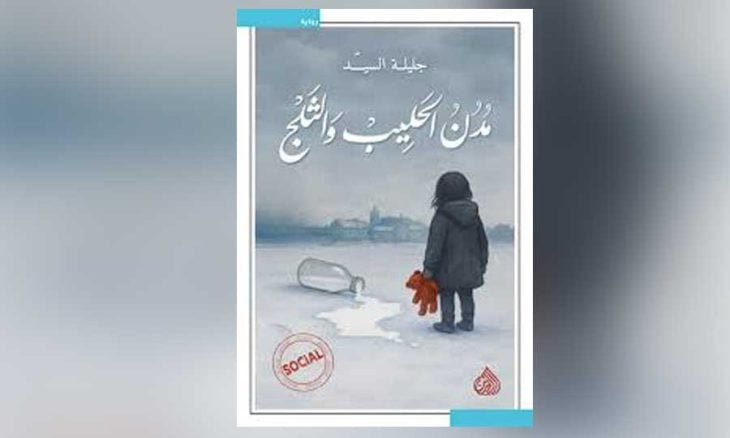أفق التجربة الشعرية

رشيد المومني
يمكن الفصل بين مستويات الحضور الجمالي والفكري، التي تتميز بها التجارب الشعرية، ضمن لحظة جغرافية وتاريخية، انطلاقا من التفاوت الملاحظ بين مقوماتها الفنية والجمالية. وإذا كان من الضروري إضاءة هذه المقومات، فإن السبيل إلى ذلك يتمثل عبر رصد علاقتها بالدلالات الرمزية، التي يمتلكها مفهوم «التجربة». علما بأن التركيز على المفهوم، هو في حد ذاته إشعار بتوافر مستوى جد متقدم من النضج الجمالي والفكري لدى النصوص الشعرية المعنية به. وبالنظر للضبابية الملازمة لمفهوم « التجربة «فإنها تظل عرضة للاختراق الطائش، والصادر عادة عن كل كتابة تتخذ من الشعر مجالها الملائم لممارسة فعل التسيب. والحال إن «التجربة» بما تعنيه من حيث مرجعيتها النظرية والموضوعية، هي التي تحيل عمليا على ذلك المسار الاستثنائي، الذي أتاح لها إمكانية بلورة رؤية شعرية مستندة على قوانينها ومقوماتها الواجبة الوجود، والتي تكون دليل الباحث خلال مقاربته لهوية وخصوصية هذا المسار. بمعنى أن الشخص قد يسلخ حياته بنهاراتها ولياليها، في مراكمة ما يعتبره دواوين شعرية، دون أن تحظى هذه المراكمة بالنزر اليسير من دلالات «التجربة « وأبعادها.
وإذا نحن سلمنا سلفا بحق الجميع في كتابة الشعر، في سياق اقتناعنا بميل البشرية كافة لترجمة ما يخالجها من حالات، ومن عواطف وانفعالات ومشاعر، إلا أن كتابة هذا الضرب من الشعر تظل مع ذاك حقا قائما بذاته، ومنفصلا كلية وبصفة مطلقة، عن مجال «التجربة الشعرية» بمفهومها الفكري والإبداعي الكبير، الذي يمكن تلمس مقوماته في تلك الرموز الشعرية الكبيرة، المتوزعة على امتداد السيرورة التاريخية، التي نتعرف بها على المحطات الجغرافية والزمانية الأساسية، التي رسمتها التجارب الشعرية الجديرة باسمها، خلال استجاباتها الفعلية والعالية لنداءات أسئلة الكتابة.
وللمزيد من التوضيح، يمكن توصيف جوهر التجربة الشعرية، على ضوء الاستراتيجية المحتملة، التي يعتمدها الشاعر في تشييده لمسكنه الوجودي. ما يجعل التجربة مؤطرة سلفا بخاصيتها التجسيمية والرمزية في آن، والتي يقتضي إنتاجها حضور إواليات، موجهة لتفعيل رؤية متكاملة من حيث استيفاؤها لشروطها المعرفية والجمالية. فمفهوم السكن بدلالته الرمزية، يتضمن سلفا مبدأ وجود أرضية معرفية قابلة لما يمكن تسميته على سبيل المجاز بالتهيئة الشعرية. علما بأن الحديث هنا عن السكن لا علاقة له بالمرجعية المعمارية، التي تأوي الحضور المادي والفيزيقي للمادة. إنه وبكثير من الإيجاز، معمار سكني بالمعنى اللغوي، الفكري والروحي للكلمة. وكما أن البناء المعماري لا يكون كذلك، إلا من خلال استيفائه لشروطه الوظيفية، التي تسمح للذات البشرية بممارسة حياتها بشكل طبيعي وتلقائي، فإن السكن /البناء بالمفهوم الشعري، لا يمكن أن يكون كذلك، إلا من خلال استيفائه لشروطه الجمالية والفنية المطلوبة. ذلك أن الأمر يتعلق باختيار الفضاء، وبتوافر الإمكانيات المعرفية لتملكه، كما يتعلق بتجدد مقومات البناء، وبوضع الخطوط العريضة للهندسة، التي ستضفي على الشكل معناه وهويته. علما بأن إنجاز هذا الشكل لا يتقيد بأجندة معلومة، كما لا يتقيد بشكل محدد نهائي وثابت، انسجاما مع حركية خصوصيته، التي لا يحدها بالضرورة مكان أو زمان.
فضمن هذا الإطار فقط، يمكن الحديث عن التجربة، حيث التفكير الشعري لا يكون معطى أو متاحا بصفة جاهزة ومجانية، بقدر ما هو خلاصة تفاعل محتدم بين مقوماته الذاتية والموضوعية، التي لا علاقة لها بظاهرة التوظيف المجاني للسيولة المعجمية، أو أطروحة الفيض العاطفي. وبالتالي، فإن الحديث عن خصوصية التجربة الشعرية، هو في الأصل، حديث عن مسارات انبثاق ضوء ذلك الزمن المعرفي والجمالي العابر للأزمنة وللأحوال واللغات، في قلب سيرورة تكون عادة مصابة بدكنة العمى، كي يكشف /الزمن عن تدفق أسرارها الخفية، وقد أمست مرئية، ومندرجة في حظوة حضور، تتطلع الكينونة أبدا إلى اعتلاء مدارجه.
إن التجربة ضمن هذا السياق، نتاج لهب السؤال الذي لا يمتثل بالضرورة لسطوة قوانين العقل، دون أن يتنكر لها بالضرورة، أو يدخل في سجال سلبي معها.
والسؤال الشعري، الذي تتشكل بموجبه مدارات التجربة، يمتلك القدرة على إلهاب قوانين العقل، كي يغامر بتجاوز اجتراحاته التقليدية – مهما كانت متقدمة – في أفق انفتاحه على مؤانسات مغايرة ومختلفة، تغتبط روح العقل الشعري باكتشاف منازلها.
إنها اكتشاف منازل اللامرئي المنتمية في شق كبير منها، إلى مجهول الغياب، وبفتنة اكتشافه القصوى، يخترق الكائن سلطة الجدار الأخير، الذي يجهز عادة على آماله في البقاء، كي يستمتع بتمديد وتوسيع أزمنة حضوره على تخوم الماوراء، بما هي تخوم اللامتناهي. حيث لا أثر لبوابة الغياب المغلقة على أسرارها. تلك التي تنتصب أمام العقل الخالص بشموخها المأساوي، لتقف حائلا بينها وبين تطلعه العبثي للإطاحة بها. ثمة فقط وبمباركة التجربة، لك أن تغتسل في أنهار الفراديس. أن تقطف ما تبقى من فواكهها المحرمة. أن تفاكه نساءها الحور، ثم أيضا، لك أن تعرج على زبانية جهنم كي تتفقد أخبارهم، على طاولة لا تغرب الكأس عن سماواتها. طبعا، لا يقف الأمر عند حدود تخييل لغوي، بقدر ما يتعلق بصولة الذهاب. تذكر إذن أنك الآن هناك في أتون نار التجربة، وفي برد سلامها.
في قلب هذه الاستحالات الكبرى، يكون للتجربة أن تحتفي بحضورها المتعدد الأبعاد، محاطة بشعريات محفلها. إنها شعرية الحرف المحيلة على شعرية ما لا يرى. شعرية استعادة المنسي. شعرية التفكير في ما لم يفكر فيه بعد.
غير أن الأهم من هذا وذاك، هي شعرية تبين الطريق المفضي إلى أوائل الأشياء أو نهاياتها. مع الأخذ بعين الاعتبار أن مقومات هذه الترسيمة، لا يستند إلى أي يقين يشفع لها ببلوغ ما تتوخاه من غايات وأهداف. ذلك أن اليقين، هو الصوت النشاز الذي تتنكر له التجربة الشعرية بامتياز، بالنظر لاستسلامها الجمالي إلى نداء المباغت والمفاجئ والغامض، الذي يكشف ضوء الرؤية عن مكامنه، وعن تشكلاته. وهو مكسب يقع بعيدا عن طائلة يقين تنعدم معه فرصة الانتشاء بمساءلة الغائب، عله يبوح بما يضطرم في برده من نار. فـ»الكنه» الشعري لا ينجلي لأي هاجس مسكون بصولة يقينه، بل عكس ذلك، هو سليل ذلك التحير الذي به تغتني التجربة ويتنامى وعيها بالحاجة إلى الشيء، دون معرفة ما يمكن أن يكون. وبتعبير آخر، إنه الشيء الظاهر كفقد، والغائب كموضوع. وبالتالي فإن سحرية مراودة هذا الكنه، هي جوهر التجربة الشعرية التي لا علم لهؤلاء ولأولئك بها. حيث سنخلص للقول في نهاية المطاف، إنه رغم كل ما تراكمه التجارب البشرية من إنجازات تقنية ومعرفية تحت القبة الإلكترونية، التي يحتمي بسطوتها إنسان العصور الحديثة، فإن حاجة الكائن الشعري الدائمة لإغناء تجربته المتفردة والاستثنائية، ستحتفظ براهنيتها، بوصفها امتدادا أبديا وطبيعيا، لهوسه الجامح، بالكشف عن أسرار المدارات السرية، الضاجة بنداءات الكينونة.
*شاعر وكاتب من المغرب