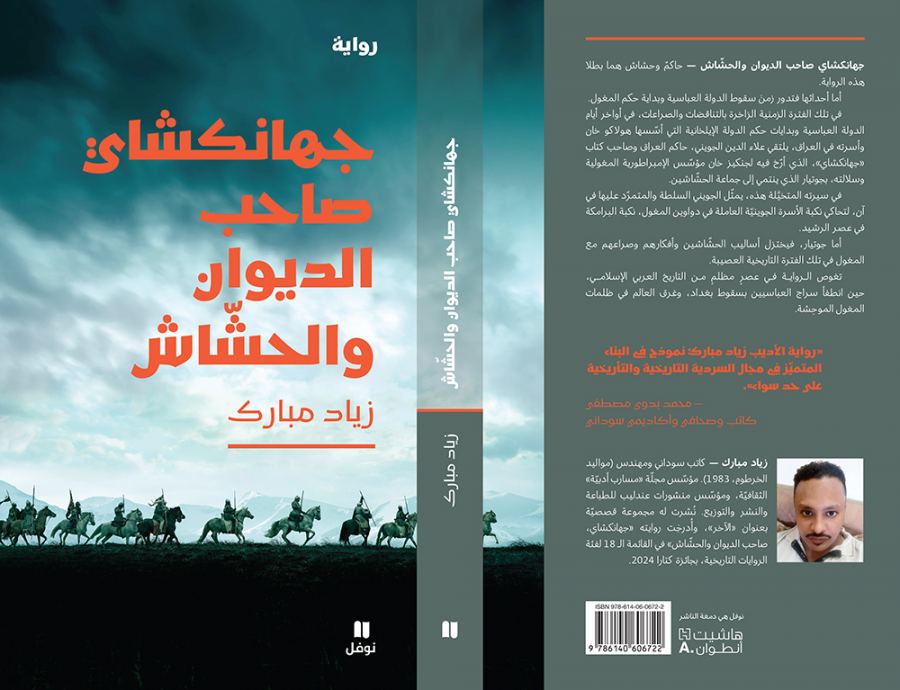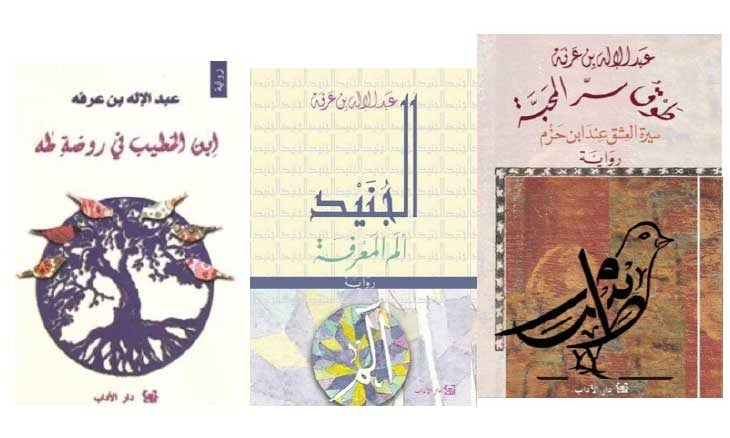موسيقى الشعر: هل يمكن أن تُخلي أصوات الحياة مكانها للصمت؟

عبداللطيف الوراري
ارتبط الشعر عند العرب بالغناء حتى عُدَّ «الغناء ميزان الشعر». ولا يرقى إلينا شكٌّ في أن الشعراء، منذ ما قبل الإسلام، كانوا يُغنّون أشعارهم ويعبّرون عن نظمه وإلقائه بالإنشاد، وكان من هؤلاء الشعراء من يُنْشد الشعر قاعداً، ومنهم من ينشده واقفاً، كما أنّ من طقوس إنشاد الشعر والتغنّي به اللِّباسَ والعنايةَ به. عدا عن أنّ أحدهم قد يرفع من قدر الشعر، أو يحطُّ منه تبعاً لحسن الإنشاد أو سوئه.
ومثل هذه العلاقة نجدها في عدد من الأعراف الثقافية العريقة، بما في ذلك العرف الإغريقي، حيث كان الشاعر يُعرف باسم المغنّي، إذ كان يتغنّى صحبة أداة موسيقية بمغامرات ومآثر الآلهة والأبطال، ويُمثّل هوميروس نموذج الشاعر المغنّي. كما امتدّت هذه العلاقة إلى العهد القروسطي مع شعراء التروبادور والرحالة المتجوّلين. لم يكن تمركز القصيدة العربية على ذات الشاعر وعالمه الداخلي، هو ما يطبعها بطابعها الغنائي وحسب، بل كذلك الاعتناء بمحفلها الصوتي الإيقاعي بشكل بارز، الذي يمنحها أدائیّة خاصة تتأتى من مجموع الظواهر الصوتية النابعة من نسيج علاقاتها اللغوية من تكرار وجرس ونبر وتنغیم وغير ذلك. فقد كان هذا المحفل بمثابة منجم، عَمل الشعراء على استثماره، مثلما اهتمّ به العلماء بالشعر وجعلوه في طليعة مباحثهم النقدية.
من هنا، لم يكن ثمة من قيمة للشعر العربي خارج شرط الإيقاع، ليس فقط في مرحلته الشفاهية، بل حتى في العصر الحديث حيث ظلّ الإيقاع في قلب أي حداثة شعرية. حين تعود إلى نصوص شعرائنا المبرّزين من رومانسيين ومحدثين، تجد أنّه كان لكل شاعر «عقدة إيقاعية»، أو تجد عنده عَروضا خاصّا به يتقاطع فيه ما هو صوتي بما هو تصويري، أو ما هو إيقاعي بما هو جسدي؛ ولاسيما حين تعود إلى تسجيلات بعض هؤلاء الشعراء، بدر شاكر السياب، نزار قباني، صلاح عبد الصبور، أمل دنقل، محمود درويش، فدوى طوقان، أدونيس، سركون بولص، فتشعر بأصواتهم وهي تأخذ طبائع خاصة ومنحنيات حسية بقدر ما هي تتعالق مع طقس القصيدة، وما تنطوي عليه من وعاء إيقاعي ثري. هذا ما يمكن أن نعنى بدراسته ضمن ما يسميه هنري ميشونيك بـ»الأنثروبولوجيا التاريخية للصوت» التي تتعلق – في نظره- بتسجيلات صوت الشاعر، إذ تبرز سمات الصوت الخاصة، الجسدية والفيسيولوجية (السنّ)، كما يكشف علم الأعراض الذي يتخلل الصوت، عدا التلفُّظ وصوت الصدر، وصوت الرأس، وصوت الأنف. فلا تُعدّل المتغيراتُ الصوائتَ فحسب، بل إنّها كذلك تشرط نطق الشخص. يقول: «الصوت يوحّد، يجمع الذات، جنسها وحالاتها. إنّه البورتريه الشفوي». إلى الآن، ما زال ثمّة فراغ في نظرية إيقاع الشعر العربي، يتعلق بـ»أنثروبولوجيا الصوت».
ورغم الإمكانات الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا اليوم، إلا أن شعراءنا المعاصرين لم ينفتحوا عليها بشكل أساسي، وأيّا كان موقفنا من صنعة الإلقاء عند شعرائنا اليوم، فإنّ ما لا نقبله هو أن يسجل أحدهم بصوته (وليكن الذكاء الاصطناعي) قصيدةً لشاعر؛ لأنّه لا ينتحل صوته، بل يتطفّل على فضاء القصيدة بكامله. ولكن، في المقابل، نكتشف أنّ في شعرنا المعاصر ثمة ميل شديد إلى مقاومة الصوت لصالح الاحتفاء بالصمت، كأنّ هذا الشعر يريد أن يتجرد من الموسيقى ويُخلي مكانها لمنحنيات السرد النثري المتخفّف من الإيقاع. وحتى جمهور الشعر أثناء حضوره أماسي القراءة الشعرية بات لا يطيق هذا الصمت، بل يتأفف منه، لأنه لا يشبع عصب ذائقته الفنية، أو لا يقع في صميم «أذنه الموسيقية» على الأرجح؛ حيث تظل الموسيقى مكوّناً عضويّا بالنسبة إلى النص الشعري في تاريخ الثقافة العربية.
سألت «القدس العربي» بعض الشعراء الذي يقاومون الصمت عبر احتفائهم بالإيقاع ضمن هذا الشكل أو ذلك: ما هي قيمة الصوت الفردي بالنسبة إلى الإلقاء في القصيدة؟ هل ثمة ميكانيزمات (تركيبية، إيقاعية..) تساعد الشاعر(ة) على التماهي مع طقس القصيدة ومناخها الدلالي والرمزي؟ هل تجد شكلا أنسب من غيره لإظهار منحنيات الإيقاع لحظةَ الإلقاء؟
صباح الدبي: حياة أخرى للقصيدة
لا شكَّ في أن الصوت بوصفه طاقةً يتماهى لحظةَ الإلقاء مع روح القصيدة وطقسها، إنه هوية فردية يتبدَّى من خلالها الدفق الروحي والوجداني للذات الشاعرة، ومن ثمّة يصبح الصوت الفردي ذاتاً أخرى مُضاعفَة تُعلن عبر ذبذباتها ورجع صداها عن هذه الذات. فالقصيدة لحظةَ الإلقاء تولد من جديد، ويصبح لها حضورٌ مادي يكشف عنه الصوت، وتستدعِي أحوالها الأولى خلال المساحة الزمنية للإلقاء، وتخرج من كتابتها على البياض إلى نبضها الجديد الذي يعلن عنه الصوت، وبذلك يمنح الصوت الفردي البصمة الجينية الفريدة التي لا تتكرر، والتي تمنح القصيدة لحظة إلقائها كينونتها ووجودها. وما يساعد الشاعر على التَّماهي مع طقس القصيدة ومناخها الدلالي والرمزي، هو إحساسه الداخلي وصفاء روحه وانخراطه في ما تحجبه الحروف وتكشفه على السَّواء، ثم إن استدعاء أحوال القصيدة وما سكبته الذات في حروفها لحظة الكتابة، من شأنه أن يمنح الحياة لما تختزنه الحروف، ليصل ذلك عبر الصوت، وعبر شحناته الوجدانية والروحية إلى المُتلقّي، فينخرط دون شكّ في هذه الحالة الصوتية الفريدة التي تتماهى فيها روح الشاعر مع روح صوته. إنّ الإلقاء الجيد إضافة نوعية وجمالية للقصيدة، يُتمُّ ما أثثته الصور الشعرية، وما نسجه الخيال من لوحات يفيض ماؤها، وهذه الجودة يمنحها إتقان مخارج الحروف وصفاتها، وحسن التحكم في المساحة الزمنية بين الكلمات والعبارات، ولحظات الاسترسال والتروِّي، ورفع الصوت وخفضه تبعاً لما تستدعيه الحالة الشعورية، وتجنب الرتابة من خلال تنويع موجات الصوت بين الجهورية والخفوت والتنفس الصحيح الذي يتيح الراحة المطلوبة لحظة الإلقاء، فضلا عن الحرص على التآلف بين الصوتي والبصري ليتحقق التأثير المرجو في المتلقِّي، ويحدث التماهي المطلوب مع عوالم القصيدة.
الأنسب في الإلقاء هو كل ما يجوِّده دون مبالغة أو تكلُّف أو استعراض، وما يجعله لحظة شعرية بامتياز للشاعر وللمُتلقّي على السَّواء، وهو ما ينقل ما يعتمل في الداخل، وما تُخفيه القصيدة من أسرار، وما يسمح بتماهي الشاعر مع جمهوره لينخرطا معاً في طقس شعري مُشترك، تُحييه الحروف والأصوات واللقاء الإنساني. والأنسب أيضا أن يكون الإلقاء في وضعية الوقوف وأن يشعر الشاعر بالكلمات ويشحنها بالطاقة الروحية ويتماهَى مع الجمهور في لحظة صوتية بصرية تمنح القصيد حياة أخرى لحظةَ الإلقاء.
صالح لبريني: بين القراءة والإلقاء
يُشكّل الصوت في الإلقاء الشعري عاملا مهما وحاسما في التأثير على المستمع لتوصيل معاني النص الشعري ودلالاته، ويمكن عدّه وسيلة من وسائل التعبير عن العاطفة وإثارة الشجن أو الفرح، كما أن التنوع والتنغيم الصوتي يحققان الحيوية ويبعدان الملل والرتابة عن النص الشعريّ، بل يسهمان في تحقيق التفاعل بين النص المقروء المسموع والمتلقي، والتماهي مع طبقات النص وموضوعاته. بعبارة أخرى، إن الصوت في الإلقاء الشعري يؤدي إلى إضفاء طابع إيقاعيّ ودلالي على النص الشعري، وتكون له القدرة على استثارة الأهواء والرغبات لدى المستمع. أما بخصوص الميكانيزمات التركيبية والإيقاعية التي تجعل الشاعر ينسجم مع الجوانب العاطفية والمناخ الدلالي والرمزي، نذكر التكرار باعتباره العمود الفقري للإيقاع بشتى تجلياته؛ ومن أنواعه التوازي الذي يُعدّ من السمات الفنية التي تُميّز الشعر، ويندرج تحته العديد من القواعد الإيقاعية الصوتية كالتكرار الصوتي أو الصرفي أو التركيبي، والنبر والانتظام والتنغيم والقافية، إضافة إلى الخصائص البلاغية كالتوازن والترصيع والتصريع، والأساليب المجازية والاستعارية والتشبيهات والكنايات، مع ضرورة الإشارة إلى أهمية الثنائيات الضدية والاستخدام الرمزي والإيحائي للغة والمحسنات البديعية كالجناس والسجع. فهذه المميّزات تؤدي إلى توليد وتوسيع الدلالات داخل النص الشعري وتدمغه بالطابع الإيقاعي، دون نسيان العناية بمخارج الحروف، ولغة الجسد من خلال الحركات والإشارات، مع التنويع في إيقاع الصوت ونغماته واحترام الوقفات العروضية والدلالية؛ كلّ هذا يُشكّل روح النص الشعري وحياته الإيقاعية والدلالية، ويكشف عن العوالم النفسية والعاطفية للذات الشاعرة، ويثبت لدى المستمع المعنى والدلالة.
أمّا الشكل المناسب لإبراز منحنيات الإيقاع فيعود إلى طبيعة النص الشعري، ذلك أن إيقاعية الشعر العمودي تخضع لضوابط ثابتة، بينما شعر التفعيلة يتميز بحرية استخدام أسطر طويلة وأخرى قصيرة مع تنويع الإرواء والقوافي، ما ينتج عنه منحى إيقاعيّاً يتماهى مع الارتجاج العاطفي. أما قصيدة النثر فلها إيقاعيتها المنبثقة من الداخل، فهي تُركّز على التفاعل القائم بين التوزيع البصري والتكرار والتنغيم الداخلي والاعتماد على الترميز والإشارة. وهذا ما ينعكس على الاختلاف القائم بين هذه الأشكال الشعرية على مستوى طريقة الإلقاء، رغم أن الكثير من النقاد والشعراء ينبذون إلقاء قصيدة النثر لكونها صالحة للقراءة لا للإلقاء.
رشيد الياقوتي: الطريق إلى قلب المتلقي
يجد فن الإلقاء في الشعر أهميته في تلازمه العضوي مع النص المقروء أمام المتلقي، الذي يشكل بدوره عضوا مؤثرا في عملية الإلقاء، حسب تفاعله وانفعاله مع الشاعر القارئ. ولا ينحصر هذا الفنّ في طبيعة الأداء الصوتي بما «يستنفر» من عناصر صوتية تبدأ بتدفق الهواء من الرئتين أعلى القصبة الهوائية عبر الحنجرة، واهتزاز الأحبال الصوتية، فينتج عن ذلك الصوتُ الذي تتلقفه الشعيرات السمعية الدقيقة والحساسة في الأذن الداخلية. إن فن الإلقاء هو أعقد وأوسع تطبيقا من ذلك، إذ يحتاج إلى مهارات أشبه ما تكون بمهارات التمثيل لنقل التجربة الشعرية داخل النص من مجرد مخطوط جامد، ينتظر قراءة صامتة، إلى حالة صوتية تستثير مجمل حواس الشاعر وأعضائه الجسدية، بما يجعل المستمع يشعر بمعانيه وأحاسيسه، بل يعتبر فن الإلقاء، في نظر الغالب الأعم من النقاد، جزءا أساسيا من تجربة الشعر، يرتكز على عناصر معيارية في تقييم الإلقاء كالاهتمام بمخارج الحروف، والوضوح في الكلمات وسلامة نطقها، كما يرتكز الإلقاء على التعبير الموسيقي، متوسلا تقنيات التنغيم في الصوت، بما يوافق الحالة الشعورية المتدفقة من المعنى المطروق والمشاعر الناتجة عن ذلك، من حزن وفرح، أو غضب، إلخ. على مستوى آخر ذي طبيعة إيقاعية، تبدو عملية التوقف، في الأماكن المناسبة لإبراز المعنى واستثمار الصمت بغرض إثارة الترقب أو التأمل، أمرا بالغ الأهمية لتطويع انفعالات المستمع وتوجيهها إلى الغاية المنشودة من القراءة.
يبدو التعبير الجسدي عبر التواصل البصري مع المستمعين فعالا وذا جدوى في استمالة العواطف وكسب تأييدها وولائها للشاعر. هكذا يلجأ هذا الأخير، في أداء تمثيلي مصطنع أحيانا، إلى استخدام حركات اليد، وتعبيرات الوجه لدعم المعنى وإقناع المستمع بمصداقية الرسالة الشعرية المُعَبَّر عنها في النص. وإذا كان فن الإلقاء على هذا المستوى من الأهمية، فإنه بذلك يستوجب تطوير كثير من المهارات أثناء قراءة النصوص الشعرية بصوت عال، والتحكم في الإيقاع والانفعالات. من وجهة نظر مختلفة، أرى أن «الصوت» المترتب عن الإلقاء بكل عناصره الحسية والعضوية، قد يُفوِّت على المتلقي فرصة الإنصات الحقيقي لنبض القصيدة وصوت الشعر المتواري خلف حجاب المعنى، الذي نستوعبه ونتذوقه بالتلقي الصامت والمنفلت من ربقة الذائقة «الغنائية»، الجهيرة والمنحصرة في عملية الإلقاء والاستماع. إن القبض على الحالة الشعرية يتطلب شاعرا لا منشدا، ومتلقيا من نوع خاص، يمتص رحيق الشعر بالإنصات لنبضه واكتناه جوهره النفيس بسبر أغواره العميقة، لا منصتا «يطرب» لنبرات صوت القارئ في حال من الانتشاء الحالم. فإذا كانت الغاية من قراءة الشعر هي إيصال هذا الشعر إلى قلب المتلقي وإقناعه بجدواه، فإن الوسيلة الأمثل لتحقيق ذلك هي تفادي «تجويد» القراءة واستدرار إعجاب المستمع المأخوذ بكل ترنيمة أو ترتيلة توقع المتلقي في حال من الخَدَر الحسّي.
أمل الأخضر: حالة الحضور
تظل للإلقاء حظوة خاصة في إبراز ملامح النص، من حيث علاقته بصاحبه إذ يتسنى له إخراجه من حالته الحيادية، وإشراكه في الحالة الوجودية التي انبثق عنها النص في بادئ الأمر؛ فتتجلى للمتلقي دلالات جديدة، وتنكشف له معانٍ خفية، تبعث على الإدهاش وحصول اللذاذة المضاعفة. فأثناء الإلقاء يمتزج ما هو عاطفي وذاتي، بالعودة إلى حالة الخلق الأولى، المفعمة بالمشاعر والانفعالات. تتخلل القراءة الشفهية تأثيرات إضافية: حركة الجسد، طبيعة الوقفة، تقطعات الصوت، تعابير الوجه.. يستمد منها الشاعر قوته، من أجل خلق حالة الدهشة والتقبل الحسن من طرف المتلقي/ المستمع للنص. فالإلقاء باعتباره جسرا ممتدا بين طرفي العملية الإبداعية، هو في الأصل طاقة خلاقة، ومشرعة على مجموعة من الأحاسيس، ومضافة إلى مجموعة من الدلالات الواردة في النص المكتوب. كما يغدو، بهذا المعنى، ملمحا جماليا لنص من النصوص، يشحذ عبره القارئ الأول، أو المتلقي الجيد له، طاقته ومشاعره وبعض أعضاء جسده، بغية استبطان النصوص واستغوارها وكَشْف ما فيها من معانٍ ودلالات، سواء بالنسبة إليه ككاتب أولي للنص، أو كقارئ مستمتع بما يقرأ، أو مكتشف لهذه الدلالات الجديدة المنبثقة من الحالة النفسية المتخلقة بفعل اندماجه في المقروء.
أما حضور النص عند زمن الإلقاء، فإنه يزاوج بين اللحظات الأولى لعملية الإبداع. مثلما أن يستعيد طبيعة النص، ويجعل الكاتب لنصه في الوضعية الجديدة المشتركة مع الحضور، بعيدا عن عزلته المعهودة، وأمام جمهور حي، يستقبله مباشرة على نحو حميمي وخاص. إذن، ثمة تشابك، وتداخل لمجموعة من الوضعيات إبان عملية الإلقاء، ومن ثم نفسر هذا التباين الحاصل بين استقبال النص الشعري مكتوبا، واستقباله شفويّا لحظة إلقائه.
كاتب مغربي