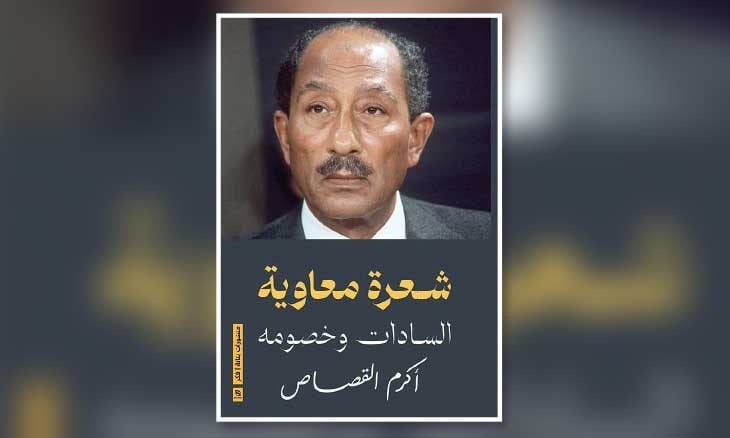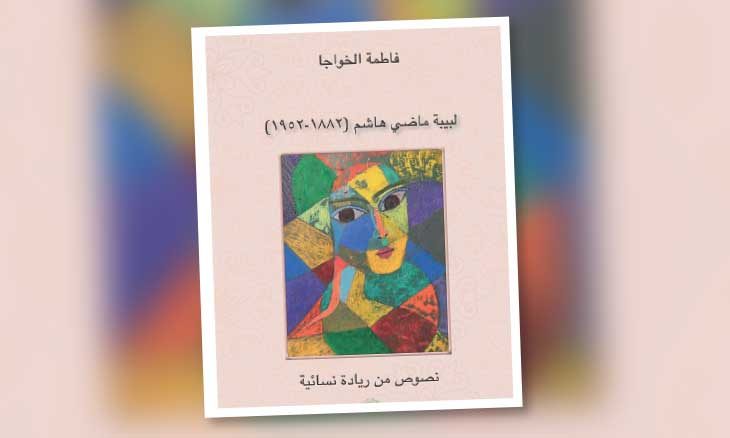في الطابور
بقلم فراس اكرم الرملاوي -غزة –
رن هاتفي برسالة من إحدى المؤسسات الإنسانية تدعوني لاستلام طرد صحي. تناولت الأمر بجدية وتوجهت إلى العنوان المذكور، لأجد نفسي أمام صفين متوازيين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، يمتدان كخطوط الألم في لوحة حرب لا تنتهي.
وقفت في الطابور، رافضًا البحث عن واسطة تعجل وصولي. بينما كنت أنتظر، بدأت أتحدث مع الرجل الذي أمامي. كان خمسينيًا، ظهره محنيًّا كأن الدهر قد راكم فوقه سنوات من الشقاء. سألته: “لماذا لا يقف أحد أبنائك بدلاً منك؟” نظر إليّ بعينين غارقتين في الرماد، وقال بصوت متحشرج: “أبنائي؟ إنهم هناك، تحت أنقاض بيتنا، لم يبقَ لي منهم سوى طفلة صغيرة، تركتها مع عمتها حتى أعود…”
لم أستوعب وقع كلماته حتى باغتني بكاء الرجل الذي خلفي. التفتُ إليه، فرأيته يكتم أنينه بين يديه المرتعشتين. سألته ما به، فرفع رأسه بوجه محفور بالحزن وقال: “دخلوا منزلنا، أحرقوه، اقتادوا ابني إلى مكان مجهول… لا أدري إن كان في معتقل أم تحت التراب.”
إلى يساري، كانت هناك امرأة تهمس لرفيقتها، وصوتها متقطع كأنها تحكي حلماً لم تستوعب بعد أنه كابوس. قالت: “ذهب حفيدي يبحث عن كيلو من الدقيق ،وصل إلى دوّار النابلسي… وعندما عادت الدبابات، لم يبقَ منه سوى بقعة على الإسفلت، لم نعرف ملامحه.”
عندها، تنهدت أخرى، ورفعت رأسها المثقل بالمآسي، وقالت بصوت أشبه بالاحتضار: “أما أنا… فقد وجدت أمي في مجزرة مدرسة التابعين، لكنها لم تكن أمي بعد الآن… كانت كومة من اللحم، حملها رجال الدفاع المدني إلى الميزان وقالوا لي: هذا وزن أمك، يمكنك دفنها الآن.”
شعرت حينها أن الطابور لم يكن مجرد انتظار… كان سردابًا من الأحزان، كل خطوة فيه تقود إلى قصة أكثر إيلامًا. كاد دوري أن يصل، لكنني انسحبت، وعيناي مغرورقتان، لم أعد أحتمل سماع المزيد، ولم أعد أجد في نفسي رغبة باستلام أي شيء… سوى الصمت.