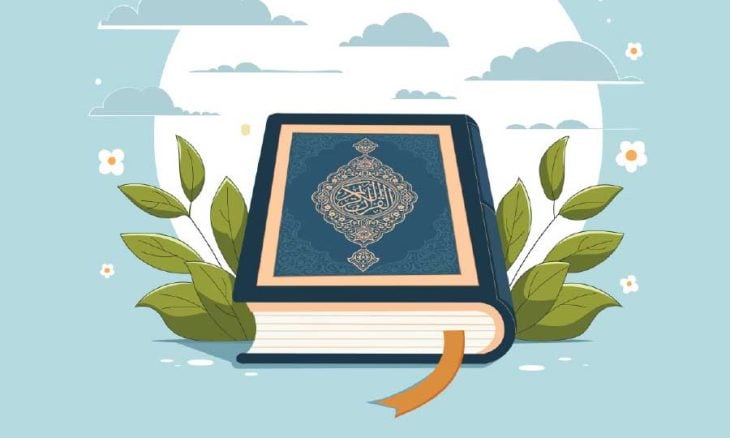
الغيّ والرّشد في التنزيل

توفيق قريرة
(1): الغواية الأولى
من العبارات التي تتكرر في القرآن ولها استعمالاتها الخاصة عبارة الغيّ، وبعض المشتقات القريبة منها كالفعل أغوى، أو اسم الفاعل غاو. ونريد في هذا المقال أن نقترب من هذا المعنى باعتماد وسائل إدراكية في فهم المفسرين له، وأن ننظر في السياقات التي وردت فيها هذه العبارات.
يردّ أهل الاشتقاق عبارة الغيّ والغواية وفعل الإغواء إلى جذر واحد هو (غ. و. ي) ونحن سنقارن بين جذور ثلاثة يتغير بعض من حروفها ولكنّها تلتقي، أو تفترق في الدلالة وهي (غ. و. ي) و (ه . و .ي) و ( ك.و. ي). ولا تختلف الجذور الثلاثة إلاّ في الحرف الأوّل وتغييره مع الاحتفاظ بالحرفين، يسمّيه علماء اللسان بالاستبدال، ويعنون به أن تغير حرفا وتترك البقية لترى إن كان لذلك التغيير وظيفة في تمييز دلالة من أخرى؛ وهذا التغيير علامة على أنّ للحرف دلالة تمييزية، كما يقولون، فالغين دورها تمييزي لأنّه حين تستبدل من واو أو كاف تغير المعنى. نحن سنفترض أنّ تغيير الحرف الواحد في هذا الثالوث الاشتقاقي لا يقود إلى إخراج المعنى عن دائرة دلالية موحّدة، تشترك فيها الجذور الثلاثة. ذلك أنّك تجد شيئا من التردّد والترجيع الذي هو كالصدى بين ما يفيده كل جذر في دلالات الكلمات المشتقّة من الجذور الثلاثة. وهذا يعني مبدئيا أنّ الغواية والهواية والكي فيها ترجيع صدى دلالي، وبينها تعالق معنوي كأن تقول إنّ الغواية مثلا درجة متطوّرة من الهواية، وأنّ الكيّ نوع من عذاب له صلة بهما.
معنى المسافة الذي قصدناه إذن هو، معنى يمنحه لنا القول، إنّ المعاني في درجات بينها مسافات فالهوى مثلا درجة من الغواية أولى، والكي درجة من الغواية أقوى في فعل الهواية، والكي مسافة تجد فعل الغواية وسطا بينهما. يسمّي العرفانيّون هذه الطريقة في ترتيب المعاني بالمسترسل ويعنون به أنّ المعاني لا تتقابل أو تتضادّ ثنائيّا تضادّ الليل والنهار، وتضاد الغواية والرشد وتضاد الكيّ بالنار والتبريد بالماء؛ بل إنّ المعاني تتعامل دلاليا في ما بينها تعاملا تدريجيا وتتوزّع على مسترسل يشبه الطيف. هو طيف دلاليّ يمتد وفق تصوّر أو تمثل لميدان إدراكي معين، فيه طرفان أحدهما موسوم بالإيجاب والثاني بالسلب أو يوسم أحدهما بالكثرة والثاني بالقلة. سنفترض أنّ الغواية والهواية والكيّ تنتمي إلى مسترسل دلالي واحد ينتمي إلى ميدان إدراكي مشترك سنسميه الجذب والإيقاع.
الأجسام في الكون يمكن أن تكون كيانات تتحرّك بفعل جذب معيّن: أي بتأثير قوّة تجذبها إليها؛ فالأجسام إذن في حركة الجذب هذه سائرة طوعا أو كرها إلى نقطة هي نهاية فعل الجذب، وسنسميها نقطة الإيقاع. فعل الغواية هو فعل جاذب وفعل الكيّ هو منتهى نقطة الإيقاع، وفعل الهواية هو المرحلة التي يمرّ بها الجسم المغويّ، لكي ينتهي إلى هدف ومهبط للحركة تكون منتهاه وهو الكي بمعنى الاحتراق الذي يبلي الأجسام المنجذبة الهاوية. في جذر (ه. و. ي) أسرتان اشتقاقيتان متعاملتان هما، السقوط في الحبّ ومنه هوِيَ يهوى السقوط في الجبّ ومنه هوَى يهوِي. في الجذر (ه. و. ي) إذن سقوط أوّلي بعد الجذب بالغواية وقبل الوقوع في الكيّ وبداية التلاشي.
في القرآن الكريم يرتبط أوّل فعل للصراع بين آدم والشيطان بفعل الغواية ففي الآيات (75، 83 من سورة صاد ) تنقل لنا المساءلة والاستخبار بين الله وإبليس كيف أنّ النزول إلى الأرض سيكون متبوعا بفعل الغواية؛ قال: ( فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (82- 83).أغلب المفسرين سكتوا عن تحليل فعل الغواية بما هي نقطة في مسار أو فعل متولد أو مولد لغيره، واكتفوا في فعل الغواية بتفسير آلياتها، أو آلاتها التي تنتج ما سميناه نحن بالإيقاع: إيقاع آدم في الخطيئة ليستحق النار أو الكيّ. يقول القرطبي: «قال: فبعزّتك لأغوينّهم أجمعين لما طرده بسبب آدم؛ حلف بعزة الله أنّه يضلّ بني آدم بتزيين الشهوات وإدخال الشبهة عليهم ، فمعنى «لأغوينهم»: لأستدعينّهم إلى المعاصي، وقد علم أنه لا يصل إلا إلى الوسوسة، ولا يفسد إلا من كان لا يصلح لو لم يوسوسه، ولهذا قال: إلا عبادك منهم المخلصين أي: الذين أخلصتهم لعبادتك، وعصمتهم مني. وفي سورة الحجر ( 39 ) ذكر لفعل الغواية في سياق شبيه من مخاطبة إبليس للذات العلية: (قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ).وفي تفسير هذه الآية أصّل محمد الطاهر بن عاشور فعل الإغواء بأنه خلق رباني ألبسه إبليس ويريد إبليس أن يلبسه للبشر يقول: الباء في (بما أغويتني) للسببية، و(ما) موصولة، أي بسبب إغوائك إياي، أي بسبب أن خلقتني غاوياً فسأغوي الناس. واللام في {لأزينن} لام قسم محذوف مراد بها التأكيد، وهو القسم المصرح به في قوله: {قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين} [سورة ص: 82 ] .
وقد أطال صاحب التحرير والتنوير في تفصيل ما سيكون عليه فعل الغواية مع المغويين من البشر، وكيف أنّ هذا الفعل الذي هو من تلبيسات إبليس للبشر وظيفة من وظائفه بالنسبة إلى البشر حتى لكأنّه لا وظيفة له خارجها فإن لم يكن قد سمّي إبليس لتلبّسه بفعل الغواية لسمّي الغاوي؛ والتزيين: التحسين، أي جعل الشيء زينا، أي حسناً.. والغواية بفتح الغين: الضلال. والمعنى: ولأضلنّهم». إن كان لنا أن نفسر كلام بن عاشور عن فعل الغواية بكلامنا نحن عنها بأنّها فعل جاذب قلنا إنّ الغواية من أصلها قوّة إلهية مبثوثة في روح إبليس وإبليس سينفثها في البشر الذين يمكن أن يتأثروا بهذا النفث ويستدرك بن عاشور استدراكا إيمانيا بأنّ ذلك لا يعني أنّ الغواية من أصلها فعل ربّاني يريد أن يهلك به خلقه أجمعين، وجعل المُغْوَيْن هم الأصل، واستثنى منهم عباد الله المخلصين»، لأن عزيمته منصرفة إلى الإغواء، فهو الملحوظ ابتداء عنده، على أن المُغوَيْن هم الأكثر. وعكسه قوله تعالى: ( إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك) [سورة الحجر: 42 ]. والاستثناء لا يُشعر بقلّة المستثنى بالنسبة للمستثنى منه ولا العكس» .
لقد كان فعل الجذب بالغواية في حكاية إبليس مع آدم بواسطة حواء والثمرة، عندها بدأ الجذب بأن جُرّ آدم جرّا إلى خارج الجنة، وبدأ عندئذ فعل الهبوط فقال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر»، أو فعل الخروج فقال تعالى: (فاخرج منها) (الحجر: 34)؛ فالهبوط حركة عمودية من علوّ إلى قرار هو الذي سيسمّى الدنيا تسمية ليست عبثية لأنّها مهبط الخلق الأوّل ومكان قراره بالموت والإقبار. لذلك كان تصوّر الدنيا والجنّة تصوّرا عموديا في النص القرآني وهو تصوّر استبدلت فيه الدنيا بالنار في الأدبيّات المسيحيّة؛ ففي هذا التصوّر، فإنّ النار هي الطبقة الدنيا بالنسبة إلى طبقة أعلى منها هي الجنة.
أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية







