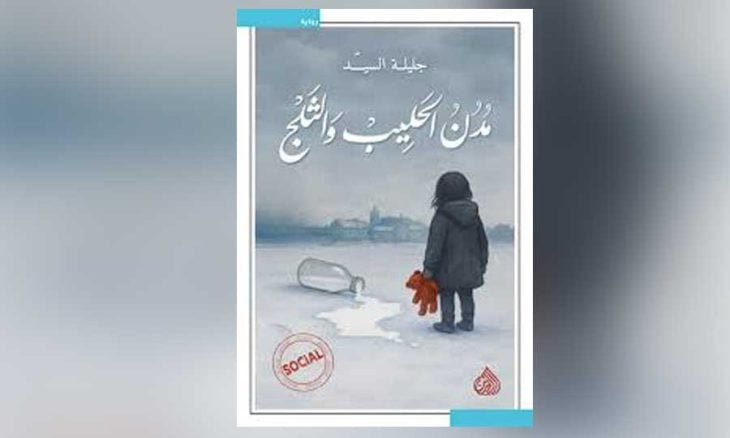في مواجهة الهمج
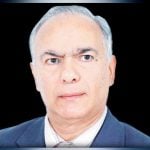
رشيد المومني
ما الذي يستطيعه الشاعر، إزاء أزمنة مصابة بلوثة القتل والإبادة، ومتخصصة في إحراق المواثيق الحقوقية، التي دأبت الشعوب على الاحتماء بمدوناتها من شرور طغاة، مختصين في تشويهها وتجريدها من نبل وظائفها، في السر كما في العلن؟
ثم ما الذي يستطيعه الشاعر ذاته، إزاء الأسئلة الحارقة التي دأبت هذه الأزمنة الطاعنة في الذبح على التلويح بها؟ بعد أن أمست أكثر من أي وقت آخر، تعيث خرابا في جمالية نصوصه، التي كانت إلى حين، سعيدة بانزياحها التام عن سطحية المعيش ورتابته.
تلك هي ملامح وضْعِيةٍ لا يتردد معها واقع الهيمنة، في الكشف عن شراسته وعنفه، بوصفه طرفا أساسيا في صياغة مصائر العباد والجماد، وأيضا بوصفه فاعلا مركزيا، في تأطير ما تسفر عنه المكابدات البشرية من أعمال فكرية وإبداعية، ذلك أن تَفَتُّحَ شهية القَتَلة لالتهام المزيد من الأوطان، وممارسة مَا جَدَّ من برمجيات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تتدخل بشكل مباشر في تضييق الهامش الإبداعي – وتحديدا لدى الشاعر – لتحرمه من حرية اختياراته التي يجد فيها مسالكه الجمالية ضالتها المنشودة. وفور مداهمة جحافل القتلة لتساؤل الشاعر، فسينتبه إلى واقع مراوحته الدائمة بين نداءات الشعري ونداءات الواقعي، بما يحف دلالاتهما المعجمية من تضاد واختلاف. وهي النداءات الموهمة باختفائها، كلما تظاهرت شراسة المعيش بتواريها في خلفية الصورة، مفسحة بذلك المجال، لإمكانية انتشاءٍ عابرٍ بوهْم أصل جمالي، لا مجال للتشكيك في أصالة جوهره وصفائه. أي الأصل الهارب من قبضة الواقع . فيما الهمجُ يجاهرون بضراوة تفجيرهم لبراميل القهر، وإحداث المزيد من الفواجع الكارثية ، التي من شأنها تعرية أوهام هذا الأصل، والكشف عن قابليته الفورية للاحتجاب، كي يجد الشاعر نفسه خلسة ودون سابق إنذار، معزولا عن فراديسه الشعرية، المترعة بعبق الخصوصية، وفرادة الاجتراح. كما سيجد نفسه معْنيا، بحتمية مواجهته اللامشروطة لمخططات الترهيب والترويع.
وغني عن القول، إن هذا التورط هو في حد ذاته، نتاج الامتداد الطبيعي لدلالات المفاهيم الحافة بمقولة الالتزام ، والتي تظل جاهزة لتذكيرنا بالمواسم التاريخية لحراكها التغييري. بمعنى أن الشاعر، ومهما أسرف نظريا في تجاوزه لواقع الحال، إلا أنه لا يلبث أن يستشعر في دواخله يقظة ذلك الإحساس الجارف بأخلاقيات المسؤولية وقيم الواجب، الذي لا يلبث أن يعود بمفهوم الشعر إلى بؤرته المركزية، ذاتِ العمق الاجتماعي والإنساني. وفي اعتقادنا أن تلك اليقظة، تنبثق من توقيت مفصلي يتم فيه تجسير العلاقة القائمة بين القيم الإنسانية المناصرة للشعوب المضطهدة، وقيم الكتابة الشعرية، بوصفها التعبير الجمالي والإنساني عن آفاق الخلاص الروحي المستشرفة عادة من قبل الكائن. مع الإقرار بأن الشعر، وبمختلف مداراته واجتراحاته، لا يلبث أن يفقد نقاء وصفاء جماليته، حالما يشرع في معاينة جحافل العدوان، وهي تفهمك بلا هوادة في ممارسة طقوس الفتك، بمباركة مكشوفة من صمت وتواطؤ المنتظم الدولي، حيث يفضي الإمعان في عرض مَشاهدِ القيامةِ، إلى إشاعة حالة مزمنة من اليأس لدى الشاعر، وإلى إخماد شعلةِ الرؤية والفكر، خاصة حينما يتسلم التوثيق السمعي والبصري زمام المبادرة، كي يجهز ببلاغته التعبيرية والتوصيلية، على أقوى ما يتطلع المجاز إلى بنائه من مشاهد القتل والدمار. فجَرَّاء هذا العنف المشهدي، سيُحْشَرُ الشاعر المثقل بقيم الانعتاق، تلقائيا وغصبا عنه في زاوية اغترابٍ لا قِبَلَ للانزياحات الأسلوبية ببرودته. وتحديدا ستسفر إشكالية «جدوى» الكتابة والقول، عن أوهام ثوابتها، مكرسة بذلك عبثية مراوحتها الدائمة والمرهقة بين الحاجة إلى شعرية مسكونة بتهاليل نرجسيتها، وأخرى منذورة لمطاردة أشباح الشر، حيث ما من مجال محتمل لرأب الصدع الفاصل بين الحدين، ما دامت آلة القتل لا تتردد في تصفية كل ما له صلة عن قُرب، أو عن بُعْدٍ بكرامة الكائن. وما دامت الآلة ذاتها، قادرة على قطع دابر الكتابة جملة وتفصيلا، قدرتها على إلزام الذات بالامتثال لقدر معاينتها لأهوال المرئي، بعيدا عن الحلم بأي تغيير محتمل، سواء من جهة القول أو الفعل.
لكن، رغم تجذر هذه الاستحالة في دواخل الكتابة الشعرية، إلا أنها لن تفُتَّ في إرادة بحثها الدؤوب عن أفق ممكن، يستجيب بشكل أوبآخر لمقتضيات أسئلتها المنفتحة بإصرار، على الممكن كما على المستحيل . هذا إن لم نسلِّم سلفا بكون هذه الاستحالة هي الأصل في إطلاق شرارات السؤال، التي تستضيء بها الكتابة في ليالي أسفارها وترحالها. إذ مهما تضاعفت ضراوة السحل، ومهما احتَدَّتْ وتعددت الكروب المؤثرة سلبا على مقولة الجدوى، فإن الكتابة الشعرية تستمر في استشرافها لما أمكن من آفاقها المؤجلة، لكن على طريقتها الخاصة بها، بمعنى أنها تظل حريصة على الانتصار للذات الإنسانية، بصرف النظر عن الصيغة الجمالية التي تعتمدها في ذلك، وذلك هو أحد سُبُلها المركزية لترسيخ جوهر استحالةٍ أخرى محايثة، يتعذر صرف الانتباه عنها، التي يمكن توصيفها باستحالة الإمعان في الاستهانة بالهوية الوجودية والإنسانية للكائن، والتي تقتضي منه إبداء المزيد من إرادة الصمود والتصدي، المضاد لجبروت وعنجهية سَدَنَة الإبادة. ولن يكون من الضروري ضمن هذا السياق، اقتراح ترسيمة محددة ومُلزِمَةٍ لمفهوم التصدي والتغيير، المطلوبين من القول الشعري، على أرضية أخلاقية أو سياسية ما، باعتبار أن هذا الاقتراح، من شأنه إعادة إنتاج مدونات مشوبة بعاهات التكرار والاستنساخ. علما أن إشكالية التغيير، تتميز بتنوع وسائطها انسجاما مع تنوع مجالاتها واختصاصاتها. فما يستدعي تغييره بالحجاج، يختلف مبدئيا عما يستدعي تغييره بقوة السلاح. فضلا عن كون المجالين معا، يختلفان جذريا عن مجال اشتغال الشعر المستقل بآلياته التغييرية.
وبالنظر لما يشوب سؤال التغيير من التباس، فإن معضلة الخلط، الناتجة عن سوء الفهم، تظل واردة باستمرار. ما يؤدي إلى إلحاق غير قليل من التشويش، على مفهوم التغيير ككل، وأيضا على منهاجيات تفعيله. وكما هو معلوم، فإن هذا الخلط سيظل محتفظا براهنيته، وكذا بالعوامل المؤثرة في تنشيط آلياته، خاصة بالنسبة للقائلين بالوظيفة النضالية للشعر، بوصفها شرطا أساسيا من شروط إنجاز عملية التغيير . وبالنظر لعدم اقتناعنا بضرورة مزاحمة الشاعر لاختصاصاتٍ تبدو لنا بعيدة عن مجال اشتغاله، فإن دائرة مفهوم التغيير تصبح أكثر اتساعا، حيث لا تلبث إشكالية التعقيد الملازمة للتواصل، أن تلقي ظلالها على الموضوع . ذلك أن وظيفة التواصل ضمن متطلبات الحياة العامة، لاسيما تلك المقترنة بالقضايا المصيرية ، تستوجب توافر حد موضوعي من حدود التفاهم بين الأطراف المعنية كافة. وهو ما يعتبر لاغيا بالنسبة للخطاب الشعري، الذي يستند عمقه التغييري إلى تواصل حر، لا يتقيد فيه الباث ولا المتلقي بأي قانون يؤثر بشكل مباشر في تضييق هامش الخصوصية الشعرية، على حساب توسيع نطاق المصلحة العامة.
فعالَم الشاعر هو عالَم لُغَوي بامتياز، وحالما تتيسر حالة من التوازن بينه وبين مقتضيات الواقع، يكون كل شيء قابلا للتموضع داخله، بعيدا عن الإخلاص بشعرية المقام وجماليته. غير أن هذا العالَم اللُّغوي، لا يلبث أن يفقد إمكانية تفاعله مع المَعيش، أو بالأحرى مع المُمِيتِ، فور شروع الهمج في تحويل فضاءاته إلى خرائب، يتعالى من جنباتها صراخُ الجماجم واستغاثات الأشلاء.
*شاعر وكاتب من المغرب