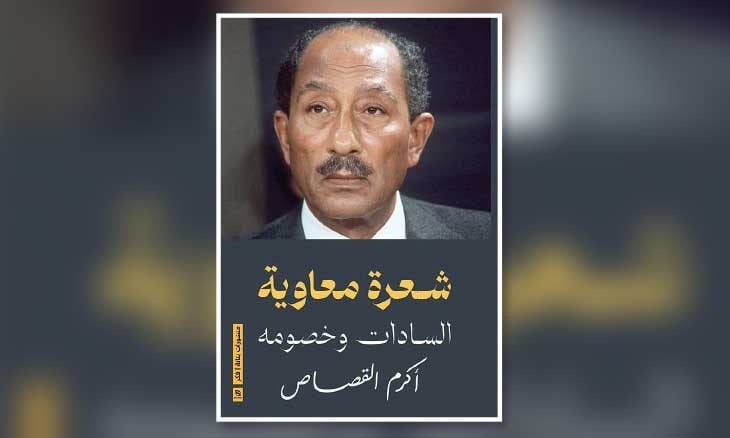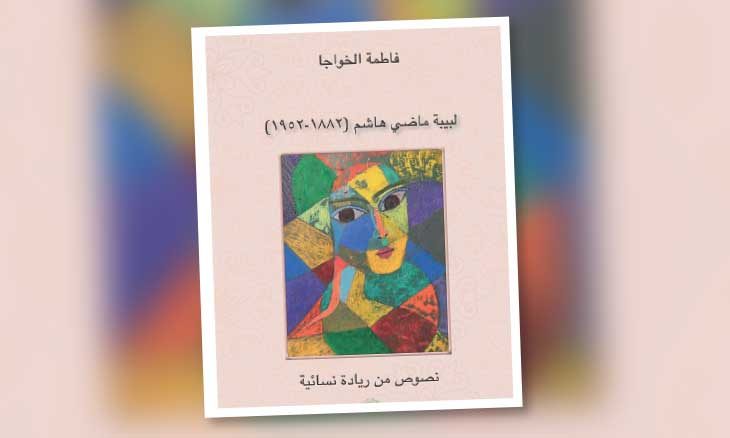السريالية الدارجة من حولك!

إبراهيم عبد المجيد
اعتذر من البداية عن استخدام كلمة السريالية بعيدا عن الفن، لكنها الحيرة، أو ما يردده الناس بشكل عابر، يصبح حقيقيا في كثير من الأحوال. من السهل الحديث عن نشأة الحركة السريالية في فرنسا، وكذلك نشأتها في مصر في الفترة نفسها، بعد الحرب العالمية الأولى، وما عرفناه من فنانين تركوا بصمتهم الفنية في العالم، وحالة الرفض التي جاءت بالحركة، ليس للمذاهب الفنية الأخرى فقط، لكن للواقع الذي صار ما وراءه، أو ما فوقه إذا أردت ترجمة مباشرة، هو الحقيقة الأوْلى بالتجسيد. من السهل أن تجد في مصر الآن فنانين مثل ماهر جرجس أو محسن البلاسي، يبدعون في الحقل نفسه الذي لا حدود واقعية له، وتتحدث عنهم.
لكنني أقف عند الكلمة حين تقال، بشكل دارج ولا تزال، تعليقا على شيء غير معقول. جريمة أو نداء وسط الليل لامرأة أو رجل وحيد، أو حتى مدرس في الجامعة يحدد للطلاب ما يقرأونه من كتابه، ثم يأتي الامتحان في ما لم يقرأوه، أو مباراة كرة قدم يتعمد فيها لاعب إبعاد الكرة إلى الخارج، في الدقائق الأخيرة، ليضيع الوقت حين يكون فريقه فائزا. بالمناسبة كان في مصر في الستينيات لاعب كرة قدم شهير اسمه مصطفى رياض في نادي الترسانة. كان لاعبا رائعا ومعه لاعبان لا أنساهما، هما حسن الشاذلي وبدوي عبد الفتاح. كان الثلاثة يشكلون ثلاثيا شهيرا بالمعنى الحقيقي للكلمة. كان مصطفى رياض في العشر دقائق الأخيرة في كل مبارة تتقدم فيها فرقته، يتعمد إضاعة الوقت بطريقة تثير ضحكنا. فحين تخرج الكرة من لاعب من الفريق الآخر متجاوزة خط التماس على أحد الجانبين، يجري بسرعة لإحضارها، وتظن أنت أنه يريد أن يكسب الوقت ليلقي بها إلى الملعب بسرعة، لكنه ما يكاد يقف على خط التماس، حتى يتركها خارجه من جديد تتدحرج بعيدا، فيتحرك زميل آخر ببطء لإحضارها.
ساهمت أنا يوما في هذا المشهد السريالي بسبب الكرة، ليس لأني كنت لاعبا في أحد النوادي، رغم لعبي لها في الشوارع والمدرسة وإتقاني لها، لكن حدث هذا المشهد عام 1970. لم أكن طبعا أعرف أنه سيحدث. في ذلك العام كانت المباراة النهائية لنادي الإسماعيلي، مع نادي الإنكلبير الكونغولي، على بطولة افريقيا. بالمناسبة كنت أشجع كل الأندية غير الأهلي والزمالك، خروجا على العرف العام، دون فهم سياسي لما أفعل. كنت في ذلك الوقت أعمل في محطة الكهرباء الرئيسية لشركة الترسانة البحرية. كانت المبارة ليلا على الأضواء الكاشفة في موعد عملي، الذي كان من الثالثة حتى الحادية عشرة. كيف حقا تفوتني المباراة ولا تلفزيون في العمل، بل لا أحد تقريبا في كل ورش الترسانة بعد النهار. تركت المحطة وذهبت إلى مقهى خفاجي القريب في منطقة الورديان. عدت سعيدا بفوز الإسماعيلي واستمتعت كعادتي بلاعبيه مثل أبو جريشة وسيد بازوكا وميمي درويش. وجدت رجال أمن الترسانة ومعهم رجال البوليس في انتظاري على باب المحطة. كان السؤال كيف تركت المحطة، وكانت هناك غارة تجريبية اطفأت فيها أضواء الميناء كلها، وظلت شركة الترسانة مضيئة فأفسدت الغارة. كانت الغارات التجريبية تتم كثيرا كشكل من أشكال الاستعداد للحرب.. «سيتم تحويلك للتحقيق». قيل لي ذلك فوجدت نفسي أقول «زهقنا من الغارات التجريبية. أرحمونا وشنوا غارات حقيقية على إسرائيل». تصورت في ما بعد، الميناء كله مظلما إلا مكان صغير هو شركة الترسانة، لو صار لوحة فنية فربما تبعث الأمل، أرحت نفسي بالسريالية أنا المحب للفنون.
تستخدم كلمة السريالية حقا للراحة النفسية كثيرا في الحياة اليومية، تعبيرا عن عدم القدرة على التفسير، لكن أيضا عدم القدرة على الاقتناع أو الفهم، أو عجائبية المشاهد الفارقة للعقل. من المشاهد السريالية بالمعنى الدارج الذي أقصده، الكثير في مصر الآن. منها المرأة التي ألقت بزوجها من الدور السادس، لأنه يسهر كل يوم في المقهى، أو حوادث القتل لفتيات يرفضن الزواج فيقتلهن من تم رفضه، أو من يقتلن ويدفن الضحايا في بيوتهن تحت البلاط، وغيرها يمكن الوقوف عندها، لكنني أقف عند حادثة إصابة شخص بجروح في الرأس ونزيف في المخ، نتيجة إلقاء حجر من صبية وأطفال على قطار يمر في الدلتا. ذلك يتكرر كثيرا جدا وإن لا تتجاوز الإصابات القطار نفسه، فيسمع الجالسون صوت اصطدام الأحجار به، ونادرا حتى ما تكسر زجاجه إذا أصابته. رأيت ذلك كثيرا في رحلاتي بالقطار حين كنت متيما بها، لكنها ما زالت قائمة رغم عبور السنين، وهذا ما أدهشني، خاصة أن هناك كاميرات على جانبي الطريق، يمكن بها البحث عن الجناة والقبض عليهم وعقابهم تنفيذا للقانون. للأسف رغم بشاعة الحادثة، وجدت نفسي أرى لوحة سريالية لم يرسمها أحد، لفريق من الأطفال يقفون متباعدين يقذفون القطار بالحجارة. لكنني رغم ذلك أكرر السؤال، كيف لا يتوقف هذا رغم وجود الكاميرات، ومن هو المقصر فيه بينما نعرف الجناة. هل تشجع الحكومة المذهب السريالي؟ ربما.. فمن المشاهد السريالية أيضا رغم بشاعة السياسة، قانون الحبس المفتوح، الذي بسببه لا يخرج أحد من السجن إلا نادرا، وتعاد له القضية وهو في السجن، بالاتهامات القديمة نفسها، مثل الاتصال بجماعة إرهابية ونشر الشائعات المخلة بالمجتمع، ويظهر في كل مرة بالمحكمة. ربما يأخذ الأمر شكلا وجوديا، فما دام الزمن لا يمر في الوجودية كفلسفة، فلنجعله كذلك في حياة المتهمين السياسيين، رغم عدم معرفة من يفعلون ذلك بالوجودية.
من المشاهد السريالية، بالمعنى الدارج، التي رافقتني في صباي وشبابي، المظاهرات المدفوعة الأجر للعمال، في استقبال أو دعم الزعيم، والتي أقمت لها رواية كاملة هي «بيت الياسمين، والتي ازدادت سرياليتها حين قرر الموظف المناط به ذلك، أن يقتسم الأجر مع العمال ولا يذهبون. يستمر الأمر عشر سنوات ويتم القبض عليه مرة واحدة أيام مظاهرات يناير/كانون الثاني 1977، فيصرخ لمن جاءوا للقبض عليه «أنا الذي أقود المظاهرات لدعم الرئيس بالأجر، فكيف تعتبرونني سببا في مظاهرات مجانية». من المشاهد السريالية التي جرت حولنا أخيرا، جلسات الحوار الوطني الذي لا أعرف أين هو اليوم، وأين ذهبت نتائجه، وتخيلت أنه قد تم إغلاق الباب على من فيه، رغم حسن نواياهم، كما أغلق الحاكم بأمر الله باب حمام النساء عليهن. هذا كله لاعلاقة له بالسريالية الحقيقية في الفنون والآداب، كما قلت وأكرر، لكن له علاقة بالراحة النفسية حين تقول «دا شيء سريالي» الكلمة التي وصلت للكثيرين ممن لا يعرفون معنى السريالية. رغم أن كلمة عبث هي الأقرب، لكن لا أعرف كيف تسللت كلمة سريالي إلى الألسن، رغم أن كلمة «عبث» أيضا وراءها فلسفة إنسانية عميقة، لكن ربما أن كلمة عبث الدارجة، فيها شيء من القذف.
يحدث الآن هجوم على المسلسلات التلفزيونية باعتبارها قللت من شأن الحارة المصرية، وينسى الكثيرون أن الرقابة على المصنفات الفنية، أغلقت الباب أمام الأعمال السينمائية، التي يمكن أن تناقش القضايا الإنسانية الكبيرة، أو أن يظهر قاض أو ضابط او محام، أو أي ممن يعملون في الجهات التي يسمونها سيادية، في شكل درامي، أو حتى كوميدي باعتباره مخطئا، فلم تبق إلا الحارة وما فيها من بشر لا حماية لهم، ومن ثم تنتفض السوشيال ميديا، هذه ليست حارتنا الحقيقية، باعتبار كذبة أن الفن يعكس الواقع ولا مساحة فيه للخيال. لا ينتبه أحد إلى أن هذا هو الواقع المتاح الآن رسميا، في الدولة التي تريد تغيير المسلسلات لتكون هادفة. أما إذا ابتعدت عن مصر، فحين تقرأ وترى ما يحدث في غزة منذ أكثر من عامين، والأمة العربية تنتظر الفرج، بينما ألف لوحة مثل «الجورنيكا» التكعيبية، تتحقق كل يوم في غزة، كأننا ننتظر من إسرائيل أن تقدم الفرصة الكبيرة للفنانين. وليس لمثلي غير الدموع.
كاتب مصري