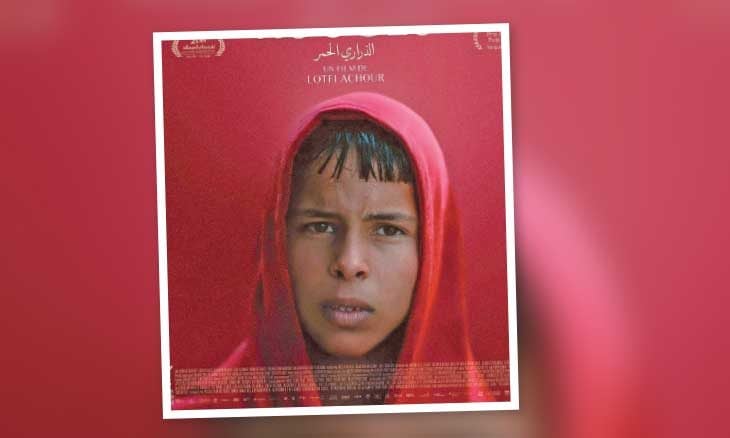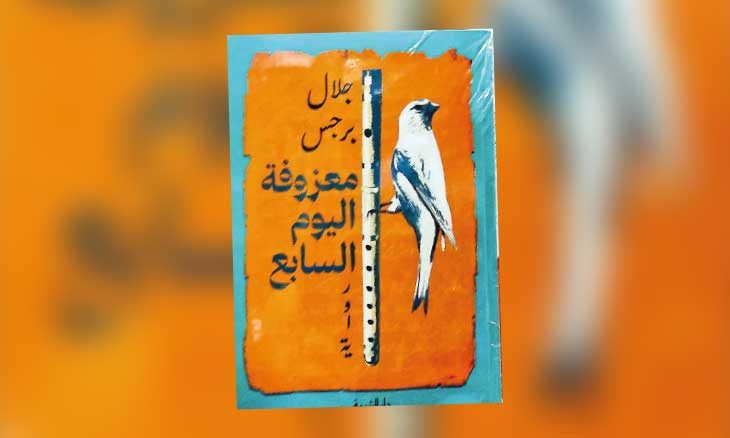في الجزائر… «العربية» خلف حيطان الدين والسياسة

سعيد خطيبي
من بين الأساطير التي تكرست في الجزائر غداة الاستقلال في 1962، أن اللغة العربية كانت «مُحرمة» زمن الاستعمار، وهي فرضية لا تُطابق الواقع. لكن الرئيس الأول أحمد بن بلة أصر عليها، وجعل من هذه اللغة حصاناً في تصفية حساباته مع المُستعمر القديم. وعندما وصل هواري بومدين إلى الحكم عقب انقلاب، اختلف مع سلفه في القضايا كلها، عدا في المسألة اللغوية، وفي رسم حدود سياسية لها.
تحولت العربية إلى قناع من أجل إرضاء المواطن، في الداخل، وتخويف الفرنسيين في الخارج. ثم توالت السنوات، من غير أن تخرج هذه اللغة من خندق السياسة، بل صارت منذ التسعينيات محل تجاذب بين الساسة من جهة، ورجال الدين من جهة أخرى. فقدت، شيئاً فشيئاً، قيمها الجمالية واللسانية، في المخيلة الجزائرية، وصار الناس يُصنفون أيديولوجياً بحسب تحكمهم في العربية من عدمه. هذا الاختزال الذي تعرضت له حرمها من وضعية سوية في البلاد، فالساسة الذين «اختطفوها»، ومن بعدهم رجال دين، لم يفعلوا شيئاً قصد تطويرها وتطويعها على لسان الناس، بل حافظوا عليها في أقفاص، يعودون إليها كلما اقتضت مصالحهم، فعاشت اللغة العربية مثل «غريب»، في صعود ونزول، ما انعكس سلباً على الثقافة الوطنية، التي نعجز عن تعريف لسانها. هل الثقافة الجزائرية عربية أم لا؟ ويمكن أن نلاحظ هذا التوظيف السياسي للغة في المناهج المدرسية، على سبيل المثال. فحين قررت الجزائر تعريب المناهج، عربت فقط ما جرى وصفه بالمواد «الهوياتية»، وهي التاريخ والجغرافيا والفلسفة، بينما المواد العلمية ظلت بالفرنسية. ما يُفيد بأن «التعريب» لم يهدف إلى بسط لغة عربية، بل أرادوا منه خلق ثقة سياسية بين المواطن والسلطة. وإذا طالعنا الكتب المدرسية، في السنين الأخيرة، سنجد أن كتب العربية تتضمن نصوصاً بالفرنسية مترجمة، بينما كتب الفرنسية لا تُدرج نصوصا عربية مُترجمة. هذه الحالة من الانفصام التاريخي، فرضت على اللغة العربية موضعاً، لا تُحسد عليه، مُسيجة بحيطان، عاجزة عن التحرر من منطق الحسابات القديمة.
الفرنسيون والعربية
ساد اعتقاد مفاده أن الفرنسيين حظروا اللغة العربية، حال وصولهم إلى الجزائر عام 1830. لكن الأرشيف يدحض هذه الفكرة. فالفرنسيون أنفسهم كانوا في حاجة إلى العربية، قصد التواصل مع الأهالي، وشجعوا موظفيهم على تعلمها، كما حافظوا على المدارس التي كانت تعلمها، ليس حباً في هذه اللغة، بل بما يخدم مصلحتهم، وقد توالت قرارات رسمية بشأنها. ففي صيف 1850 أصدر نابليون مرسوماً يقضي بإنشاء مدارس فرنسية مُسلمة، في الجزائر، تضمن التعليم للفرنسيين والجزائريين، مع تعليم مزدوج باللغتين. تضمن البند الثاني من المرسوم، أن التعليم مجاني ويُلقن القراءة والكتابة بالعربية للأطفال. فالتعليم المجاني بدأ في الجزائر قبل أن يصل إلى فرنسا، ثم صار كل صف يتداول عليه معلمان، واحد للمواد بالفرنسية والثاني بالعربية. وفي عام 1870، تضاعف عدد المدارس إلى 36 مؤسسة، موزعة على مدن البلاد، كلها تضمن تعليماً بالعربية، جنباً إلى جنب مع التعليم بالفرنسية، يرتادها ما لا يقل عن 13 ألف تلميذ، وهو رقم ضئيل مقارنة بأعداد الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس آنذاك. لأن هذه المدارس انحصرت في المدن، ولم تتوسع خارجها، ولأن هناك تعليما آخر باللغة العربية، كانت تضمنه المدارس الصوفية، التي لعبت دوراً حاسماً في الحفاظ على اللغة، عكس الحركة الإصلاحية، التي ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي، برعاية ما يُسمى «جمعية العلماء المسلمين»، التي أنشأت مدارس خاصة، لكنها لم تكن موجهة سوى للبورجوازية، ولم تعرف إقبالاً واسعاً، لأن تكاليف الانضمام إليها كانت عالية، عكس التعليم في المدارس الصوفية، بمقابل رمزي، وكذلك في الكتاتيب.
معضلة التعريب
عام 1962 استعادت الجزائر استقلالها، في بلد يُحصي 15% من المتعلمين فقط آنذاك. بينما الغالبية كانت في أمية (لكن جلهم كانوا يفهمون اللغة العربية). وانطلق السباق من أجل التعريب. تحولت الفرنسية إلى لغة أجنبية، وطفت إشكالية: من أين نأتي بأساتذة مُعربين؟ شرعت سفارة الجزائر في بغداد، في نشر عروض عمل في الجرائد، وكذلك فعلت سفارات أخرى في دول شقيقة، من غير ان نعلم ما هي المقاييس التي عملوا بها في انتقاء الأساتذة، الذين سوف يدرسون العربية في الجزائر. في الداخل، كل شخص يمتلك حظاً من التعليم صار مدرساً، بغض النظر عن تخصصه. صار المشهد أقرب إلى مسرحية عبثية. تدريس ارتجالي للغة العربية، لأن السلطة جعلت منها سلاحاً في تصفية حساباتها مع المُستعمر القديم. لم تتعامل معها كلغة، بل كقضية سياسية. بالمقابل ظل القطاع الاقتصادي حكراً على اللغة الفرنسية. ظلت الفرنسية هي «لغة الخبزة»، وعجزت السلطة عن الموازنة بين اللغتين، ففي سباقها نحو التعريب، في ستينيات القرن الماضي، بادرت أيضاً إلى حظر الأمازيغية، من المدارس والإدارات. نشأت العربية مشوهة، في الأعوام الأولى، ويتذكر الجزائريون ماذا وقع نهاية الثمانينات، مع انتشار اللاقطات الهوائية، وظهور القنوات الأجنبية على التلفزيون، حيث صاروا يُتابعون المحطات الفرنسية، سخطاً على ضعف الميديا المحلية، وممارستها للرقابة، وكي يثبتوا فشل السلطة في التعريب، وأن الناس لم ينسوا لغة المستعمر القديم.
وأخطر ما وقع، في مسار ترسيخ فكرة أن العربية كانت مُحرمة زمن الاستعمار، هو نسف التراث الأدبي بالعربية قبل 1962. مثلاً، أول رواية جزائرية بالعربية، صدرت عام 1957 «الحريق» لنورالدين بوجدرة، لكنها محيت من الأذهان، لأن السلطة الناشئة عقب الاستقلال قررت تكذيب التاريخ. وقررت أن الشعب كان محروماً من لغته.
حين كانت المدرسة تلقن العربية، قبل الاستقلال، جعلت منها مادة لغوية، بعيداً عن الدين، بينما في جزائر ما بعد 1962، جرى ربط لا واع، بين العربية والإسلام، بل إن الخطابات السياسية ـ حينذاك ـ كانت تصر على ربط اللغة بالدين، فحوطوها بسوار عازل آخر. وصارت جماعات دينية تدعي حيازة العربية، كما لو أنها ملكية فردية، ما رسخ في عقول بعض الناس أن رفض الجماعات الدينية المتطرفة لا ينفصل عن رفض اللغة العربية. هكذا أدخلت السلطة، في الستينيات والسبعينيات، هذه اللغة في معضلة. لا هي خدمتها ولا هي سمحت لها بتطور طبيعي في الجزائر. بل ظلت عصا تُطارد بها خصومها، فقبل أن يُعلن هواري بومدين عن تأميم المحروقات في 1971، ما أثار أزمة مع الفرنسيين، كان قد أعلن أن ذلك العام سيكون عام التعريب. وجه سلاحه صوب الفرنسيين باللغة قبل الاقتصاد، حصل ذلك بينما الحزب الواحد، الذي يحكم البلاد، لم يكن يتكلم العربية، فلم يجر تعميم العربية في اللجنة المركزية لجبهة التحرير سوى عام 1980، مما يُبين أن السلطة نفسها لم تكن مُقتنعة بمسألة التعريب. ولا يزال الأمر يُراوح مكانه، كلما نشب خلاف مع فرنسا، وبدل دعم العربية، نسمع من يلوح بمنديل الإنكليزية، وأنهم سوف يستبدلون الفرنسية بالإنكليزية، بينما العربية في دكة الانتظار، فهي على الورق لغة وطنية، ولها مؤسساتها، لكنها مسلوبة من قيمها الجمالية، ومحصورة مثل كرة تتبادلها أرجل السياسة والدين.
كاتب جزائري