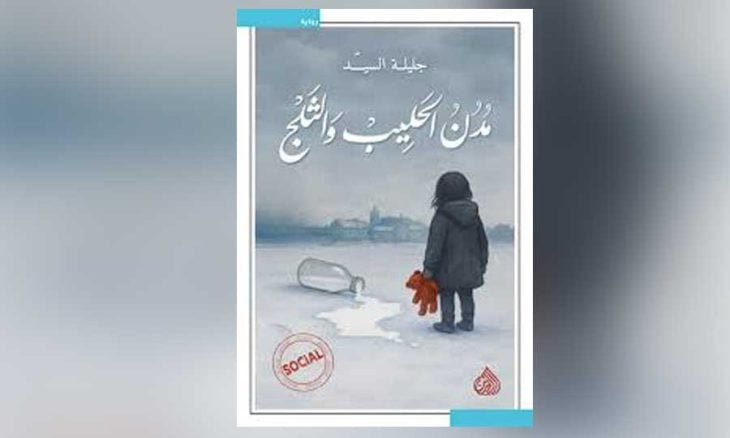الفتوة الخالد: نجيب محفوظ وجلال صاحب الجلالة

مروة صلاح متولي
في الحكاية السابعة من ملحمة «الحرافيش» نقرأ عن جلال صاحب الجلالة، أحد الفتوات من سلالة عاشور الناجي، أعاد جلال الفتونة إلى آل الناجي، بعد أن تسربت من بين أيديهم، واسترد كل ما فقدته السلالة من سلطة وجاه ومال، واستطاع أن يفعل ذلك كله في لحظة شجاعة وقوة قلب، عندما قرر أن يواجه الفتوة سمكة العلاج واثقاً في قدرته وأصله واستحقاقه للفتونة، فطرح سمكة العلاج أرضاً وانتزع منه الفتونة والمجد القديم، واستتب له الأمر وصار هو الفتوة وهتفت الحرافيش باسمه.
هذا الفتوة الفريد من نوعه سماه نجيب محفوظ (جلال صاحب الجلالة) وعلينا دائماً أن ننتبه للأسماء عند نجيب محفوظ واختياره لها وأن نتوقف أمام وقعها ودلالتها. هو جلال ابن عبد ربه الناجي، أو جلال ابن زهيرة كما ظل يُنادى لبضع سنوات من حياته، وفي مناداته بهذا الاسم منسوباً لأمه إهانة كبرى وتحقيرا شديدا ومعايرة بسيرة امرأة تابع الناس حكايتها المثيرة حتى لحظة النهاية ومقتلها الشنيع، تلقى جلال هذه الإهانة منذ أن كان طفلاً صغيراً وسمع الناس يقولون ابن زهيرة، لكن ذلك لم يغير من حبه لأمه الراحلة شيئاً، ظل عاشقاً لها وظلت نموذجاً مثالياً للمرأة في نظره، وكان على قناعة بكل ما كانت تفعله ويرى أنها كانت محقة وعلى صواب، فما كانت زهيرة سوى امرأة جميلة ذكية فاتنة، تدرك جيداً قيمة جمالها وما وُهبت من نعم ومواهب، وكانت امرأة طموحة تتطلع إلى الأفضل دائماً، لذا كانت تبحث بين الرجال عن الرجل الأقوى والأجمل والأغنى، ذلك الرجل المثالي الذي يستحق أن يفوز بها، وكان زواجها واقترانها برجل ما أو حتى إنجابها منه، لا يوقف عملية البحث ولا يمنعها من الاستمرار فيها، فإن وجدت رجلاً أفضل فلتطلق الزوج الحالي ولتتزوج من جديد ولتنجب أيضاً من كل رجل تتزوجه. وكان جلال من أنجبته زهيرة أثناء زواجها من عبد ربه الناجي، قبل أن تطلقه وتتزوج من محمد أنور، الذي كان مصرعها على يديه بعد أن طلقته وتزوجت من المعلم عزيز.
عقدة الموت ووهم الخلود
قدم لنا نجيب محفوظ شخصية جلال منذ طفولته، وجعلنا نتابع بالترتيب الزمني مراحل تكون هذه الشخصية العجيبة وتشابك عقدها ومخاوفها وهواجسها. رأى جلال بعينيه مقتل أمه زهيرة وهو طفل صغير، وشاهد ذلك الوجه الجميل يتهشم تحت عصا محمد أنور الغليظة، وتعرّف على الموت للمرة الأولى في حياته، تلك القوة الرهيبة، وذلك الشيء الغامض المؤكد الذي سلب منه أكثر من أحب في هذا العالم، وحرمه من أمه الجميلة، وكل ما يحتاج إليه من حنان وعطف ورعاية. هنا نشأت عند جلال مشكلة كبيرة مع الموت، ظل يعالج هذه المشكلة بصور مختلفة مع تغير فكره من مرحلة الطفولة إلى المراهقة والشباب واكتمال الرجولة. وعندما وقع جلال في الغرام تلقى ضربة أخرى قوية من القدر فاقمت من مشكلته مع الموت، تمثلت تلك الضربة القوية في موت خطيبته قمر بينما كانا يستعدان للزواج، موت مفاجئ سريع مبهم بعد ارتفاع حرارتها لسبب غير معروف، زاد حنق جلال على الموت، واشتعل غضبه وتمكن منه الخوف أيضاً، وأرقته حقيقة أن الموت سوف يزوره في يوم من الأيام عاجلاً أو آجلاً، وأخذ يبحث عن سبيل للخلود ويفتش عن طريقة للفرار من الموت، وكان يرى أن تحقيق الخلود عن طريق الإنجاب، وإكثار الذرية مجرد أكذوبة، ولم يقنع بهذا الوهم ولم يسمح له بأن يخدعه كما يخدع البسطاء، وقرر أنه لن يتبع تلك الحيلة البائسة من أجل التحايل على الفناء. كان جلال في ذلك الوقت قد أصبح الفتوة، وكان رافضاً الزواج بعد موت خطيبته قمر، لكنه اتخذ عشيقة بعد أن كان يرفض مصاحبة النساء بشكل عام، أو بالأحرى استطاعت زينات الغانية أخيراً أن توقعه في حبائلها وأن تحظى بعلاقة مع الفتوة.
ظل جلال يبحث عن حل لمشكلة الموت وعن طريقة للخلود، وكان يفكر ويفكر ويحاول أن يفك هذا اللغز الرهيب، ويسير ليلاً بجوار التكية، وينصت إلى أناشيد الدراويش الغامضة، ويظن أنهم خالدون لا يعرفون الموت، لكن من أين له بالسر؟ ذهب جلال إلى شيخ أو دجال يدعي أنه يمتلك السر، وأخبره أن الأمر لا يتم إلا بمؤاخاة الجن والالتحام بهم، ويتطلب ذلك تحقيق بعض الشروط وتنفيذ بعض الأوامر، وافق جلال بالطبع على عقد تلك الصفقة مع الجن، التي يشبهها البعض بصفقة فاوست مع الشيطان. شرع جلال في تنفيذ ما طُلب منه، فشيّد تلك المئذنة الغريبة الشاهقة للغاية التي لا مسجد لها كما يصفها نجيب محفوظ قائلاً: «قاعدة مربعة في مساحة بهو ذات باب خشبي مقوس مصقول، ويواصل جسمها المتين ارتفاعه، لا ترى له قمة، لا يعلوه بناء، ويعلو أضعافاً فوق كل شيء، توحي أضلاعه بالقوة ولونه الأحمر بالغرابة والرعب». وكانت المئذنة مثار تعجب الناس ودهشتهم وتساؤلهم «يتساءل أحدهم: لو سلّمنا بأنها مئذنة فأين الجامع؟» «وتابع الناس بذهول بناء المئذنة الغريبة وتواصل ارتفاعها إلى ما لا نهاية، من أصل ثابت في الأرض بلا جامع أو زاوية، لا يُعرف لها هدف أو وظيفة، حتى الذي يقوم بتشييدها لا يعرف عنها شيئاً، وتساءل قوم هل مسّه جنون؟ أما الحرافيش فقد قالوا إنها اللعنة حلّت به جزاء خيانته لعهد جده العظيم، وتجاهله لرجاله الحقيقيين وجشعه الذي لا يقنع بشيء» لكن الحرافيش كانوا مغلوبين على أمرهم، لا يملكون إلا مطالعة ذلك المسخ أو ذلك البناء المشوّه القبيح الذي فُرض عليهم فرضاً في صمت مطبق، حتى المقاول الذي عمل على بناء المئذنة لم يكن مقتنعاً، لكن كانت لديه أسبابه كما يذكر نجيب محفوظ: «اتفق مع مقاول على تشييد المئذنة في إحدى الخرابات، وقد امتثل الرجل لما يُطلب منه طمعاً في المال وخوفاً من البطش». ثم اعتزل جلال الناس اعتزالاً كاملاً واختفى عن الأنظار قابعاً في غرفته لمدة عام كامل، كما طُلب منه أيضاً، وأوكل أمور الفتونة إلى مساعديه غير مكترث بشؤون الحارة والحرافيش، وفي اليوم الأخير من عام العزلة ظن جلال أنه التحم بالجن وحظي بالخلود، وبات موقناً بأن الموت لن يستطيع الاقتراب منه بعد الآن، ولن يتمكن الزمن من ترك آثاره على جسده القوي ووجهه الجميل، فأخذ يسرف في ملذات الحياة بنهم شديد، «انتصر على الزمن بعد صموده أمامه وجهاً لوجه بلا رفيق، لا خوف منه بعد اليوم، فليهدد غيره بجريانه المنحوس، لن يبتلى بالتجاعيد ولا بالشيب ولا بالوهن، لن تخونه الروح، لن يحمله نعش، لن يضمه قبر، لن يتحلل هذا الجسد الصلب، لن يتحول إلى تراب، لن يذوق حسرة الوداع، تجوّل عارياً في الحجرة وهو يقول بطمأنينة: مباركة هذه الحياة الأبدية».
صوّر نجيب محفوظ شخصية جلال من جوانب متعددة، وكفتوة يمتلك السلطة على الحرافيش رسمه محفوظ كشخص يحتقر الناس أشد الاحتقار، لا يشعر بمعاناتهم ولا يعترف بها في الأساس، ويهزأ من احتياجاتهم الضرورية التي لا حياة دونها كالطعام والشراب. ويرى أن الناس مجرد مخلوقات ضعيفة بلا فكر أو رأي أو كرامة، كمن كان يرى أن الشعب بلا كرامة أيضاً وأنه هو من أتى ليعلمهم إياها، لكنه علمهم الفقر وطالبهم بالتقليل من الأكل والشرب. وأضاف إليه محفوظ صفات الطمع والجشع وعدم الاكتفاء، «بدا أول ما بدا أنه وقع أسيراً لعشق المال والتملك، لا يشبع من ناحيته، غدا أكبر تاجر وأغنى غني، وفي الوقت نفسه لم يتهاون في جمع الإتاوات وتقبل الهدايا، ولم ينعم بخيره إلا رجال عصابته حتى عبدوه عبادة، وشيّد عمارات كثيرة، كما شيّد إلى يمين السبيل داراً خيالية، سميت بحق بالقلعة لجلالها وكبرها، وفرشها بفاخر الأثاث، وحلاها بالتحف كأنها حلم الخالدين، ورفل في الثياب الغالية، وتنقل بالدوكار والكارتة، وتوهج بالذهب في أسنانه وأصابعه» وهو من توهم فيه الناس أنه ما أتى إلا ليقيم العدل الاجتماعي والمساواة بين الفقراء والأغنياء، وقالوا عندما أصبح الفتوة «فليسعد الحرافيش، ليسعد كل محب للعدل، سيتوفر الرزق لكل مسكين، سيعرف الوجهاء أن الله حق». لكن ما حدث بعد ذلك كان العكس تماماً مضافاً إليه الكثير من الاحتقار والازدراء كما يصور نجيب محفوظ في حوار بين جلال وأبيه: «وسأله أبوه ذات صباح الناس يتساءلون متى يتحقق العدل؟ فابتسم جلال بامتعاض وتمتم متسائلاً ما أهمية ذلك؟ فقال عبد ربه بدهشة إنه كل شيء يا بني، فقال جلال بازدراء إنهم يموتون كل يوم ومع ذلك هم راضون، فقال عبد ربه الموت علينا حق أما الفقر والذل فبيدك محقهما، فصاح جلال اللعنة على الغباء».
أنهى نجيب محفوظ حكاية جلال صاحب الجلالة بالموت، لكنه لم يكن موتاً عادياً، بل كان موتاً مهيناً إلى أقصى حد وخاتمة بشعة اختارها له صاحب الرواية، فلم يكتف محفوظ بهزيمة جلال أمام الموت بينما هو غارق في وهم الخلود، وجعل ذلك الموت تحقيراً أبدياً للفتوة الخالد حيث يموت في مكان خاص بالبهائم والحيوانات، عارياً تماماً ملطخاً بالروث والعلف حين كان يحاول أن يروي عطشه الشديد ويطفئ النار المشتعلة في داخله بالشرب من حوض مياه تشرب منه الحيوانات. مات جلال بالسم على يد عشيقته زينات عندما شعرت ببوادر تخليه عنها، وعندما أخبرته وهي تراه يموت أمامها أنها هي من وضعت له السم، لم يصدق أنه يموت وقال لها «الموت مات يا جاهلة» على الرغم من شعوره بمفعول السم الذي يسري في جسده والألم الرهيب في أحشائه. تحت تأثير حالة من الهياج العصبي الشديد نزع جلال ملابسه وهرع إلى الشارع عارياً، حيث كان مشهد الموت الذي صوره نجيب محفوظ ببراعة قائلاً: «انحنى فوق حافة الحوض، لامست شفتاه الماء المشبع بالعلف، شرب بنهم، شرب بجنون، صرخ صرخة مدوية ممزقة بوحشية الألم، غاص نصفه الأعلى في الماء العكر، تقوض نصفه الأسفل فوق أرض مغطاة بالروث».
كاتبة مصرية