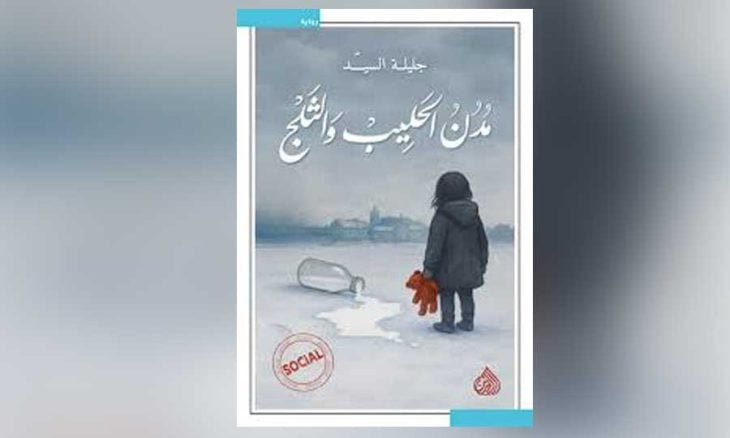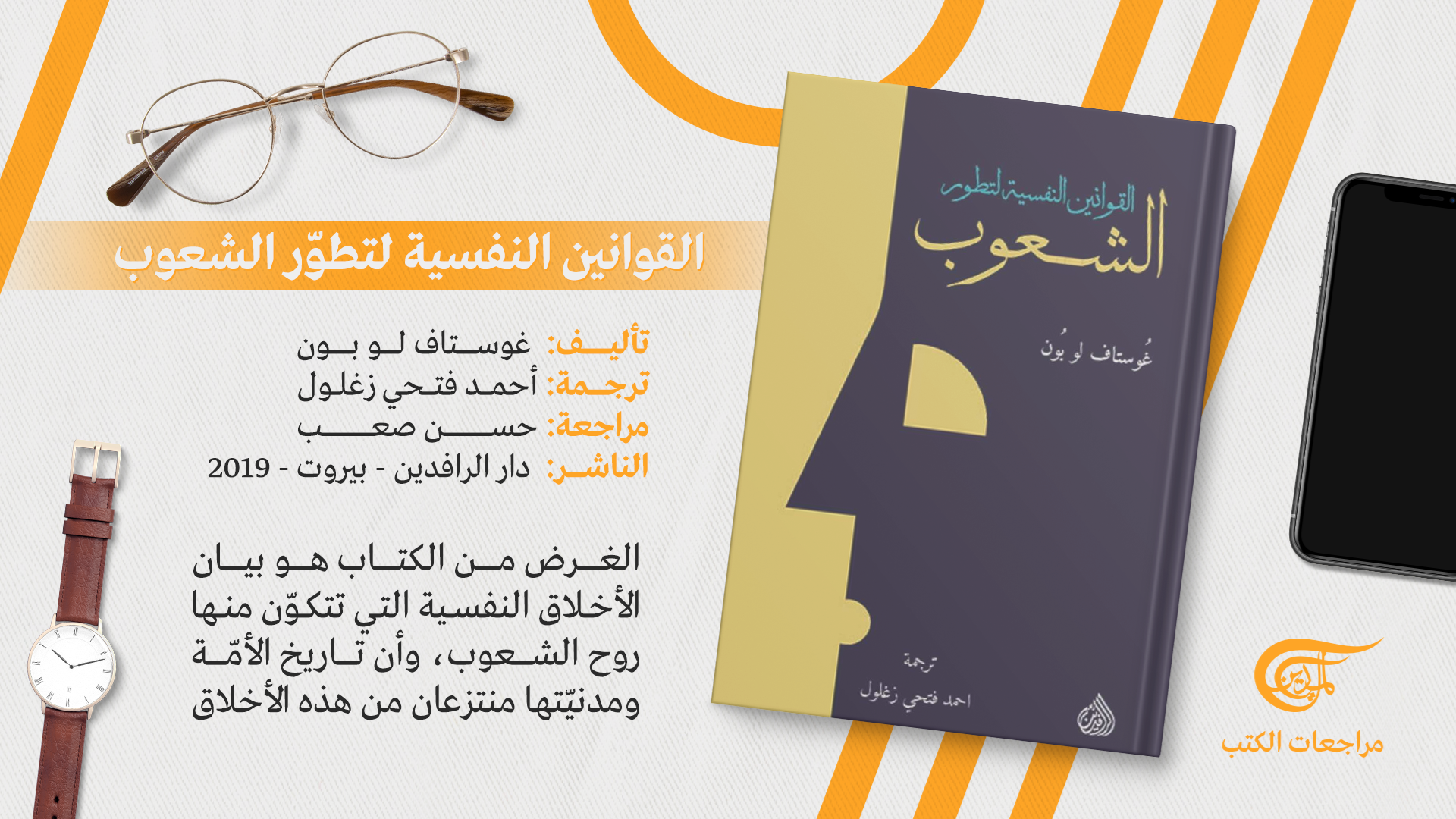الشاعرة المغربية فاطمة الميموني: كثافة التجربة هي ما يمنح القدرة على النفاذ إلى غياهب الروح

الشاعرة المغربية فاطمة الميموني: كثافة التجربة هي ما يمنح القدرة على النفاذ إلى غياهب الروح
عبد اللطيف الوراري
فاطمة الميموني شاعرة مغربية مُقلة، إذا كتبتْ لا تُريك إلا الأقل من المعنى الذي تقصده إليه وتتحجج به؛ فهي تُعول على خبرة القارئ وتأويله لخفاء اللغة التي تكتب بها بتقتير شديد. الشعر عندها مجاهدة مع اللغة قبل العالم في حد ذاته. في ديوانيها السابقين «لو» 2011، و»سبحة» 2015، لا نخطئ الأسلوب الصوفي الذي ينشئ تجربة اللغة ويطبعها بطابعه التصويري الخاص، ولا نخطئ بناءه الكثيف الذي يستخلص معاناة الذات في عالم يتلاطم بالأهوال؛ وهذا في حد ذاته يعكس صورةَ لغةٍ مُتخففةٍ وزاهدةٍ في بهرج المظاهر، ما يجعل التعرف على الشعر الذي تقترحه موطنا من مواطن الفرح بالجمال واكتشافه من منابعه الصغيرة والمتناثرة، بلا ادعاء أو أوهام.
عبر شعرها الذي يستضيء بشذراته الكثيفة، تنزع الشاعرة إلى تشييد شعرية عرفانية، تتقوم بكثافة التجربة، وتتخذ من التقاطبية المكانية (أرض/ سماء) في عُرام عناصرها وعناصرها الطبيعية وما يثوي وراءها من صور التحول والتلاشي التي لا حصر لها، ذريعة تعتصر فهم الذات للعالم وقدرتها على الانفعال به، وتسعى إلى تجاوز أعيانه ومشاهداته المبتذلة بالحكمة التي تقتطفها على حد الطريق وابتلاءاته. كما تتخذ من حيرة الذات ذريعة إضافية إلى اكتشاف معاني العشق والصحبة والسكر، داخل صورها الجوهرية. وخلال هذا السفر الذي يتم في اللغة كتجل نفساني- تخييلي، تسكر الحروف بدورها على نحو يمنح المعنى الناشئ باستمرار شهوة اكتشاف ما فيه تكون الذات بين وبين؛ بين قول وآخر، وبين سفر وآخر. هكذا تجعل الذات الشاعرة المنتشية بسكرها ولغتها، ومن شهوة الحبر الذي تكتب به، طريقا للمحبة ورهانا للمعرفة والتخطي في آن واحد، على نحوٍ يعنينا ويخاطبنا في الصميم، فيما هو ينحدر بنا عبر ملفوظاته الكثيفة إلى عصور سحيقة من الصمت والنسيان.
□ أسألك ابتداء: ما الذي قادك إلى الأدب؟ متى سمعت بكلمة الشعر لأول مرة، وفي أي عمر وجدت نفسك تكتبينه وتقتفين معناه؟
■ أذكر أني، في مرحلة الدراسة الإعدادية، كنت شديدة التعلق ببعض الكتابات السردية لكتاب من أمثال جرجي زيدان، ولطفي المنفلوطي، وجبران خليل جبران وإحسان عبد القدوس. وكنت أداوم على قراءة مجلة «العربي» وبعض المجلات ذات التوجه الديني، التي كان يقتنيها بانتظام والدي رحمه الله. كما كنت كثيرة التردد على المكتبة العامة للمدينة، التي هيأت فرصا ثمينة للمطالعة من خلال ما كانت تزخر به من كتب متنوعة، خصوصا دواوين الشعر القديم. وكان أول ما قرأته في هذ الباب «المعلقات السبع» التي كنت أجد صعوبة في فهمها، ولكنني كنت أستمتع بموسيقاها استمتاعا شيقا.
في هذه المرحلة، كنت أخط بعض المذكرات اليومية، أو بعض السرديات التي لا تحتكم إلى القواعد العلمية للكتابة، ولكنها في الواقع أسهمت بشكل كبير في توطين سؤال الكتابة، وجعله مصدرا للفخر والإعجاب بالذات، وإن كان ذلك يتم في صمت. وخلال الدراسة الثانوية كنا ندرس نصوصا شعرية مختلفة لشعراء القصيدة التفعيلية، على يد أساتذة كانت لهم القدرة الفائقة على تحويل نبض القصيدة إلى خفق يسكن قلوب بعضنا، أذكر أستاذ اللغة العربية محمد الغرناجي، رحمه الله، والشاعر المهدي أخريف. كما تعرفت، في هذه المرحلة، على الملاحق الثقافية والصفحات المخصصة لإبداعات الشباب التي كانت تصدرها الصحف الوطنية بانتظام، وكانت فرصة سانحة لقراءة نصوص شعرية تختلف عما كنا ندرسه في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وفي سنة 1986، نشرت نصوصي الأولى في صفحة (حوار) لجريدة «العلم»، التي يرجع إليها الفضل في التعريف بالكثير من الأسماء التي كانت تجايلني أو تكبرني بقليل، مثل: الزهرة المنصوري، والعربي مومن، وعبد الملك العليوي، ومحمد الصالحي، وأحمد هاشم الريسوني، ومراد القادري، وابتسام أشروي، وأمل الأخضر وإيمان الخطابي.
لم يكن فعل الكتابة صادرا عن وعي جمالي بقضايا الشعر، إلا ما درسناه في المرحلة الثانوية من مفاهيم لا ترقى إلى توجيه الشاعر، وقد تميزت هذه المرحلة بتعاطٍ نهِمٍ لقراءة الشعر، على الرغم من ندرة الدواوين التي كنت أستعيرها من بعض أساتذتي، وحتى أتمكن من قراءتها بين الفينة والأخرى كنت أقوم بنسخها: دواوين لبدر شاكر السياب، وعبد المعطي حجازي، وعبد الوهاب البياتي، وأمل دنقل، وبعض الشعراء المغاربة وأخص بالذكر محمد الصباغ. كانت كتاباتي الشعرية، في هذه الفترة، تعرف تدفقا كبيرا، ولكنها لم تكن نابعة من رؤيا إبداعية واضحة. أعتقد أن ذلك يرجع إلى المرحلة العمرية التي تتميز بالحماس والتطلع إلى إثبات الذات.
□ تنتمي فاطمة الميموني إلى جيل التسعينيات في الشعر المغربي، الذي شهد حضور الصوت النسائي بقوة. ما هي أسباب هذا الحضور وفاعليته في تجديد أساليب هذا الشعر؟
■ في مرحلة التسعينيات برزت أسماء شعرية نسائية بقوة، مقارنة بما عرفته خريطة الشعر النسائي المغربي قبل تلك الفترة، حيث لم يصدر سوى ثلاثة دواوين في سبعينيات القرن الماضي حسب بيبلوغرافيا الشعر المغربي المعاصر (1923/2016) التي أعدها محمد قاسمي: «أصداء من الألم» لفاطمة الزهراء بن عدو الإدريسي سنة 1975، و»زهور شائكة» للزهراء الناصري 1977، و»دعوني أقول» لسعاد فتاح 1979. ومع بداية الثمانينيات عرفت حركة نشر القصائد والدواوين الشعرية النسائية انتعاشا ملحوظا؛ حيث صدرت ثمانية دواوين، إلا أن التسعينيات ستمثل نقطة تحول كمي في عدد الإصدارات، حيث بلغ عدد الدواوين سبعة وثلاثين (37) ديوانا. ولم يكن تحولا على مستوى الكم فقط، بل كان، أيضا، على مستوى الأساليب والأدوات الشعرية، التي تطرح أفقا جماليا يساهم في التأسيس لقصيدة النثر مع اختلاف كبير في الرؤى والمرجعيات والاختيارات الجمالية. وقد أغنى ذلك المنجز الشعري المغربي، وهيأت الظروف لظهور حساسية شعرية جديدة عانت من انعدام مواكبة نقدية موجهة ومؤطرة، ولكنها أثبتت حضورها من خلال ما صدر من دواوين، وما نشر في المجلات والصحف الوطنية. وقد يرتبط ذلك بما عرفه السياق الاجتماعي من تحولات مهمة، أصبحت معها المرأة المغربية، في تلك الفترة، ترتاد الجامعات بكثافة، وتشارك في العمل السياسي والمدني، ما رفع من مستوى وعيها، وجعلها قادرة على التحول من مجرد موضوع شعري إلى مشارك فعال في ترتيب أولويات الحياة العامة، حيث ولجت مجال السياسة، والصحافة، وتدبير المؤسسات الحية في المجتمع.
□تعرفَ عليك القارئ شاعرة مُقلة بلبوس عرفاني. بمن تأثرتِ حتى استقللتِ بأسلوبك الشعري الذي يمزج بين اقتصاد اللغة والانفتاح على التجربة الصوفية؟
■ أنا مقلة في النشر، ويلزمني في هذا المقام أن أذكر ما قام به الشاعر الراحل محمد الميموني والشاعر محمد بشكار من جهد كبير من أجل إقناعي لإصدار مجموعتي الشعرية الأولى الموسومة بـ»لو»، التي شرفني الشاعر عبد الكريم الطبال بتقديمها. أعتبر أن هذه المجموعة تمثل مرحلة ثانية، لأن هناك تحولا كبيرا على مستوى اللغة الشعرية وبناء النص. ثم صدرت مجموعتي الثانية «سبحة»، وهي قصيدة طويلة فزت بها، مناصفة مع الشاعرة وداد بنموسى، بجائزة القصيدة العربية التي كان يرعاها محترف الكتابة في فاس. فحين يعود القارئ إلى نصوص التسعينيات المنشورة في بعض المنابر الشعرية الوطنية والعربية، يكتشف أنها كانت تتميز بتوظيف رمزية لغوية وتصوير متشذر، ثم أتت مرحلة التوظيف الإشاري للغة، وقد نتج ذلك عن معاشرتي الطويلة للكتابات الصوفية، نثرا وشعرا في مرحلة إعداد الدكتوراه لمدة غير قصيرة، فأصبحت في هذه المرحلة مُداوِمة على قراءة كتابات ابن عربي وابن الفارض والحلاج والسهروردي، وأشعار عبد الكريم الطبال ومحمد السرغيني ومحمد بنيس وأمينة المريني ومحمد الشيخي ومليكة العاصمي، التي كانت تُنشر في الملاحق الثقافية للجرائد الوطنية.
وأعتقد أن هناك إجماعا حول حضور بعض سمات الكتابة الشعرية الصوفية في الديوانين، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون داعيا لتصنيف ما أكتبه في باب الشعر الصوفي؛ لأن هذا الأخير يعبّر عن تجربة شعرية مرتبطة بتجربة عرفانية يسلكها العارف، ومع ذلك كان ناتجا عن قراءتي لكتابات صوفية شعرا ونثرا، ولبعض الشعراء المغاربة والعرب، الذين تأثروا بالمنحى الصوفي في قصائدهم. ولا يمكنني أن أذكر أسماء شعراء محددين تأثرت بهم تأثرا مباشرا، أو اقتفيت نهجهم أو حاولت تقليدهم، إلا أنني كنت أحب، بشكل كبير، كتابات محمد الصباغ الشعرية، وحتى النثرية التي لا تخلو من شاعرية خاصة.
□ إلى أي حد تفيدك تجربة التعبير الصوفي في تشييد عالم بديل تحلمين به؟ وفي المقابل، ألا ترين أن كثافة التجربة لا تُطلق إمكان البوح والإفضاء بذات الأنثى ومشاغلها الصغيرة؟
■ في الحقيقة، لا أعتقد أن التعبير الصوفي يفيد في تشييد عالم بديل نحلم به، بل هو سبيل لاختراق العالم الواقعي والتفاعل معه، فالإشارة بالمفهوم الصوفي تطرح أسئلة تتعلق بإثراء للغة، ومن ثم للمعنى؛ المعنى الذي لا يقف عند ما نراه بالعين، أو ما نلمسه، بقدر ما يصبح المعنى، وتصبح اللغة نفسها، كائنا متصديا مع الواقع، كائنا يرهب الآخرين ويمتعهم في الوقت ذاته، ولا شك في أن الجميع يعرفون مأساة أصحاب الإشارة، ممن قتلوا أو صلبوا أو عذبوا.. وما ذلك إلا بسبب تمرد اللغة وتحميلها أبعادا إشارية ثورية إن صح التعبير. فالتعبير الصوفي لا يشيد عالما نحلم به، بل هو يكشف أسرار العالم الذي نعيش فيه، أسرار الجمال والقبح، والموت والحياة، والمحبة والضغينة، ولا أعتقد أنني أُصنف ضمن الشعراء الذين خاضوا التجربة وارتقوا في مدارك العرفان، بل أظن أن ما أكتبه يستقي بعضا من سمات هذه الكتابة، خصوصا تلك المرتبطة بالجانب اللغوي في بعده الإشاري، أو بالجانب الدلالي الذي يرتقي بالصورة الشعرية وبضفاف المجاز إلى بحار المعنى المشرع على حدائق الحياة والذات بكل ما تعرفه من قلق وجودي. ضمن كثافة التجربة التي تمنح الشاعر/ الشاعرة على السواء قدرة على النفاذ إلى غياهب الروح الإنسانية، بحثا عما يمكن أن يسكن عمقها من نور مهما كان ضئيلا، لأنه هو وحده القادر على جذبها من عالمها السفلي إلى عالم الجمال، الذي لا تسكنه الأنثى وحدها، مثلما لا يسكنه الذكر وحده. أقول كثافة التجربة، ولا أقصد التجربة الصوفية، لأن هذه الأخيرة مشتقة من التصوف كسلوك يسلكه الصوفي في حياته، بكل ما يعيشه من مكابدات ترقيه من مقام إلى مقام، الأمر الذي لا ينطبق على الشعراء المحدثين.
أما البوح والإفضاء بذات الأنثى ومشاغلها الصغيرة، فلا أعتقد أنه يمثل هم الشاعرة إلا في جانب منها، حيث يجب أن تكون الكتابة الشعرية ذات بعد كوني إنساني، حتى إن كانت الصورة المعبر عنها تصويرا لذرةٍ من الألم الذاتي المستكين في روح الشاعرة. وحديث الأنثى عن التفاصيل الصغيرة، كما ورد في السؤال، يظل، دائما، مدعاة للتماهي مع عالم الآخر، تماهيا ينتهي إلى التوحد في التعبير عن الإنسان، وقد تصبح التفاصيل الصغيرة، حينما نكشف عنها، قادرة على تغيير مجرى سفينة الحياة.
□ هل لك طقوس وحالات مخصوصة في كتابة القصيدة؟ وهل تعودين إليها من أجل تنقيحها وإعادة كتابتها؟
■ ليست لي طقوس ولا حالات مخصصة في الكتابة، فكتابة الشعر واردٌ يرد متى حنت الروح إلى الصفاء والتصافي، أما التنقيح وإعادة الكتابة فمسألة ضرورية متى عولْتُ على النشر، ونادرا ما أنشر. لذلك تجدني، أحيانا، أكتب بعض الشذرات وبعض النصوص التي أخطها دونما عناية في قصاصات، أو جذاذت العمل، أو حتى على ورق المطبخ، وقد أعود إليها وأدونها في ملفات بالحاسوب، وقد تضيع وما أكثر ما تلف منها.