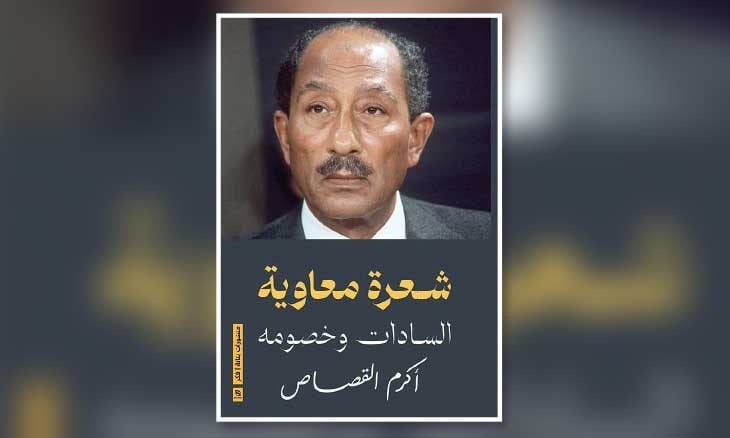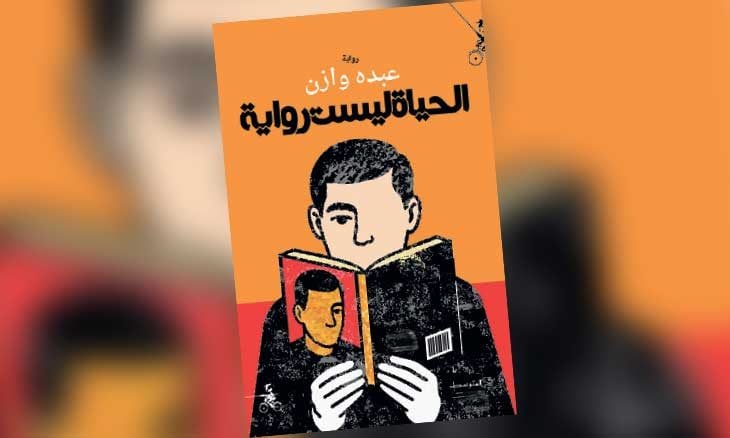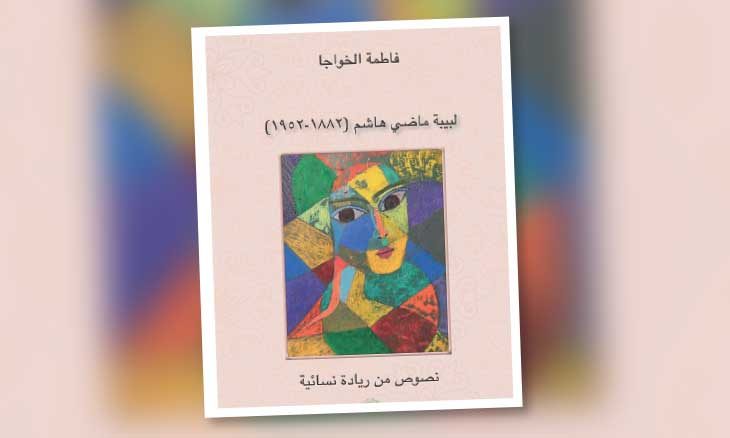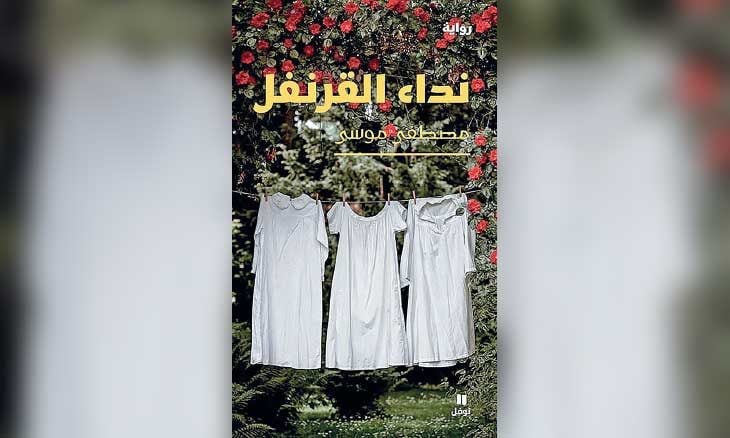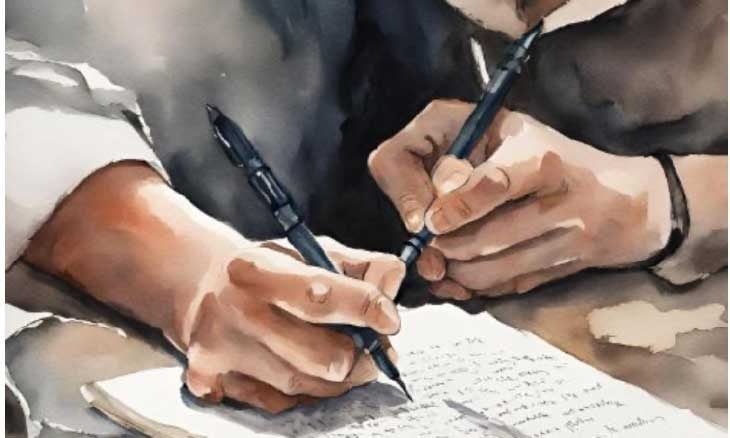
في تلقّي الكتابات الذاتية: كيف يعيد النص تشكيل الأنا؟

عبداللطيف الوراري
لم يكن تاريخا عاديا ووحيد المسلك؛ ذلك الذي عبرته السيرة الذاتية وهي تتملّك الطرائق التي وردت عليها من الأنواع الأدبية الأخرى، وتهضمها مع الوقت غير عابئة بأصحاب «الأيديولوجيا المضادة». وعبر هذه السيرورة استطاع هذا النوع أن يغتني ويراكم معرفة خاصة به، وبكلّ كتابةٍ تتوجه نحو الذات ونحو استعمال ضمير المتكلم. وطوال العقود الأربعة الأخيرة، يمكن أن نتحدث عن «انفجار» الكتابة السيرذاتية، وكتابات الذات بوجه عام، ليس لأنها تحررت من ربقة النظرية التقليدية وحسب، بل لأنها صارت تقدم نفسها بوصفها الوسيلة المثلى للإجابة عن «أزمة الذات» المعاصرة من جهة، ومن أجل تحليل الصعوبات التي تواجه الذات للتعبير عن نفسها داخل اللغة من جهة أخرى. ومن نموذج عن الذات إلى آخر داخل أشكال الكتابة الذاتية، يبرز «الانهمام بالذات» والنظر إلى «الذات بوصفها تخييلا»، ولكن ما يبقى في نهاية التحليل، سوى تخييلات الذات القائمة على التاريخ الشخصي بوصفها وسيلة «لإدراك العالم». يمكن أن يترتب على ما سبق مشكلات نوعية تخصُّ بناء الكتابة وطابعها التداولي.
حدود أبستيمولوجية
عندما كان فيليب لوجون مُنْكبّا على صوغ ميثاقه السيرذاتي، مَيَّز بين السيرة الذاتية وباقي الأنواع القريبة من الكتابة الذاتية، مثل: المذكرات، والسيرة، والرواية الشخصية، واليوميات والبورتريه. ووجد أن الاختلاف بينها يُفسِّر نفسه بالحاجة إلى ميثاق، سيرذاتي ومرجعي في آن، يتولى مُهمّة الفصل بين «ذات التلفُّظ وذات الملفوظ بضمير المتكلم». فخلافا للسيرة، تسمح السيرة الذاتية لمؤلِّفها ليس بتمثيل الأحداث المهمة والعامة، التي عَيّنت وجوده في الغالب فحسب، بل كذلك الأفكار والمشاعر التي صاحبت هذه الأحداث. معظم السير الذاتية تثيرها الرغبة في تبديد سوء الفهم وإعادة تشييد الحقيقة التي مثّلتْها بكيفية غير مكتملة وشائهة، مثلما تثيرها الرغبة في تبرير بعض الوقائع والمواقف. وبالقياس إلى الرواية التي تعتمد ميثاقا تخييليّا، تخلق السيرة الذاتية انطباعا لدى القارئ بأنّها تتعهد بقول الحقيقة، وبأن ما يتلقّاه مُطابِقٌ للواقع، ولكنها تعمل على التدليس التلفُّظي، على التناوب الحُرّ للغاية بين أزمنة القصة وأزمنة الخطاب، تبعا للجدلية التي تختصُّ بها: لا يكتفي السارد بمجرد سرد أحداث حياته الماضية، لكنَّهُ يلقي عليها نظرة نقدية؛ أي يحكم عليها ويُسوِّغها في ضوء معرفته الراهنة.
وتنهج المذكّرات مثل السيرة الذاتية نظام الحكي الاسترجاعي، الذي يخصّ حياة المؤلف، بيد أنها تولي الأهمية للأحداث التاريخية، فتكون إما إخبارا عما شاهده الشخص وسمع به، أو إخبارا عما حدث وقال به، أكثر من كونها إخبارا عن الأحوال التي كان عليها، كما في السيرة الذاتية، لكن من الصعب، أثناء ممارسة الكتابة، أن يُفصل بينهما إلا في ضوء «المشروع الرئيس للمؤلِّف».
وفي ما يتعلق باليوميات، يتمّ تقليص الانزياح بين الخطاب وما يكون مسرودا إلى حدّ أدنى: فما يكتبه صاحب اليوميات في نهار يومه هو ما يحمله على تقطيع خطابه، وكلّ ما يدخله يُؤسِّس نَوْعا من الوحدة. وهكذا ليس بإمكان كاتب اليوميات، وهو المرسل إليه كذلك، أن يسيطر على الزمن بالطريقة نفسها التي يسيطر بها كاتب السيرة الذاتية. لكن قد تكون اليوميات استرجاعيّة إذا كان لها القدرة على التفكير في نفسها، فتأتي في الغالب لترسم نَوْعا من البورتريه، أو الرسم الذاتي.
تبقى الحدود بين السيرة الذاتية وجاراتها مع ذلك غائمة وعصيّة على التحديد، إذا علمنا بأن مفهوم النوع أمسى أقلَّ ملاءمة مما كان عليه في السابق. لن يعرض التصنيف الأجناسي الذي يمنحه المؤلف أو الناشر للنصّ إلا حَـلّا جُزئيّا، وأمام القارئ إمكان تأويلي أكبر في تلقِّيهِ لهذا النص أو ذاك من الكتابات الذاتية. من هنا، فإنّ مسألة تلقي هذه الأخيرة تغدو إشكاليّة، لأنها لم تعد ترتبط بالميثاق أو بـ«تعاقد القراءة» القائم بين المؤلف والقارئ. إنّ الإشكالية المعاصرة لتلقّي النص السيرذاتي من قبل القارئ، قد أملت على فيليب لوجون، ولاسيما بعد صدور «ابن» سيرج دوبروفسكي، أن يخفف من طابع ميثاقه الدوغمائي، ويقول بـ«سذاجة» من يعتقد بشفافية اللغة وبإمكانيَّتها للإحالة على الذات المتشبِّعة التي توجد خارج النص، أو لقول الحقيقة عن مثل هذا الذات، أو من يعتقد بأنّ استعمال ضمير المتكلم يدلُّ على كائن مستقل ومفرد، مستشهدا بعبارة رولان بارت: «في مجال الذات ليس ثمّة من مرجع».
كما سارع نُقّاد الأدب بدورهم إلى الاعتراض على هذا الميثاق الذي يرفض مرونة النوع السيـرذاتي، ويضطرّ القارئ إلى أن يسجن نفسه داخل سنن القراءة وآفاق التلقي. فإذا كان يقوم على علاقات القارئ مع النصوص، من أجل ضبط اشتغالها وفهمها، إلّا أن لا أحد يجبرنا أن نقيم عقد القراءة على اتفاق صريح مثلما كان يقترحه فيليب لوجون؛ بل إن هذا العقد ينبغي أن يشتغل أو يعمل ضمنيّا داخل النص. والأرجح أنّه يمكن تحديده باعتباره وظيفة جوهرية للنص، وليس باعتباره فقط وظيفة تعمل على ضوء النص الموازي (صفحة العنوان) أو المعطيات المرجعية للنص فقط. فادّعاء الوحدة يطرح مشكلة لدى القارئ، وهو ما يحمل على إعادة تأليف مختلق لـ(ذات) تغامر باقتراح (ذات) مُتخيّلة، بشكل يؤدي إلى خرق النموذج القاعدي ليصير أكثر مرونة، وقادرا على استيعاب نصوص التخييل والوثائقي المعيش ومحكي الحياة، وشهادة الناس الذين لا يكتبون. سيكون الرهان المتعلق بتوسيع أشكال تزمين الذات والكتابة عنها، موقوفا على الانخراط في المحسوس، وإعادة بناء الهويّة التي لن تعود نموذجا قارّا، بل هي في سيرورة أو تطوُّرٍ مُستمرّ. ويستجيب مثل هذا الشرط لأهداف مؤلِّفي هذا المتن المتراحب من الكتابات الذاتية، ولرغائبهم التي تسعى نحو إعادة بناء الـ(أنا) الاجتماعي في تناغم مع الـ(أنا) الداخلي. ومن هذا المنظور، يكون بوسعهم أن يعاودوا النظر إلى الماضي من أجل تحديد الأسباب والآثار المترتبة عليه في حاضرهم، بقدر ما يهمُّهم إعادة كتابة التاريخ الرسمي في سياق كتاباتهم الذاتية. حتى داخل الكتابة التاريخية التي ارتبطت بالأرشيف الرسمي وظلّتْ تخضع للموضوعية العلمية تبعا للعلم الوضعي كما وضعه أوغست كونت، برز وعي جديد بالكتابة البيوغرافية التي أخذت تهتم بسير الناس العاديين، وانزاحت إلى قدر من الخيال لإعادة تمثيل أحداث الماضي، بما في ذلك «التاريخ الجديد» الذي دعا إليه جاك لوغوف، أو ضمن ما يسميه بيير بورديو بـ«الوهم السيري»، الذي يُترجم عن نفسه داخل المعرفة السوسيولوجية، أو يدعو إليه هايدن وايت في أطروحته التي شَكّكت في «حقيقة» ما يمكن أن يعكسه السرد التاريخي في ضوء صنعة التاريخ، الذي ليس أقلّ من الرواية من حيث شكلها التخييلي. فلئن كان التاريخ والسيرة الذاتية يطالبان بالأصالة والصدق، أو الرغبة في أن يكون كلٌّ واحد منهما موضوعيّا بالقياس إلى الماضي، غير أنّه يجب ألا ننسى أنّ المؤرخين وكُتّاب السير الذاتية لم يكونوا محايدين، فمعظمهم يسرد التاريخ ويستخدم التقنية السردية في كتاباته، ويتمثَّل الواقع والماضي عبر وسيط الكلمات، أي اللغة التي هي في الأصل نسق «قابل للانهيار».
وسّعوا الذات
باتت أشكال الكتابة الذاتية تسائل الأدب المعاصر ونظريته، فيما هي تنفتح على مجالات شتى من العلوم الإنسانية، مثل الفلسفة، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، والتداوليات، وعلم النص، والتحليل النفسي وغيرها. وقد تزايدت مثل هذه الأشكال التي تنحرف عن النموذج القاعدي السيرذاتي، بحيث لا يتردّد المؤلف في أن يقترض من أجناس الخطاب الأخرى الشكلَ الأدبيَّ الذي يتطلّبه الأنا السيرذاتي ويناسب أفقه الكتابي ومصادره وموادّ بنائه، بل يزيحه عن الواقعي لصالح المتخيّل وضروبٍ من الاستيهام. وهذا اللاتحديد متأصل في الميثاق السيرذاتي نفسه، لأن المؤلف لا يمكنه أن يقول كل الحقيقة عن نفسه بكيفية واعية. ذلك ما حمل النقاد على اقتراح تعيينات جديدة لتمييزها عن شكل السيرة الذاتية، التي جرت عليها سنن التقليد الأدبي، وضمن وسائط وعلائق جديدة لم تعد تراهن على التمثيل الذي يقوم على مبدأ تكافؤ الدليل والواقع، بل أخذت تخرق مبدأ التطابق/ التشابه بين الكتابة والواقع وتسعف على التداخل بين العالمين الواقعي والتخييلي. ومن هنا، صار بإمكان اللغة تحويل الواقع وإزاحته، وبالتالي لا وجود للحقيقة إلا داخل النص، بما هي أثر للمعنى ونتاج التفاعل اللغوي مع مراعاة الظروف والشروط التي تؤطر عمليات التواصل.
ففي سياق العلاقة بين السيرة الذاتية والأعمال التخييلية، أو حضور عناصر تخييلية في الكتابة التاريخية ونظيرها، تأسست آفاق نظر جديدة تقوم جوهريّا على فهم الذات بوصفها تخييلا. فالتخييل بوصفه فاعليّة نصية صار يقوم بدور رئيس، يقلّ أو يزيد، داخل معمار الكتابات الذاتية، كما أنّ الحكي داخل نصوص التخييل الذاتي، مدعوما بتجربة التحليل النفسي والتجريب الجمالي، لم يكفَّ عن اللعب بعلامات اللغة وابتكارها، وصار بوسع المؤلف أن يُغيّر في الواقع، ولا يعطي إلا «صورة» عنه. لن ينحلّ مأزق التلقي إلا عبر تقبُّل الطابع المفارق للسيرة الذاتية ولغيرها من كتابات الذات، أي أنّها تشتمل على تخييلات أقرب إلى «الحقيقة» من صور ابتذالها، ويظلّ اعتقاد القارئ قائما على تشكُّل اللحظة التي تنشأ فيها السيرورة باستمرار، وتتدفق معاني الحياة في ضوء حاجيات الوعي الحاضر. وبعبارة أخرى، يتجاوب النزوع التخييلي للكتابة الذاتية مع بنيات هويّتها السردية التي تسعى على الدوام إلى شكل ما من التكامل السردي الذي يعطي لمفاهيم الحياة المعيشية وأحداثها معانيَ لم تكن تمتلكها وقت حدوثها، وتعطي لطريقة سردها طابعا أكثر اتساقا وانسجاما، حتى إن كانت في جزء كبير منها مُفكّكة. إنّ سرد هذه الكتابة يبتكر أكثر من كونه يصف. ولهذا من السخف الزعم بأنّها تحكي الحقيقة التي من المستحيل بلوغها، وفي المقابل يمكن أن يكون ما فيها «حقيقيٌّ أكثر» بحكم طابعها التخييلي.
إنّ الكتابة الذاتية تخصُّ جميع محكيّات الحياة، ويمكن أن تتعلّق بحياة شخص واقعي (مؤلّف مثلا)، أو بحياة شخصية خيالية، وأصبح ممكنا في هذا المنظور أن نتحدّث عن الأنا، الذي يكتب ليس بصفته الأنا الذي يقدّم نفسه للوجود. فهي تحضر بوصفها وسيطا تخييليّا لتحقيق المفارقة بين ذات «المرجع الواقعي» وذات «الموضوع المحكي»؛ أي بين ذات المؤلِّف كما هي في الواقع وذاته المتأملة في التخييل، فتتخلّى الذات عن مرجعيتها الواقعية، وعن وضعها المرجعي إلى حدّ أن يصبح المرجع نفسه إشكاليّة داخل النص حين تتجاوزه الذات؛ وكأنّها تريد أن تثبت أن حياتها شيئا آخر غير الذي عاشته، وذلك بِمجرّد أن تنقل محكيَّها الخاص إلى فضاء الكتابة سردا، أو شعرا.
كاتب مغربي