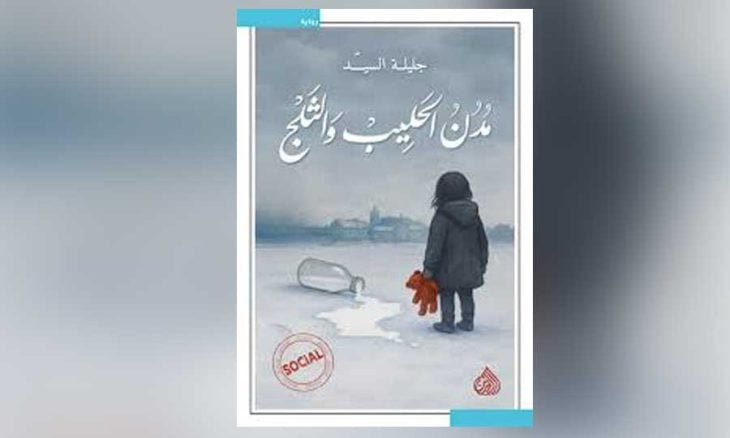فلتكن «سينما السجون» في سوريا المقبلة

سليم البيك
كأي حالٍ سينمائي في هذا العالم، لا بد للتغيرات الكبرى، الدرامية، لدى المجتمعات، كانقلابات وثورات وحروب، أن تُسقط تأثيرات على الصناعة الفنية للمجتمع، السينما منها تحديداً كونها بصناعة جماعية، وبتلقٍ جماعي، فتتعلق بشكل أوثق بالتغيرات المجتمعية، أكثر مما يمكن أن تكون عليه الروايات مثلاً، حيث تُؤلَف وكذلك تُقرأ فردياً.
الفنون كلها تخضع لتلك التأثيرات، وإن كان للسينما الأسبقية بالتأثر، لتجاريتها وترفيهيتها، أي لجماهيريتها، بالتجاور مع فنيتها، أي لنخبويتها. ولا يمكن أن تمر الأحداث الراهنة في سوريا، تحرير البلاد من ديكتاتورية فاقت نصف قرن من الحكم المتوحش، وبتطرف في ذلك خلال السنوات الأربع عشرة الأخيرة، من دون السؤال عن السينما المرتقَبة هناك، لسبب مزدوج: التقدم الواضح في صناعة المسلسلات التلفزيونية، والتأخر الملحوظ في صناعة السينما.
لن تحتاج المسلسلات التلفزيونية في سوريا، أو كما تُسمى: الدراما، تقديماً. صيتها واسع وسطوتها عارمة، منذ التسعينيات حتى اليوم، مع تغييرات طالتها مع اندلاع الثورة عام 2011. نافست تلك المصرية وتقدمت عليها في مواقع كثيرة ولدى مشاهدين كثرٌ أنا من بينهم. لم تترك المسلسلات مجالات لم تخضها: الاجتماعية، السياسية، التاريخية، الفانتازية، البوليسية، وغيرها. ودائماً بإمكانات كتابية وإخراجية وإنتاجية وتمثيلية عالية.

تأثر ذلك بانقسام الصناعة والعاملين فيها من بعد عام 2011، بخروج من عارضَ نظام الأسد، من البلاد وتشتتهم في العالم، وببقاء الأكثرية الموالية للنظام، حفاظاً على مصالحهم الشخصية والمهنية، في مواصلة العمل الذي صار دعائياً في معظمه ومبتذلاً، على حساب مواقف أخلاقية. بين الطرفين وقفت فئة لم توالِ النظامَ ولم توالِ المعارضات على أشكالها.
هذا التقسيم الثلاثي خفف من حضور الدراما السورية كما عرفناها ما قبل عام 2011، أضعفها بشقها، لتكون الإنتاجات الأكبر هي تلك المقبلة من داخل البلاد، توازيها إنتاجات تداخلت فيها الصناعة والتمويل والتمثيل العربي، إذ لجأ الممثلون السوريون تحديداً، من داخل البلاد، إلى أعمال عربية بعد انهيار الدراما السورية وتحولها إلى دعاية للنظام وسردياته، وتشتت العاملين في الدراما خارج البلاد، مع إمكانية استجماع الذات في السنوات الأخيرة والخروج بأعمال جديدة، كان أبرزها سياسياً كذلك ومعارضاً للنظام، «ابتسم أيها الجنرال».
هذا التقدم السوري في صناعة الدراما، المسلسلات التلفزيونية، وازاهُ تراجع مضاعَف لحالٍ متراجع أصلاً، في الصناعة السينمائية، من بعد اندلاع الثورة. أسباب مذكورة أعلاه، تلخصها مفردة «تشتت»، أودت إلى انهيار تام للسينما السورية، بوصفها عملاً جماعياً.
ظهرت وثائقيات عديدة ومنها الممتاز، في السنوات الأربع عشرة الأخيرة. لكن الوثائقيات أقل جماعية من الروائيات، أقل احترافية ومهنية في حاجة إلى تخصصات أبرزها التمثيل والكتابة، كما أنها يمكن أن تعتمد على تقنيين أجانب، وهذا حالها سورياً، إضافة إلى أن الكارثة في كل مكان، سوريا وفلسطين وغيرهما، تستحضر الوثائقيات وتستبعد الروائيات لأسباب صناعية وسردية.
حديثي عن السينما إذن يتعلق بجانبها المركب، الأقرب لصناعة تحتاج لإنتاجها نوعاً من الاستقرار، لا الاضطراب، وهذا ما لم يتوفر في الحالة السورية، بالإضافة إلى التشتت، وعوامل أخرى كقلة جدوى العمل في الأفلام، وهي مستقلة لا حكومية ولا تجارية خاصة، مقابل العمل في مسلسلات، وهي حكومية أو تجارية خاصة، وكذلك عربية بإنتاجات خليجية ضخمة، وما شابه. السينما الفنية، الجادة، المستقلة، كانت ولا تزال خارج هذا المجال تماماً. لا يخلو الأمر من أفلام شهدتها السنوات الأخيرة وكانت خارج سلطة النظام، أذكر منها «يوم أضعتُ ظلي» و»نزوح» لسؤدد كعدان.
لكن، منذ ما قبل الثورة، كانت السينما السورية في حالة متراجعة، جداً، مقابل تقدم المسلسلات، فللأخيرة مريدوها من منتجين وموزعين ومشاهدين، وقبل كل شيء، لها مباركة النظام السوري، بخلاف الفيلم السوري الأقرب لظروفه، إلى مغامرة سياسية من ناحية، وتوزيعية من ناحية أخرى. فأي فيلم يخرج عن توجيهات النظام أو رضاه، لا مكان له في البلاد وقد يُضيق عليه من النظام نفسه، خارجها، فظهرت أفلام من داخل سوريا في الأعوام الأخيرة، كانت أقرب للدعاية الحربية. وهذا بخلاف طبيعة السينما، الفنية منها تحديداً، وهي نقدية وغير مهادنة أو، على الأقل، غير منصاعَة ولا مروضة. لذلك كله، لا سينما سابقة في سوريا بل أفلام متفرقة. من هنا يحضر السؤال: هل من سينما سورية جديدة إذن؟
من كل ما سبق، يمكن القول باطمئنان، إن في سوريا إمكانات وإمكانيات لاستهلال خط سينمائي يستطيع أن يكون في عقد من الزمان، أول عربياً. ذلك بافتراض أن البلاد ستتجه لاستقرار مأمول، مهما بانَ غدُها، اليوم، مجهولاً. قد نكون اليوم أمام مغارة علي بابا التي سندخلها خلال السنوات المقبلة، ونجد الوفير من الأفلام السورية التي لا تعوزها تخصصاتٍ مهنية من ناحية، ولا جرأة فنية من ناحية أخرى، مدعومة بحدث تاريخي تعيشه البلاد والمشرق العربي اليوم. لكن ما السينما المرجوة هنا؟
في مجال مجاور، كان لأدب السجون السوري المكانة الأبرز عربياً، لما جربه المجتمع من مسالخ بشرية ومعتقلات قرأنا عنها روايات وقصائد، لكن بمشاهدة بعض آثارها أخيراً، مع الفيديوهات التي انتشرت منذ تكسير أقفالها، انتبه أحدنا إلى الفارق المخيف بين خيالنا مما قرأناه وما نراه في سجون كانت مأهولة ساعات قبل رؤيتها، وجرت فيها عمليات إعدام ساعات كذلك قبل تحريرها. رغم هذا الفارق المهول، يبقى الأدب السوري، والشهادات المَحكية، الموردَ الأول لمن لم يجرب المعتقلات هذه، في تخيل ما كان يحصل في السراديب والزنازين. هنا تبدأ مهمة السينما السورية المقبلة. هذا ما ننتظره من هذه السينما، ردم الهوة بين ما تخيلناه في الأدب الوثائقي، وما رأيناه في الفيديوهات العشوائية.
تحضر الأسباب كما سردتُها أعلاه، أخيراً، لترقب سينما سورية مندفعة، ولخصوصية التاريخ السوري، في وحشية لأكثر من نصف قرن تطرفت في مرحلتها الأخيرة، مرفقةً بسجون ما كان لدانتي أليغييري أن يتخيلها في مجلد «الجحيم» لملحمته «الكوميديا الإلهية»، منتهيةً لانكشاف لبعض ذلك، ولا أقول كله. مع حضور الأسباب، فلتكن الخصوصية السورية في أدب السجون، إذن، خصوصيةً سينمائية مقبلة. فليؤلف الكتاب سينما سجون، فلتتحول الروايات والشهادات إلى أفلام، من دون غوغائية ولا دعائية، الواقع فاق الخيال ولا يحتاج سوى نقله بفنية وحساسية، وإخلاص لأصحاب التجارب المميتة، وأساساً وهذا المختلف اليوم، بحرية لم يشهدها أي من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الروائية المصنوعة في سوريا، حتى اليوم. تحررت إمكانية السينما كذلك في سوريا، وهذا الجديد.
كاتب فلسطيني/ سوري