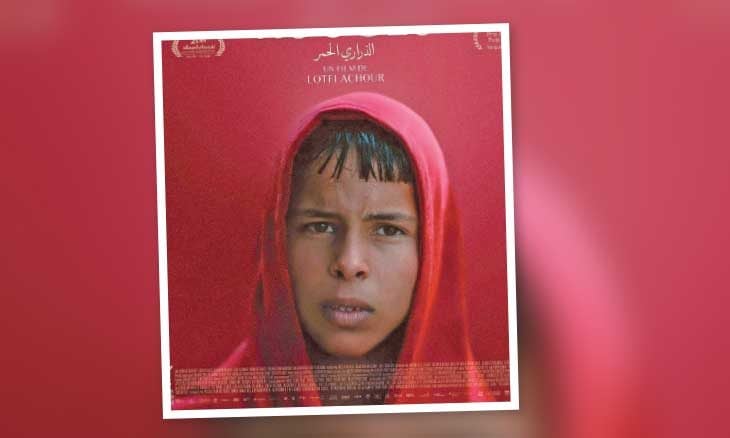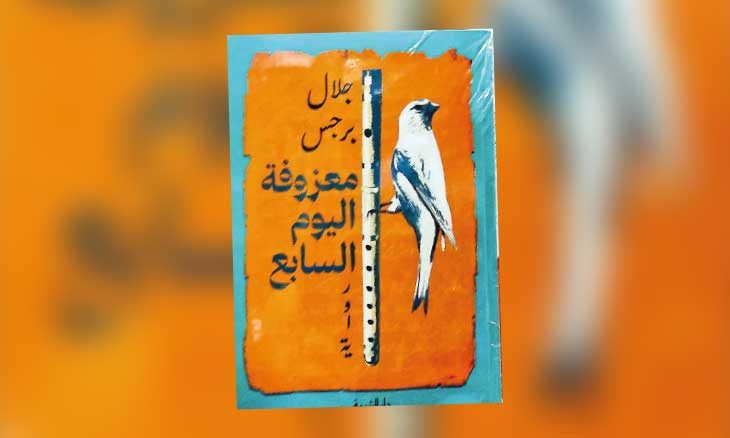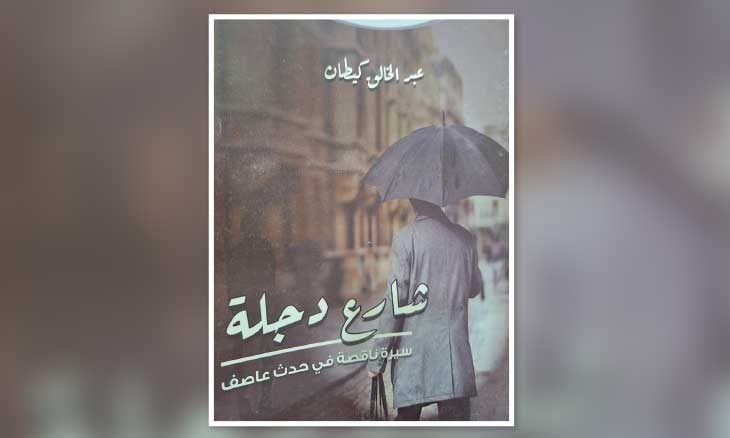المرأة في رحلة الحداثة: السفر كنافذة للتغيير والتحديات

المرأة في رحلة الحداثة: السفر كنافذة للتغيير والتحديات
سُفيان البراق
لعل المنبهر بالتجربة الغربية، والأوروبية تحديدا، إذا سمع أحدهم يتساءل عن المنزلة التي تبوأتها المرأة الأوروبية في تجربة السفر، سيؤكد أنها حظيت بمرتبةٍ أسنى؛ إذ أن أوروبا هي منبع منظومة الحداثة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، وخلال القرن الخامس عشر ابتدعت النهضة وانفكت عن العصر القروسطي، وسيدعم ذلك أيضا بالقول إن الحرية هي مدماكٌ أساسي من مداميك الحداثة، ومن ثمة ينشأ أن المرأة هناك حظيت بالحرية، وتنعمت بالاستقلالية، وما تركت تجربة إلا وكان لها إسهامٌ فيها. وقد يتجاوزُ هذا الزعم وينغمر في مقارناتٍ بين المرأة في الضفتين: الغربية والشرقية، وقد لا ينفك عن تفخيم تجربة الأولى في الحياة، والنظر إلى الثانية نظرةَ شفقةٍ، لكونها لم تنل ما تستحقه من الاهتمام المرجو، ولم تسعد بحظوةٍ مماثلة للتي سعدتْ بها المرأة الأوروبية.
وحتى نُجيب عن هذا الإعلاء المبالغ فيه نأخذ، من باب التمثيل لا الحصر، تجربة المرأة الأوروبية في السفر، هل عاشت هذه التجربة بشكلٍ مكتمل؟ هل وثقت رحلاتها وتنقلاتها بكل أريحية؟ هل وجدت أمامها حائلا أعاق دخولها تجربة السفر؟ لعل من بين أهم القضايا التي ما فتئت تثير جلبة وحمأة في صفوف النساء، قديما وحديثا، هي حصر بعض التجارب على الرجال فقط، والنظر إلى المرأة بحسبانها صفرا على اليسار، ونعت التجربة الإنسانية على مرّ تاريخها بأنها تجربةٌ ذكورية خالصة، في تصغيرٍ واضح من شأن المرأة. حاول لفيفٌ من الفلاسفة الذين يحتلون مكانة أسنى في تاريخ الفلسفة رمي المرأة بنعوت قدحية، تحط من قيمتها ومكانتها، وأكتفي هنا بعرض موقف الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، كونه مثالا جليا لهذا «التحقير»، وقد اعْتَقَدَ كانط اعتقادا راسخا وجادا أن الفلسفة لا يمكن أن يمارسها إلا الرجل، وكأن التفكير حِكرٌ على الرجل وحده، ولعل ما ترتب عن هذا الإقصاء، أننا نادرا ما نسمع سيدة توصف بأنها فيلسوفة.
إن الصاعق في هذا الأمر هو أن هذا التحقير الذي طال المرأة انتعش بشكلٍ جلي في أوروبا في عصر التنوير خلال القرن الثامن عشر، ومعلومٌ أن كانط من أَميزِ دعاة التنوير في تلك الفترة، ولعل مقالته: «ما التنوير؟» خير دليل على ذلك، فضلا عن مشروعه النقدي المهم الممتد من نقد العقل الخالص أو المحض (المعرفة)، مرورا بنقد العقل العملي (الأخلاق)، وصولا إلى نقد ملكة الحكم (الجماليات). ما دام أن فيلسوفا متنورا، ورائدا لامعا للنزعة النقدية بلا مُدافعة ينعتُ المرأة بأنها موصوفةٌ بالرقة والضعف، وبالتالي ما عليها إلا أن «تكون جميلة دون أن تتحمل عبء التفكير والتعليم (السمو بلغة كانط)، فإذا امتلأ رأسها باللغة اليونانية قد تنبت لها لحية أيضا (إيميلي توماس، معنى السفر، ط1). فما هو الرأي الذي سيخامر خَلَدَ من يتحاشى التفكير النقدي ولا يسعد بالحس التنويري حول المرأة وأحوالها؟ قبل كانط بزمن طويل ظن أفلاطون أن الذكور من سماتهم التفوق على الإناث في كل شيء، وبعده تلميذهُ أرسطو الذي عرف الإناث تعريفا غريبا قائلا: «هن ذكور مشوهات» (معنى السفر)، وبعدهما فيلسوف الجدل هيغل، خلال القرن التاسع عشر، الذي أقر بأن الفلسفة لا يمكن أن تقربها المرأة، رغم محاولاتها الجادة والمُضنية بُغية الوصول إلى مبتغاها.
أخذ هذا التبخيس البين من طرف الفلاسفة للمرأة يتنامى تدريجيا إلى أن وصل الأمر بهم إلى حصر تجربة السفر على الذكور فقط، وحُرمت النساء، اللهم إلا النزر اليسير منهن، من خوض تجربة السفر والتلذذ بها، ولعل هذا عائد لغياب أو ندرة وجود كتابات نسائية في أدب الرحلة حتى القرن التاسع عشر. وعندما طالبت طائفة من النساء البريطانيات بالانضمام إلى الجمعية الجغرافية الملكية في بريطانيا، ردت مجلة «بَنْشْ» على طلبهن المشروع بأبيات موجزة ومقتضبة مليئة بالسخرية والاستخفاف بهن وبطلبهن (يُنظر: معنى السفر). وهي أبياتٌ تعكسُ بجلاء صورة المرأة الأوروبية آنذاك في مجتمعها ومحيطها، علما أن أوروبا خلال تلك الفترة، سنة 1893، كانت منتشية بتبلور الحداثة ومُكتسباتها. فما أسباب تهميش المرأة في ذاك السياق وتلك الحقبة؟ حينما أبصرتُ تلك الأبيات الشعرية في مجلة «بنش» البريطانية، التي تضمنت البيت الآتي: «فليمكثن بالبيت ويرعين الصغار، أو يخيطوا قمصاننا الممزقة»، انثال على رأسي مباشرة بيتان لأبي العلاء المعري الذي ازدرى المرأة وهزأ منها. يقول:
«علموهن النسج والغزل والردن … وخلو كتابة وقراءةْ فصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص … تجزي عن يونس وبراءةْ». يمكن أن نقرأ ما قاله المعري في السياق الذي عاش فيه والذي طبعته خصوصية معينة، وسادت فيه ذهنية محافظة بخست المرأة حقها، لكن الأبيات التي احتلت الصفحات الأولى لمجلة «بنش» البريطانية تُقرأ هي الأخرى في سياقها الذي يُخالف سياق المعري، حيث كانت أوروبا تسعد بالريادة في كل شيء: السياسة، الاقتصاد، الفلسفة، والعلم، إلخ.
إن المرأة الأوروبية، إلى حدود القرن التاسع، لم يكن لها أدنى حضورٍ في مجموعة من التجارب: السفر والانتخاب مثالين، علما أن الأوروبي يُنافح عن حضارته، ويزعم أنها حضارة الحرية والمساواة والديمقراطية والليبرالية، في حين أن التاريخ يُفند ذلك على الفور، ومن ثمة يُستجلى أن البيئة الغربية أقصت المرأة وهمشتها وحرمتها من تجربة السفر قديما وحديثا، ولتوضيح الفرق بينهما يمكن القول، إذا جاز التعبير، إن ما شهده العالم من نقلاتٍ تقنية وعلميةٍ مهمتين مست مختلف مناحي حياة الإنسان، ولم تهمل بالطبع مفهوم السفر الذي تبدل معناه متأثرا بهذه التحولات: اكتشاف الطائرة، الهاتف، آلة التصوير، الخريطة الإلكترونية، إلخ. وبالتالي لم يعُد مفهوم السفر يحيلُ على المعنى الذي كان سائدا في زمنٍ ولّى، حيث كان يرمزُ للصبر والجلد، ويقتضي قدرة هائلة لتحمل العطش والقيظ ووقوع المطر، والتحلي بالجسارة في الفيافي والقفار والمناطق الوعرة التي تعج بالوحوش، وهذا كله كناية عن المشقة التي تفرضها ظروف السفر. كما أن غاية السفر قديما كانت هي الاستكشاف والتعرف على ثقافة شعبٍ آخر وسبر غورِ خصوصيته. علاوة على خلق علاقات جديدة وصداقات تبقى صامدة، رغم تصاريف الأحوال. أما السفر حديثا فقد أضحى مرادفا للترف، والبذخ، وبحبوحة العيش، حيث خلا، إلى حد ما، من المشقة، وصار كل شيء يسيرا وفي متناول الجميع. يظهر مما سبق أن السفر حديثا صارت مراميه هي المتعة، التسكع، التيه، اغتيال الفراغ، وتمضية الوقت، ليصير بلا جوهر، وبالتالي يمكن نعتهُ بـ»السياحة»؛ لأن السفر أعمق من أن يختزل في قضاء فترة من الزمن في مكانٍ بديع، والمسافر دأبه، وهو هناك، النوم والخمول واللامبالاة واللعب المجاني. بصرف النظر عن الثورة التقنية ومثالبها التي اجتاحت عالمنا وغزت حياتنا اليومية، فإن هذا التجانس الذي غرق فيه العالم تسبب في التقليص من عمق معنى السفر. نقرأ لإيميلي توماس في هذا المضمار: «كلما ازداد تجانس العالم، ازدادت صعوبة تجربة أشياء جديدة في السفر».
لعل ما يستشف من قول الباحثة أن مفهوم السفر صار أجوف بلا روح، ذلك أن جميع أقطار العالم صارت متشابهة؛ فمثلا أينما حل الإنسان سيجد يافطات إشهارية لشركة كوكا كولا، وسيصادف محلات الوجبات السريعة: ماكدونالدز على سبيل التمثيل، علاوة على مجموعة من الشركات العالمية، التي ما تركت مكانا إلا واحتلته (ففي المطارات نصادف المحلات نفسها التي تزود العابرين بالوجبات الخفيفة والسريعة، جل أروقة المطارات متشاكلة في التصميم، والماركات المكرسة نفسها تسجل حضورها في هذا المطار وذاك) لتصير الرحلات متشابهة، حتى أضحى المرء لا يكادُ يبصرُ فرقا واضحا وجليا، فضلا عن الرغبة العارمة التي تجتاح المرء في توثيق اللحظات التي يعيشها دون أن يمنح لذَاتهِ فرصة التأمل والاستمتاع، وربما لأنه لا يدرك أن «الصورة لا تفكر» وأن كل «صورةٍ تُلتقط هي بمثابة تجربة موت صغرى» (عبد العلي معزوز، فلسفة الصورة)؛ حيث يموت الشغف، وتنفلت من بين يديه اللحظات الأكثر ألقا وجمالا، وتتقلص قدرات العقل، وتشرع القوة المحفزة على التأمل في الخفوت والأفول. إن الذي يُبالِغُ بالاهتمام بالصورة، أو «الفن الرقمي» على حد تعبير صاحب كتاب «فلسفة الصورة»، فإنه يُفوتُ فرصة مذهلة للاكتشاف والتعرف على أشياء جديدة؛ إذ إن الصور تتزايد وتتكدس، والذكريات تزدحم، وكل صورةٍ تغتال الصورة التي سبقتها، والتولع يتنابذ بين الصورة القديمة والحديثة في الهاتف، أو في آلة التصوير؛ حيث إن ديدن الصور هي إهمال القديم والتشوفُ إلى الجديد. يكفي أن ينظر إلى ملفات الصور وسيكتشف بيسر بالغ اللهفة الكبيرة التي تعترينا في الالتقاط والتوثيق، وبالتالي نندهش حينما نصل إلى خلاصةٍ مفادها أن الصور القديمة سرعان ما تبرح الذاكرة، ليتزايد الاهتمام، في المقابل، بالصور الجديدة. نقرأ لعبد العلي معزوز في سياق الكلام عن الثورة التي أحدثتها الصورة الرقمية – العصرية: «إن الصورة الرقمية – تزج بنا في عالمٍ افتراضي وتدخلنا في رحاب فضاءات افتراضية لم يسبق للعين أن خبرتها، وهي أيضا انعكاساتٌ على مقولتي الزمان والمكان، تحول المكان إلى لا مكان ما دمنا في فضاءٍ افتراضي لا وجود فيه للحدود».
كاتب مغربي