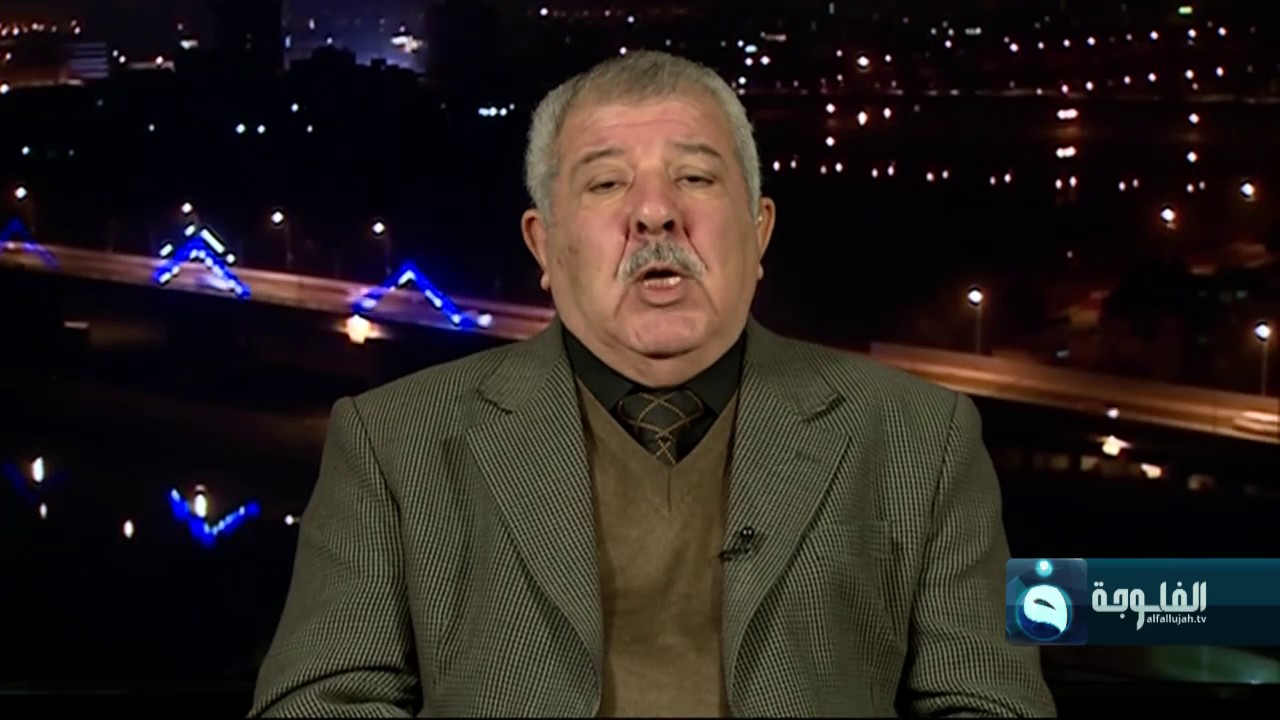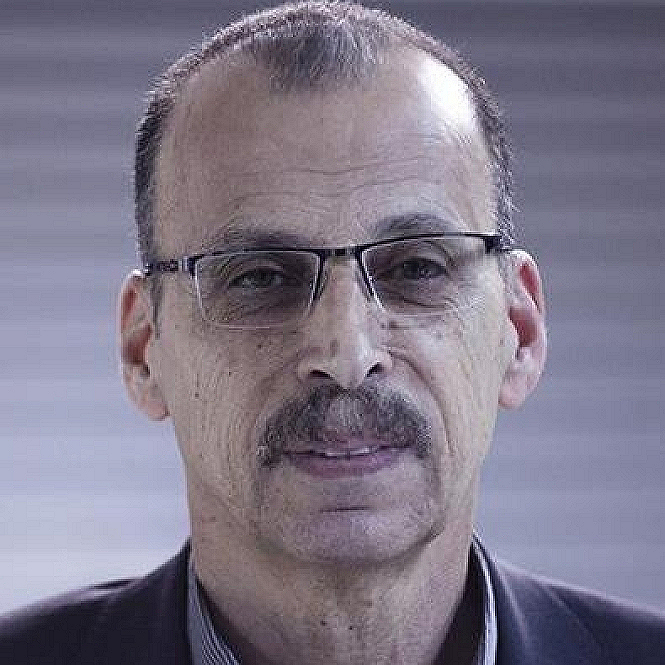سوريا: تغيير النظام السياسي أم تغيير النظام الاجتماعي

سوريا: تغيير النظام السياسي أم تغيير النظام الاجتماعي
منصف الوهايبي
ليس من مقاصدي في هذا المقال أن أناقش موقف أدونيس أو غيره من السوريّين على اختلافهم، من سقوط النظام السوري؛ وإنّما أحاول طرح هذه المسألة «تغيير المجتمع أم تغيير النظام» من وجهة نظر تتّسع في تقديري لأنظمة عربيّة أخرى لم توفّق في «استثمار» الغضب الشعبي أو «انتفاضات» شعوبنا أو «ثوراتها» خلال العقد الماضي. وقد أفضى ذلك إلى ما نلاحظه من لامبالاة عامّة الناس بالشأن السياسي، كما هو الأمر عندنا في تونس حيث شهدنا وعشنا «تعدّديّة» سياسيّة في خضمّ «الثورة» لها وعليها، وليس «ديمقراطيّة» على النمط الحديث المعروف. ولذلك أسباب ومسوّغات شتّى، لعلّ من أبرزها فقدان الثقة في السياسي؛ وجميعنا على ما أرجّح يعرف أنّ أساس العمل السياسي هو الثقة: ثقة المواطن في المترشّح وفي برنامجه ووسائل تنفيذ وعوده. والثقة رهان وليست إيمانا أو اعتقادا «دينيّا» ساذجا في السياسي، كما حدث عندنا إبّان «الثورة» أو أثناء حكم «الإسلاميّين» وشركائهم؛ حيث كانت «المرجعيّة أو الخلفيّة الدينيّة» هي مناط ثقة عدد كبير من المواطنين في «الترويكا» التي انهارت سريعا، بـ«اعتصام الرحيل» وما تلاه. والمؤمن كما يقول الحديث «يُطْبَع على كلِّ خُلُقٍ إلاّ الخِيانَةَ والكَذِب». والحقّ أنّ الشعور بالخيانة أو بالإحباط هو الذي ساد في تونس عند كثيرين؛ وقد تبيّن لهم أنّهم خُدعوا، وأنّ الوعود وتسنّم السلطة شيء آخر، وأدرك جلّهم أنّ الذين «بشّروهم» بـ«جنّة تونسيّة» كانت لهم «خائنةُ الأَعْيُن» إذ أضمروا في أنفسهم غيرَ ما أظهروه في وعودهم.
وهو الدرس الذي يفترض أن يضعه حكّام سوريا الجدد نصب أعينهم، حيث إعلان «إرادة التغيير» لا تكفي لإقناع المواطن الذي قاسى ما قاسى طوال نصف قرن من الاستبداد الشنيع والفساد والتسلّط. والزمن اليوم غير الزمن، فهو يتسارع ويضغط على نحو عجيب أو غير مألوف حيث تنشب الحروب هنا وهناك، وتندلع الثورات والتحوّلات في فترات قصيرة عندنا وعندهم في الغرب؛ تحت وطأة العولمة والتكنولوجيا الرقميّة المشتركة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وما يسمّى بالثورة الصناعيّة أو الاقتصاديّة الثالثة التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي، وغيرها والعالم اليوم غير عالم القرن التاسع عشر «عالم الامبراطوريّات العظمى» وغير عالم القرن العشرين «عالم القوميّات» وإنّما هو «عالم الثقافات»، حتّى ليصحّ ما يقوله المؤرّخ الفرنسي جول ميشليىه في قراءته لتاريخ القرن التاسع عشر، من أنّ «وتيرة الزمن تغيّرت تماما بعد كومونة باريس، إذ ضاعف سرعته على نحو غريب. فقد قامت ثورتان عظيمتان، كان من الممكن أن تفصل بينهما ألفا عام».
والقضيّة في هذا الزمن السريع، ليست في «ما ينبغي فعله» وإنّما في «كيفيّة فعله» من حيث الأدوات أو الوسائل، في مجتمع متعدّد غنيّ بتاريخه ومعتقداته وثقافاته، مثل المجتمع السوري؛ يفترض أن تكون تعدّديّته عامل تغيير باتّجاه ديمقراطيّة أساسها المواطنة لا المحاصصة كما هو الشأن في لبنان أو العراق أو عندنا في تونس أثناء حكم الترويكا ونداء تونس. وتغيير النظام أشبه بجبل الجليد، حيث لا نرى إلاّ القمّة أو ما هو على السطح، في حين أنّ تغيير النظام الاجتماعي يتطلّب دراية بالجذور والرموز غير المرئية، وليس إصدار قرار أو مرسوم؛ إذ أنّ هناك ثقافة متأصّلة في مجتمعاتنا عامّة على ضرورة تنسيب الحكم، معادية لأيّ تغيير يراه الفرد بسبب من نزعته المحافظة، مخلاّ باستقراره وبعاداته أو مكانته أو امتيازاته ومزاياه؛ وقد يلمّ بما قد يخسره؛ والإلمام بالشيء هو عدم التعمّق فيه، وقد لا يعرف ماذا سيكسب أو بماذا سيفوز؛ فيما التغيير عمل جماعيّ مداره على أهداف مشتركة.
ولا أحد غير السوريّين يعرف ما إذا كان عامّة المواطنين جاهزين للتغيير الديمقراطي المنشود؛ وهم الذين لم يعرفوا على اختلاف أعمارهم سوى نظام شموليّ متسلّط علّمهم أو تعلّموا منه أن يعوّلوا في كل شيء على الدولة «الراعية» وعلى حمايتها. وما يحدث اليوم في سوريا لا يزال مصدر قلق أو حذر، لا للسوريّين وحدهم، فيما نقرأ ونشاهد، وإنّما لجيرانهم وللعالم أيضا؛ فقد انهار النظام فيما يشبه زلزال فالديفيا في تشيلي عام 1960 الذي بلغ 9.5 على مقياس ريختر؛ وهو الأعلى. يقول بول فاليري: «إنّ الثورة محصّلة شعور ببطء التطوّر. أمّا إذا تغيّرت الأمور بالسرعة المطلوبة، فلن تكون هناك ثورة» والثورة السوريّة المنشودة لم تبدأ بعد. ولا أحد منّا من المنتصرين لإرادة الشعب، يحبّ أن يردّد عبارة ريمون آرون المأثورة التي قالها للجنرال ديغول «إنّ الشعب الفرنسي يقوم بثورة بين الفينة والأخرى، لكنّه لا يقوم أبدًا بإصلاحات تذكر». وقد يكون مآل «الثورة التونسيّة» خير مثال على هذا.
هل تغيّر النظام في سوريا حقّا؟ أقدّر أنّ السوريّين لا يزالون ينتظرون، إذ يفترض في تغيير النظام أن يفضي إلى تفكيك كافّة أشكال القمع والفساد، وإلى إقامة العدل والمساواة بين الجنسين… ويعرف جميعنا تلك الإجابات الجاهزة مثل «المجتمع غير متهيّئ بعد» أو «هناك قوّة الدولة العميقة» وما إلى ذلك من مبرّرات مردّها إلى شعور خفيّ بنوع من التفوّق الفكري عند أكثر السياسيّين الذين يتهيّبون الإصلاح الجذري. وهو غالبًا ما يكون سلوكًا نخبويًا يمهّد الأرض لبقاء الأقوى؛ إذ يعتقد أصحابه أنّهم يمتلكون الحقيقة؛ ومثل هذا الادّعاء هو الذي يصمّ الآذان ويفقد القدرة على الإصغاء للآخرين، ويحول دون تغيير النظام الاجتماعي أي بناء المؤسّسات التي تبني التعدّديّة وتحميها.
على أنّ المسألة لا تختزل في الفصل بين الاجتماعي والسياسي، على نحو ما يقول به بعض رجالات السياسة من أنّ التنظيم الذاتي الاجتماعي له مجاله الخاصّ المقبول، وأنّ السياسة القائمة «الحقيقيّة» مجالها عالم الدولة؛ وإنّما في عقد الصلة بينهما، بالرغم من أنّ السلطة في المجتمعات الحديثة اخترقت الاجتماعي أو هي صاغته على صورتها ومثالها، كما يقول أهل الفلسفة؛ فقد وسمتنا علاقات السوق والطبقات الاجتماعيّة بميسمها، حتى صرنا نعيد بوعي أو دونه إنتاج علاقات «القوّة الرأسمالية». وهذا يعني أنّ السلطة لا تتحكّم فينا من خارج فحسب، وإنّما هي تتسلّل إلى داخل حياتنا الاجتماعيّة أيضا، وتسيطر عليها. وصحيح ما يلاحظه علماء الاجتماع من ظواهر تكاد تكون عالميّة، وهي أنّ البشر هم اليوم أكثر تشتتًا حيث الشعور بـ«الفردانيّة» هو الذي يهيمن عليهم؛ إذ يشغل الفرد المكانة المركزية، على طرف النقيض من الرأي القائل بـ،»التماميّة» Holisme أو «الكلّيّة»حيث نظام معقّد بكامله كخليّة أو عضويّة، هو أعظم من مجموع أجزائه من منظور وظيفيّ. وفي سوريا قد تتعزّز «الفردانيّة» عند «الأقلّيات» فيها، ما لم تؤخذ بالاعتبار تلك الثنائيّات التي تتحكم فينا، مثل الثنائيّة القانونيّة، حيث المواطن هو مشرّع وموضوع تشريع، والثنائيّة السياسيّة حيث المواطنة تكون في الآن ذاته مبدأ وممارسات، والثنائيّة التاريخيّة حيث المواطنة مؤسّسة وصيرورة، والثنائيّة الجيوـ مؤسّساتيّة حيث المواطنة تتطوّر على الصعيدين المحلّي والكوني، والثنائيّة المؤسّسة أو المنشئة لفكرة المواطنة.
ولذا ننتظر من سوريا «الجديدة» أن يسود فيها منطق العدل والقانون، لا الضغينة والانتقام فـ»النار لا تطفئ النار» كما يقول المثل الإغريقي القديم. وهذه أمور جديرة كلّها أن تؤخذ بالاعتبار، من أجل تغيير النظام الاجتماعي. فالمواطن هو من جهة شخص «مجرّد» أي هو يتولّى تجريد خصوصيّاته التاريخيّة والإثنيّة والاجتماعيّة والجنسيّة من أجل المساهمة في إنتاج قانون، أو اتخاذ قرار يلبّي المصلحة العامّة أو «الكونيّة»، والمواطن صاحب سلطة، لأنّه يرتقي إلى مستوى مصلحة الشأن العام. ومن منظور آخر فإنّ هذه الممارسة تجري ضمن شروط مخصوصة، وفي صيرورات تاريخيّة. وهذه الثنائيّة المتعلّقة بالكوني والخصوصي غير قابلة للاختزال؛ فهي تميّز المواطنة من حيث هي فعل استئصال من الخصوصيّات، ومن حيث هي مجهود يتوق إلى الكوني. ولعلّ رهاننا جميعا، إنّما يتعلّق بإعادة صياغة هذه «المواطنة» الجديدة.
وهذا يقتضي وضع حدود واضحة بين حقوق الجماعة أو الأغلبيّة، من جهة، وحقوق الأفراد والأقليات، من جهة أخرى. على أنّ هناك حقيقة لا تخفى، هي «توتّر» ما بين إرادة الفرد وحاجاته، وإرادة الجماعة وحاجاتها؛ وقد لا يكون قابلا للحلّ، وإنّما لحسن إدارته. ولعلّ خير ما أختتم به، مع الاعتذار لأبي تمّام الطائي، أو الشامي كما يحسن بنا أن نسمّيه، قوله في وصف الربيع «رقّتْ حواشي الدهرِ فهي تَمرْمرُ»؛ وأنا أستبدل فيها «الشام» بـ«الأرض». و«الشام» تُذكّر وتؤنّث، وإن غلبت تسمية المؤنّث. وهي تشمل قبل سايس بيكو، سوريا وفلسطين ولبنان والأردن؛ لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض، فشبّهت بالشامات التي تظهر على الجلد:
أَوَ لا ترى الأشياءَ إنْ هي غُيّرتْ/ سَمُجتْ، وحُسنُ «الشامِ» حين تَغَيَّرُ
شاعر وناقد تونسي