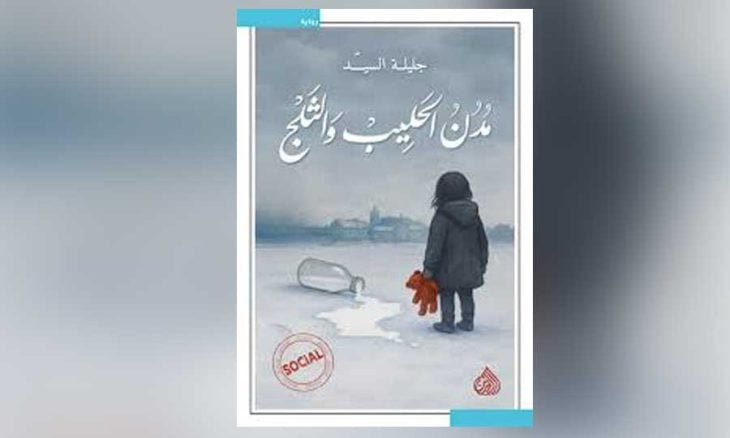سيخرجون منها كما خرجنا منها!

هاشم شفيق
كان زمناً ذاك الذي شاعت فيه عبارة «الصمود العربي» ليحل محلها الآن في هذه الأزمنة مصطلح « الخمود العربي «، ونستطيع عبر التلاعب اللغوي الذي لم يتبق لنا سواه، أن نصوغ على غراره ووفق نسقه التشكيلي من أجل التعبير السريالي والدادائي الذي نعيشه الآن، مصطلحات مشابهة، مثل «الهمود العربي» أو «الجمود العربي»، ولكيلا نطيل، فإننا نعيش حقاً مرحلة «الصدود العربي» بكل تجلياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
أعود وأقول، كان زمناً ذاك الذي كان يسود فيه مفهوم التضامن العربي، نحن الآن نعيش أقسى مرحلة! وهي مرحلة «التفكك العربي»، وقد ذهب ذلك الوقت إلى غير رجعة، يوم كنت شاباً أخطو صوب اليفاع، أيام الستينيات حين كان المغنّون العرب يجوبون العالم العربي، من أجل جمع التبرّعات عبر حفلات الغناء للمجهود الحربي، ولا أنسى ما حييت ذلك اليوم الذي كنت فيه فتى مراهقاً ينتظر مع المئات في «شارع السعدون»، قلب العاصمة بغداد، إطلالة المطرب الرومانسي عبد الحليم حافظ، ليخطو عندها العندليب خطوته من «فندق بغداد» إلى صالة «سينما النصر» القريبة من الفندق، الذي يقيم فيه الضيوف، مطربون وممثلون وفنانون مصريون، كانوا يجوبون، ذارعين العالم العربي بخطاهم وأصواتهم وأحلامهم، من أجل المجهود الحربي، للجندي العربي الذي يقف في الجبهة، مقاتلاً خصمه وعدوّه المجرم العنيف الإسرائيلي. كانت حدائق الشارع حينذاك ملآى بالمعجبين، والمشاهدين والعابرين، أولئك المنتظرين إطلالة الفنانين، وهم يتقاطرون باتجاه مقر حفل السهرة، الغنائي والاستعراضي والفني.
في ذلك الوقت، كنت وما أزال الى الآن، من المعجبين بالمطرب العاطفي عبد الحليم حافظ، وقتئذ وعدت نفسي برؤيته مهما لاقيت من صعوبات، تلك التي بدأت تظهر علائمها في تلك الليلة، أولاً لعدم امتلاكي تذكرة للدخول وحضور الحفل، ثانياً كنت نحيلاً وصغيراً في السن، والتدافع كان على أشدّه، ثالثاً كان عبد الحليم ليس من الموجودين في الفندق، حين ظهر الفنانون المصريون آخذين طريقهم باتجاه صالة السينما، وهي لا تبعد سوى عدة أمتار قليلة بينها وبين الفندق. هناك في تلك الليلة الرومانسية الجميلة انتظرت طلته، ولكن عبد الحليم تأخر بعد أن لاح الفجر، فترك بعض الحضور مقاعدهم، بعد أن يئسوا من حضوره، فتسللت بطريقتي الخاصة، ونفذت إلى الداخل، مستعيناً بحجمي الصغير، ينضاف إليه نحولي وشيطنتي، ولكن المفاجأة التي حلت أثناء الحفل في تلك الليلة، هي ظهور عبد الحليم حافظ فجأة، ثم اعتلاؤه المنصة ما بين الرابعة والخامسة صباحاً، وكان قد عاد للتو من الأردن، في رحلة للغرض نفسه، ألا وهو جمع التبرّعات للمجهود الحربي، فطلّ العندليب الأسمر ليشعل القاعة بالصفير والتصفيق والهتاف المُرحّب، ذاك الذي كان يليق بحضوره، في ذلك الليل البغدادي البعيد والأنيس.
اليوم أجلس أمام التلفزيون، لأحصي عدد الشهداء، مع نبضات القلب المتسارعة، هناك دم غزير يجري كالسواقي، وتلال من الأشلاء، وعدد هائل من الضحايا يسقطون في بلدين عربيين، والكل يرى ما يدور هناك، من حكام وسياسيين ورؤوس أموال وفنانين وناس عاديين، وهنا أسأل أين هم الفنانون؟ أولئك الذين يتفاخرون بماركات سياراتهم، وقصورهم وملابسهم، ووجاهاتهم الاجتماعية والفنية حيثما حلوا، أين هم من كل هذا؟ ومن كل ما يجري أمامهم من مصائب اجترحتها الهمجية المعاصرة والحديثة للجيش الأخلاقي! من أحفاد هرتزل؟ أين هم الصاخبون والساهرون والمتاجرون بالغناء، من كل ما يجري في بيت لاهيا وجباليا والضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، وكذلك في الجنوب اللبناني الجريح المقاوم، وكل شبر من غزة المذبوحة، أمام رؤوس الأشهاد؟ خصصوا أيها الجباة العائشون من جيوب الجماهير ليلة من ليالي سهركم الغنائي، إلى الأطفال الجائعين والنساء الثكالى والشيوخ الطاعنين في السن، إلى الجرحى والمصابين والمكلومين في كل من غزة ولبنان، حيث هناك الآلاف من العرايا والمشردين والمنكوبين الذين يحتاجون إلى كل شيء، إلى كل مساعدة ونفحة إنسانية، تسارع لمشاركتهم هذا العناء الرهيب والمصاب التاريخي.
ليت كانت هنا أم كلثوم، التي لطالما أنشدت من أجل المجهود الحربي، بغض النظر عن نتائج الحرب وما آلت إليه من نهايات، ليت كان وكانت هنا فيروز وفائدة كامل، ومحمد قنديل وشريفة فاضل، التي قدمت ولدها شهيداً للقضية العربية، وكارم محمود، ودلال الشمالي، وغيرهم ممن سخّروا حناجرهم في خدمة القضية الفلسطينية، ومد يد العون للجندي العربي المقاتل والغيور والحامي للأرض التي تتعرض للغزو والمصادرة، وللدم العربي المسفوك بسخاء، وبتواطؤ أمريكي وأوروبي واضح وسافر ومستفز للرأي العام.
أذكر حين كنا في بيروت محاصرين من قبل الجيش الصهيوني بقيادة شارون الذي دخل الكوما، في ما بعد لمدة طويلة قبيل موته، وكأنّ ذلك كان عذاباً مرسوماً، مبتعثاً من لدن مجاميع الشهداء القتلى، الذين تمت نهايتهم على يديه، فقد كان يرى صور ضحاياه وهي تمر بشاشة وعيه الميت، وهو راقد في المستشفى بين ميت وحي في آن واحد، أذكر تلك الايام من عام 1982 في بيروت الجريحة، بيروت المقاومة الكبرى، حين كان يتدفق الفنانون والشعراء والأدباء والكتاب والممثلون العرب لغرض التضامن والمشاركة، ولن أنسى أبداً إطلالة الممثلة الشقراء نادية لطفي، كيف جاءت إلى بيروت المحاصرة جواً وبحراً وبراً، لتواسي بطلّتها المرهفة الجرحى والمعوقين، حاملة لهم الورد، وابتسامتها الذهبية كانت ترتسم على شفتيها، مختلطة بالدموع والمواساة والحنوّ والتربيتة، تلك التي كان يحتاجها المقاتل الفلسطيني والعربي، في ذلك الوقت من الزمن، لنسمّه «زمن التآزر العربي» الفني، ذاك الذي أفرز النخوة الثقافية، المتحامية جمالياً وإبداعياً وفنياً، هذه التي نفتقدها اليوم بوضوح شديد أمام واقعنا الطعين، بالقنابل والدبابات والصواريخ والطائرات وهي تعمل ليل نهار وبعزيمة فاشية كبرى، في سمائنا وأرضنا العربيتين، وهذا يجري وبتصوير دقيق عبر الخبر عاجل، وأمام كل شاشات وميديا وإعلام العالم.
هنا لا بدّ لي كمواطن عربي، أن أدلي برأيي وأقول: مهما تقدّم زمن الاحتلال، وتوغّل وتوسّع وصادر وقتل وأباد ومحا وهاجم وسحق ووطّن، وغيّر من خرائط وملامح، وبدّل أسماء البلدات العربية، ونهب وسرق من تراث وتاريخ وجغرافيا، سينهار الاحتلال ويختفي في يوم ما، كما حدث للعرب والمسلمين في ما مضى في الأندلس، التي احتلوها، وبقوا فيها سبعمئة سنة، وليس سبعين سنة كما هو الحال مع الصهاينة في فلسطين، ولكنهم خرجوا منها في النهاية، وسلّموها لأهلها الإسبان، بعد أن تلاشت امبراطوريات ودول عظمى وغابت حضارات، على الرغم من أن الاحتلال العربي للأرض الأندلسية كان ثقافياً وعلمياً وفنياً وحضارياً، وليس احتلالاً تدميرياً، همجياً، نازياً وصهيونياً.
كاتب عراقي